مدخل
يضم هذا الكتاب مجموعة من المقالات التي كتبتها من موقف نقدي عن قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، واعتماداً على المعلومات التي كانت متوفرة عندي. قد لا أتجاوز الحقيقة إن قلت بأنني كنت أول من بادر إلى الكتابة النقدية والنشر عن هذا القانون في العراق والخارج، وكان ذلك بفضل ما وفره لي زميلي محمد مصطفى الكبيسي من مستندات بعد أن التقيت به في لندن أواخر سنة 2003 والرسائل التي تبادلناها فيما بعد عن هذا القانون وغيره من شؤون التأمين في العراق.
موقفي النقدي، والسجالي، يقوم على تقييم عام يرد في ثنايا هذا الكتاب، لكني أود هنا أن اقتبس فقرة مما كتبته في مكان آخر شكّل إطاراً فكرياً عاماً لبعض الأوراق التي كتبتها عن التأمين في العراق. ففي رسالة إلى مجلة إلكترونية أمريكية (رؤى استراتيجية، المجلد الخامس، العدد 3 (مارس 2006)[1]، تعليقاً على دراسة للزميل د. صبري زاير السعدي، نُشر في هذه المجلة تحت عنوان “العراق: الرؤية الوطنية، والاستراتيجية الاقتصادية، والسياسات،” كتبتُ ما ترجمته هو الآتي:
لا تكتمل الصورة من دون الإشارة إلى السياسات الكارثية للحاكم الأمريكي بول بريمر في ‘تحطيم’ الدولة العراقية (بالمعنى الماركسوي الساذج)، وتأسيسه ‘للدكتاتورية’ (بمعنى dictatura الرومانية[2])، وإهدار الأموال دون الخضوع للمُساءلة (مثل أي مُبذّر ولكن مع فارق أن الأموال التي بذرها لم تكن له) والتي كان بالإمكان، وكان ينبغي، إنفاقها بشكل صحيح على أعمال البنية التحتية بدلاً من صبغ المدارس باستخدام العقود غير محدودة الأجل/عقود الطوارئ غير محددة الكميات. هذا ناهيك عن سوء فكرة مشروع غزو العراق ودعوة جماعات بن لادن إلى العراق كساحة معركة للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب الدولي. العواقب السياسية والاقتصادية للغزو هي الآن الواقع المهيمن وهي التي تحول دون تقدم حقيقي في العراق.
رب قائل يقول ان قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 هو في صالح قطاع التأمين العراقي لأنه لو كان غير ذلك فإن شركات التأمين الأجنبية كانت قد اكتسحت السوق العراقي باعتبار أن القانون نظّم كيفية دخول شركات التأمين الأجنبية إلى العراق. وهذا قول مُقنع في ظاهره فقط خاصة وأن شركات التأمين الأجنبية لم تؤسس بعد شركات أو فروعاً لها في العراق رغم تحسن الأوضاع الأمنية. أما مساهمات رأس المال العربي في بعض شركات التأمين التي تأسست بعد الغزو الأمريكي فهي صغيرة. حقاً لا يشكل التأمين “الجائزة الكبرى” للغزو والاحتلال فهذه محصورة بالثروة النفطية للشعب العراقي، وحتى هذه لا تتمثل بالفكرة المبسطة المتداولة عن تحميل النفط بثمن بخس ونقله إلى المتروبولات الغربية (النمط الاستعماري القديم).[3] لكن الحجم المتدني لأقساط التأمين في الوقت الحاضر يعكس تركة الماضي المتمثل بنتائج العقوبات الدولية (1990-2003) من جانب وإفرازات هذا القانون في تسهيل تسريب أقساط التأمين إلى الخارج من جانب آخر.
جوهر المسألة يكمن في ما يضمه هذا القانون من مواد في غير صالح قطاع التأمين العراقي، والفلسفة التي يقوم عليها، والسياسات المرتبطة به، وإهماله المطلق لتاريخ النشاط التأميني في العراق والقوانين القائمة المنظمة له، وهو ما نحاول الكشف عنه في نصوص هذا الكتاب. ويكفي هنا أن نقول بأن مشروع إعادة تشكيل قطاع التأمين مرَّ بمرحلتين.
الأولى، إعادة الهيكلة (الخصخصة) التي لم تتحقق على أرض الواقع وهو ما نعالجه في فصل بعنوان نقد مشروع إعادة هيكلة سوق التأمين العراقي.
الثانية، إعداد مسودة قانون الرقابة على التأمين لسنة 2004 وهو موضوع دراساتنا في الفصل المعنون إعادة صياغة قوانين التأمين في العراق. لكن هذه المسودة، التي أعدت باللغة الإنجليزية، لم توضع قيد التطبيق وخضعت للتعديل والترجمة إلى اللغة العربية لتصبح الأمر رقم (10): قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. وهذا هو موضوع الفصل المعنون في نقد قانون تنظيم أعمال التأمين، الأمر رقم (10) لسنة 2005
لقد كُتب قانون 2005 بقلم أجنبي جاهل بتاريخ التأمين في العراق والقوانين المنظمة له. فهو لم يُشر، مثلاً، في مسودة 2004 وما صار بعد ذلك الأمر رقم (10) إلى قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 (العهد الملكي)، وهو أول قانون صدر في 1 نيسان 1936 من قبل حكومة عراقية، ولا إلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 39 لسنة 1960 (الجمهورية العراقية الأولى)، أو قانون تأميم بعض الشركات والمنشآت رقم 99 لسنة 1964 (نقطة تحول أساسية)، أو قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (نهاية التأميم وبدء تأسيس شركات التأمين الخاصة). وبغض النظر عن تقييمنا لهذه القوانين وغيرها كثير مما له علاقة بقطاع التأمين، فإنها صدرت من قبل حكومات عراقية “مستقلة” في حين أن قانون 2005 اختلف عنها جميعاً كونه قانوناً شرعته سلطة احتلال أجنبية وقبلت به حكومة عراقية (مجلس الحكم الانتقالي) مُعيّنة على أسس طائفية من قبل سلطة الاحتلال. ويبدو أن هذه المفارقة ليست موضوعاً يستحق التوقف عنده والتفكير فيه ملياً ضمن المشروع الأمريكي للعراق: إقحام الرأسمالية في صيغتها الليبرالية الجديدة من خلال العلاج بالصدمة.
كما أن صبيان شيكاغو (أتباع مذهب ملتون فريدمان وبقرته المقدسة “السوق الحرة” التي تستعيد توازنها (السوق) دون تدخل من الدولة) لم يتوقفوا لحظة للتعرف على تجربة سوق التأمين العراقي أثناء فترة العقوبات الدولية (1990-2003) وكيف عملت شركات التأمين التابعة للدولة أولاً ومنذ سنة 2000 الشركات الخاصة وتحت مظلة شركة إعادة التأمين العراقية، في غياب إعادة التأمين الاتفاقي العالمي والعربي، اعتماداً على مواردها البشرية والمالية والأدوات الفنية المتوفرة لها. تلك تجربة فريدة في تاريخ التأمين العراقي لم تخضع بعد للدراسة وبانتظار من يقوم بها.
لم يصدر حتى الآن أي كتاب مُكرّس لتحليل ومناقشة هذا القانون الذي يُشكّل، في اعتقادي، مرحلة فاصلة في تاريخ التأمين العراقي. لقد كتب زملاء المهنة مقالات متفرقة عن القانون، وقدموا بعض الرسائل والتقارير عن الآثار الضارة له إلى أطراف رسمية ذات علاقة بالنشاط التأميني بهدف تغيير بعض بنود القانون. وحتى وقت كتابة هذا المدخل لم يتوقفوا عن المناشدة والمخاطبة. وقد تميّز الزميل سعدون مشكل خميس الربيعي بحمله العبء الأساس في التنبيه على الآثار السلبية لعدم الالتزام بأحكام قانون التأمين والحيف اللاحق بشركات التأمين الخاصة، من خلال الكتابة لوزارة المالية ومن خلال الندوات واللجان التي يعمل فيها. وكذلك ما دبجه الزميل منعم الخفاجي من ملاحظات قصيرة قيّمة غير منشورة.[4] وهذه جهود تستحق الثناء، وأتمنى أن أرى مساهمات الربيعي وزملائه موثقة في كتاب جماعي يساهم في إبراز القضايا العقدية التي تمسُّ ممارسة التأمين في العراق وتؤثر على تطور القطاع.[5] إنْ صَدَرَ مثل هذا الكتاب فإنه سيشكل، مع كتابي هذا، نواة لدراسات جديدة، مثلما سيؤرخ للنشاط التأميني في العراق منذ الغزو الأمريكي سنة 2003. وقد يتحفز البعض لاستدراك ما فاتنا كفريق وإضافة الجديد من المعلومات والتحليلات والمقترحات لتعديل القانون.
حاولت في إحدى دراساتي “السياسات الاقتصادية في العراق والخيارات البديلة: قطاع التأمين نموذجاً”[6] تلخيص العناصر الأساسية لإعادة النظر بقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 ذكرت فيها:
إن إعادة النظر يجب أن تتجاوز مجرد رصد الأخطاء والثغرات بل تمتد لتشمل الرؤية التي يقوم عليها هذا القانون. فأحكام هذا القانون تنطوي على تناقض مستتر يتيح فرصة عدم الالتزام به. فالمادتين 13 و 14 تنصان على ما يلي:
المادة-13- لا يجوز مزاولة أعمال التأمين في العراق إلا من [قبل]:
أولا- الشركات العراقية العامة.
ثانيا- الشركات العراقية المساهمة الخاصة أو المختلطة.
ثالثا- فروع شركات التأمين الأجنبية المسجلة في العراق.
رابعا- كيانات تأمين التكافل أو إعادة التكافل.
خامسا- مؤمِن أو معيد تأمين آخر يعتبره رئيس الديوان مؤهلا وذو [وذا] قدرة مالية شرط التزامه بأحكام هذا القانون.
المادة-14- أولا- لا يجوز لأي من المنصوص عليهم في المادة (13) من هذا القانون أن يمارس أعمال التأمين إلا بعد حصوله على إجازة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
لكن الملاحظ، وبشهادة شركات التأمين العراقية ومستشاريها القانونيين، أن شركات التأمين غير العراقية وغير المسجلة لدى وزارة التجارة وغير المجازة من قبل ديوان التأمين العراقي تقوم بالاكتتاب بالأعمال العراقية في أوطانها وبذلك تحرم شركات التأمين العراقية، المسجلة والمجازة من قبل الديوان وتدفع الضرائب والرسوم عن نشاطها إلى خزينة الدولة، تحرم من حقها القانوني في الاكتتاب بأعمال التأمين. وقد نشأ هذا الوضع، الذي خسرت شركات التأمين العراقية بسببه ملايين الدولارات من الأقساط مثلما خسرت الخزينة إيرادات رسم الطابع على وثائق التأمين وكذلك إيرادات الضريبة على شركات الـتأمين، وكل ذلك لأن قانون تنظيم أعمال التأمين لا يضم مواد إضافية لضبط الاكتتاب وحصره بشركات التأمين العراقية المرخصة وضمان الالتزام بهاتين المادتين. لا بل أن القانون يؤكد على حرية شراء منتجات التأمين وخدماته من أي شركة للتأمين أو إعادة التأمين. فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة 81 في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 ما يلي:
لأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين وخدماته من أي مؤمِن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون خلاف ذلك.
ولم ينص هذا القانون أو غيره خلاف ذلك. إزاء هذا الوضع يصبح ضرورياً القيام بالمراجعة الفنية والقانونية لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 فهو يشكل العنصر الأساس في السياسة التأمينية الوطنية.
وقد اقترحنا وضع ضوابط بهذا الشأن وإدخال بعض التعديلات على القانون ومنها:
1 اشتراط إجراء التأمين على الأصول والمسؤوليات القانونية الناشئة عنها لدى شركات تأمين مسجلة لدى الدوائر المختصة في العراق ومجازة من قبل ديوان التأمين العراقي، السلطة الرقابية، بموجب المادتين 13 و 14 من القانون.
2 تحريم إجراء التأمين خارج العراق، أي خارج القواعد الرقابية التي يديرها الديوان، وهو ما يطلق عليه بالإنجليزية prohibition of non-admitted insurance واعتبار مثل هذا النوع من التأمين باطلاً إلا في حالات محددة يجب النص عليها ودائماً دون إجحاف بمصالح شركات التأمين المسجلة في العراق والمجازة من قبل الديوان.
3 فرض غرامات مالية وغير مالية عند مخالفة هذا الشرط وإلزام الطرف المخالف بشراء التأمين من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.
ويمكن تعزيز الالتزام بهذه الشروط وضمان تطبيقها من خلال التنسيق مع أطراف أخرى ومنها:
الإدارات الجمركية عن طريق تقييد إخراج البضائع المستوردة على أنواعها من الموانئ العراقية البرية أو البحرية أو الجوية وذلك باشتراط إبراز وثيقة تأمين صادرة من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.
عدم تقديم السلف أو الدفع على الحساب أو إجراء التسوية النهائية لعقود المقاولات دون إبراز وثيقة تأمين صادرة من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق. وكانت الممارسة في الماضي تقوم على إلزام المقاول، عند تخلفه عن إجراء التأمين، تسديد أجر المثل (قسط التأمين المقابل لتأمين عقد المقاولة) والذي كان يستقطع من استحقاقات المقاول لدى رب العمل.
النص في عقود الدولة على إجراء التأمين مع شركات تأمين مسجلة ومجازة في العراق. وهذا أمر منوط بوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي كما أظن.
بعض هذه الأفكار وجدت لها آذاناً صاغية لدى العديد من العاملين في شركات التأمين العراقية العامة والخاصة إلا أنها لم تترجم إلى عناصر في حملة ضغط جماعية قوية على المُشرّعين والاكتفاء بمخاطبة من احتل موقع وزير المالية.
يُشكِّل نشر هذا الكتاب، مع مدونة مجلة التأمين العراقي الإلكترونية[7] Iraq Insurance Review ومرصد التأمين العراقي Iraq Insurance Monitor التي أطلقتهما بجهد شخصي من لندن ودعم بعض الزملاء في العراق، مساهمة متواضعة لدراسة قضايا التأمين في العراق من منظور أوسع خارج الكتابة التقليدية التي تُركّز على الجوانب الفنية والقانونية الصرفة – كما يشهد على ذلك ما كان ينشر في مجلة رسالة التأمين (متوقفة عن الصدور منذ ثمانينيات القرن الماضي). ولا يعني هذا التوقّفُ عن البحث في العناصر الفنية والمبادئ القانونية المنظمة للتأمين، فهذا البحث مهمٌ بحد ذاته لتوضيح وترسيخ مفاهيم التأمين، بل الخروج من دائرة الكتابة السائدة التي تظل قراءتها، بسبب طبيعتها الفنية، محصورة لدى ممارسي التأمين في حين أن إخضاع دراسة النشاط التأميني لمنظور أوسع سيساهم ليس في إثراء مواضيع البحث بل تقريب التأمين من اختصاصات الآخرين في الاقتصاد والتاريخ والعلوم الاجتماعية الأخرى. ومن إفرازات هذا التوجه تأسيس وعي عام بالتأمين كمؤسسة فريدة في أصولها ووظيفتها تستحق اهتمام الأكاديميين وصنّاع القرار والحكومات.
وهذا المقترب في دراسة التأمين هو ما حاولته من خلال العديد من الأوراق التي نشرتها في المدونة. لقد حاولتُ الخروج بعض الشيء عن دائرة المألوف في الكتابة التأمينية للإشارة والتنبيه إلى أن هناك عالماً أرحب يمكننا أن نوطّنَ فيه النشاط التأميني والكتابة عنه. وقد وَجدتْ هذه المحاولة ترحيباً من قبل مجلس تحرير مجلة الثقافة الجديدة (صدر العدد الأول سنة 1953) الذي كان سخياً معي في نشر العديد من دراساتي فيها. وله في اعتقادي فضل الريادة، بين المجلات العراقية، بالترحيب بالكتابات التأمينية.
هناك قضايا فكرية ذات علاقة بالتأمين تستحق التوقف عندها ومعالجتها نقدياً من منظور اقتصادي وقانوني وتاريخي وحتى سياسي. ويّوفر لنا قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 مثالاً لتطبيق مثل هذه المعالجة، والفرصة للبحث فيه وما يتعلق به، وكذلك إفرازاته على الواقع الحالي والمستقبلي لقطاع التأمين، بهدف صياغة سياسة للتأمين في العراق ضمن رؤية للاقتصاد العراقي تميل بوضوح إلى تقليل الاعتماد على الريع النفطي. وقد كتبت عنها في بعض دراساتي المنشورة لكن الموضوع ما زال في أوله وينتظر من يتصدى له. ليس لي الدربة الاقتصادية والقانونية وغيرها من مناهج المعرفة للخوض في المزيد من البحث فهذا منوط بتظافر جهد جماعي يشترك فيه العاملات والعاملون في قطاع التأمين مع من يناظرهم في قطاعات أخرى وفي المجال الأكاديمي.
لذلك أتمنى أن أرى أيضاً من يقوم بدراسات، بالأرقام وبالإحصائيات التحليلية، للتعّرف على تأثير هذا القانون على حجم أعمال التأمين المكتتبة، وما يقابله من تسريب لأقساط التأمين خارج العراق، ووضعه في سياقه التاريخي كي لا تُختزلَ قضايا صناعة التأمين العراقية وما تعاني منه في الوقت الحاضر وتُلقى تبعاتها حصراً على هذا القانون. وقد يتطلب ذلك مراجعة تاريخية لتطور أقساط التأمين لعدة عقود لتقدير آثار القانون مع الآخذ بنظر الاعتبار بيئة ممارسة النشاط التأميني بضمنها حجم الاستثمارات والتجارة الخارجية وثقافة التأمين وغيرها. وسيكون مفيداً لذلك اعتماد مفاهيم الاقتصاد الكلي والجزئي في العرض التاريخي، ومنها الناتج الوطني الإجمالي ومكوناته ومكانة النشاط التأميني، والتأمين على الحياة كوسيلة ادخارية، واستثمار أرصدة التأمين، والتضخم ودورة الأعمال وآثارها على النشاط التأميني، والسياسة المالية والنقدية، والطلب على الحماية التأمينية، وأسعار التأمين. ويمكن القيام بهذه المراجعة من خلال بحوث أكاديمية عندما لا تتوفر القدرات لتحقيقها لدى كيانات التأمين.
ومن الضروري التوسع في البحث ليشمل السياسات التأمينية التي تقتضي معالجة جملة من العناوين يمكن صياغتها كما يلي:[8]
دور الدولة المباشر وغير المباشر في النشاط التأميني: التأمين التجاري (من خلال شركات التأمين العامة) والاجتماعي (من خلال الضمان والرعاية الاجتماعية).
أطروحة خصخصة شركات التأمين ومدى الحاجة إليها ضمن الواقع الحالي للنشاط التأميني (تواجد شركات خاصة وعامة).
عقود النفط وغيرها من عقود الدولة التي تغفل مسألة التأمين على الموجودات والمسؤوليات القانونية والتعاقدية، أو لا يجري فيها تأكيد واضح على إعلاء مكانة شركات التأمين العراقية.
تبنّي صياغة موحدة للعقود الإنشائية للدولة، ووضع قواعد موحدة لحصول القطاع العام على خدمات التأمين لتجنب الفساد في شراء الحماية التأمينية.
إشاعة الطلب على التأمين بين المواطنين والمؤسسات التجارية وجعل فروع معينة إلزامياً من باب حماية ثروات الوطن كالتأمين ضد خطر الحريق.
رسملة شركات التأمين العامة والخاصة؛ تشجيع تحويل جزء من الأرباح لزيادة رأس المال، وكذلك تشجيع الاندماج بين شركات التأمين لخلق كيانات تأمينية عراقية كبيرة.
تحديد موقف إيجابي تجاه دور شركات القطاع الخاص، ووضع الضوابط المناسبة لعمل الشركات الأجنبية وفروعها في سوق التأمين العراقي.
تكامل سوق التأمين العراقي: على المستوى الوطني الفيدرالي وضمان حرية مزاولة العمل في جميع أنحاء العراق والخضوع للنظام الرقابي الاتحادي المتمثل بديوان التأمين.
تكامل سوق التأمين العراقي: على مستوى الخدمات النوعية التكميلية (خبراء تسوية الخسائر، خبراء تقييم الممتلكات العينية، الوساطة التأمينية، التخصص الحقوقي في التأمين، الخدمات الاكتوارية).
متابعة السياسة المالية والنقدية وتأثيرها على دور التأمين في الاقتصاد الوطني واحتياطيات شركات التأمين.
إبراز مكانة التأمين في الحياة العامة عند رسم ميزانية الدولة، وعند إجراء الانتخابات البرلمانية، وعند صياغة التشريعات المقترحة التي تؤثر على قطاع التأمين، والاستفادة من كل الفرص لتعزيز موقع التأمين. نقول هذا وفي بالنا أن الوعي بالتأمين لا يتحقق بمجرد رفع الشعار.
نحن على قناعة أن رسم السياسة التأمينية، الذي يتطلب بحثاً مستفيضاً بما فيه إعادة النظر ببنود بعض القوانين التأمينية وتلك التي لها علاقة بالتأمين[9]، وكذلك تركة الفترة ما قبل 2003، يقع على عاتق الكيانات التأمينية. ولا أملَ في رسم مثل هذه السياسة بانتظار مبادرة من وزارة المالية وغيرها من الوزارات ذات العلاقة بالتأمين. نقول هذا وفي بالنا أن الموقف الرسمي من النشاط التأميني، في قناعتنا، يدور في فلك سياسة عامة تقوم على لجم دور الكيانات الاقتصادية الوطنية من خلال إهمالها لتتعرض للمزيد من التهرؤ كي تتسهل عملية إنجاح الاعتماد على الشركات الأجنبية، وهو المشروع الذي عملت سلطة الاحتلال على وضع الأسس القانونية له وحاولتْ العمل على تطبيقه. يُضاف إلى ذلك غياب العمل الجدي على إعادة تأسيس الكيانات الوطنية كما هو الحال بالنسبة لإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية. ولذلك متى ما استطاعت كيانات التأمين (ديوان التأمين وكذلك جمعية شركات التأمين العراقية) وضع خطة تأشيرية للنشاط التأميني وصياغة رؤية له يصبح عندها سيكون سهلاً عرضها على الحكومة القائمة بهدف تبنيها كأحد مكونات السياسة الاقتصادية العامة أو على الأقل الترويج لها بين الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان.
لقد قلت أكثر من مرة إن العديد من هذه العناوين (المطالب والمقترحات) ذات طبيعة إشكالية وقد لا تحظى لذلك بتوافق جميع أطراف القطاع. قد يكون الإجماع صعباً بسبب وجود مصالح متعارضة لكن ذلك لا يعفي أياً من هذه الأطراف من طرح وجهة نظرها. فمن خلال الجدل والحوار البيني، الذي يفترض القبول بالرأي المغاير، يمكن التوصل إلى الحدود الدنيا للاتفاق على سياسات معينة.
إثارتنا للموضوع ليس من باب العتب أو الانتقاص من أي طرف بل التحفيز على تطوير وتعزيز فهم مشترك لمؤسسة التأمين ودورها في المجتمع وفي الاقتصاد وكونها حاجة أساسية للتقدم.
إلي جانب رسم سياسة لقطاع التأمين، هناك حاجة للنظر الفاحص في بعض قضايا التأمين العراقي وهي ترتبط مع صياغة هذه السياسة. (أنظر الملحق: بعض قضايا صناعة التأمين في العراق: دعوة للنقاش).
أود أن ألفت الانتباه إلى أن سوق التأمين العراقي قد شهد بعض التطورات منذ كتابة نصوص هذا الكتاب ومنها، على سبيل المثال، إصدار ديوان التأمين لجملة من التعليمات المهمة ومنها تحديد المبلغ الأدنى للضمان، وديعة الضمان، أسس احتساب المخصصات الفنية، السياسات المحاسبية لشركات التأمين، تعليمات منح إجازة ممارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين، تعليمات منح إجازة وسيط التأمين ووكيل التأمين.
وكذلك قيام الديوان بمخاطبة المؤسسات العراقية ومنها شركات النفط فيما يخص ترتيب تأميناتها لدى شركات تأمين عراقية وعدم حصرها بشركات التأمين العامة. وقد جاء تحرك الديوان بفضل اعتراض بعض شركات التأمين الخاصة على عدم التزام مؤسسات الدولة بأحكام قانون 2005 في استدراج العروض بالمناقصة للتأمين على أموالها.[10]
ومن التطورات الأخرى تزايد عدد شركات التأمين الخاصة دون أن يقترن ذلك بزيادة كبيرة في حجم أقساط التأمين المكتتبة، أو يتغير توزيع هذه الأقساط بين شركات التأمين العامة والخاصة إذ ظل الفارق بين الشركات كبيراً مع استحواذ شركة التأمين الوطنية العامة، وهي الأقدم والأغنى بين الشركات، على الحصة الكبرى من الأقساط.
هذه الإشارات للتطورات لا ترقى لرصد تاريخي للنشاط التأميني منذ صدور القانون، وغرضي منها التشجيع على بحثها وبيان نجاح أو إخفاق كيانات التأمين (الديوان، جمعية التأمين الراقية، وشركات التأمين) في تحقيق نقلة نوعية في هذا النشاط. إن مرور ما يزيد عن ست سنوات منذ إصدار القانون فترة مناسبة للقيام بجرد نقدي لمجمل أوضاع قطاع التأمين.
منذ الانتهاء من كتابة نصوص هذا الكتاب لم تظهر مستندات جديدة تُلقي الضوء على ظروف وكيفية تحرير مسودة قانون التأمين، ولم يكتب أحدٌ عنها وحتى ممثلي شركات التأمين العراقية الذين استأنس الخبير الأمريكي المنتدب برأيهم وقبله البريطاني الذي كُلف بتقديم دراسة عن إعادة هيكلة قطاع التأمين. هذه اللحظة في تاريخ التأمين العراقي بحاجة إلى من يوثقها بشكل أفضل مني. وأرى أن تقييمي النقدي للقانون بحاجة أيضاً إلى من يُخضعه للمعاينة والنقد.
في النية نشر دراسات أخرى في كتابين أحدهما بعنوان أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية[11] والثاني بعنوان جوانب اقتصادية للتأمين في العراق. وكنت قد أعددت المسّودة الأولى لكتاب بعنوان التأمين في كوردستان العراق: دراسات نقدية سنة 2009 بهدف النشر لكني فشلت في إيجاد ناشر عراقي له حتى في كوردستان العراق.
عند إعداد النصوص الحالية في كتاب للنشر قمتُ بتصحيح بضعة أخطاء في الطبع والصياغة وأضفت بعض التواريخ، لكنني لم أدخل إلا القليل من التغييرات على التحليل والحجج والاعتراضات التي وردت فيها. هناك بعض التكرار، أرجو أن أعذر عليه، جاء بفضل اهتمامي الخاص بأفكار معينة، وقد أبقيت على هذا التكرار لأن التخلص منه كان سيُخلّ بتماسك ما هو مكتوب ولقناعتي أنه يساعد في تأكيد مواقف معينة.
لقد حاولت، قَدْر الإمكان، أن أوثق في الهوامش المصادر والمراجع التي استعنت بها في كتابة هذه النصوص. أقول قدر الإمكان لأن الإحالات ناقصة بعض الشيء، وهذا النقص سببه حفظي لبعض المعلومات أثناء الإعداد دون تثبيت المصدر وهو الحال بالنسبة للمعلومات المأخوذة من الشبكة العنكبوتية. إضافة إلى أن قسماً من المعلومات هي قيد التداول الموسع بحيث تصعب الإحالة إلى كاتب أو مرجع معين. لقد أبقيتُ على الهوامش كما وردت في نصوص المقالات ولم أعدّل فيها أو أضيف عليها إلا القليل لتعريف القراء بالدراسات التي نشرتها في أوقات لاحقة.
أملي أن يُحفِّز هذا الكتاب زميلات وزملاء المهنة على تناوله بالنقد الصارم وتقويم أخطائي. ولعل من ساهم من ممثلي شركات التأمين العراقية في مناقشة إعادة هيكلة القطاع ومسودة القانون في الفترة 2003-2005 سيقوم بالكتابة عن تلك الفترة الحرجة والفاصلة في تاريخ التأمين العراقي. وآمل أيضاً أن أقرأ كتاباتهم عن التأمين والتعاون معهم في بحث القانون وما يتعلق به.
وأنا أعد النصوص لهذا الكتاب خطر ببالي أن هذه النصوص أو قل بعضاً منها ربما أصبحت قديمة إلى حد ما. ربما هي قديمة من منظور شخصي لكن القضايا التي أثرتها ما زالت قائمة بانتظار المزيد من البحث والكتابة. فالأمر رقم (10) لم يتغير والتنظيم الداخلي لشركات التأمين بقي على حاله، وقل مثل ذلك عن جوانب أخرى في قطاع التأمين. وفي ظني أن هذه النصوص تشكل مساهمة في كتابة لجانب من تاريخ التأمين في هذه الفترة.
ختاماً أود التنبيه إلى أن الآراء الواردة في نصوص هذا الكتاب تمثل وجهة نظري الشخصية ولا علاقة لها بشركة وساطة التأمين التي أعمل لديها في لندن.
(*) خيبر متخصص في قضايا التأمين
لندن صيف 2011/صيف 2013
لتزيل النص الكامل للكتاب كملف بي دي أف انقر هنا
[1] كانت مقالة د. صبري السعدي بعنوان:
Iraq’s National Vision, Economic Strategy, and Policies, Strategic Insights, Volume V, Issue 3 (March 2006(
رابط المقالة:
http://edocs.nps.edu/npspubs/institutional/newsletters/strategic%20insight/2006/saadiMar06.pdf
[2] استخدامي لمصطلح الديكتاتورية هنا فيه مجانية. لكن الهدف هو توصيف حكم ممثل الولايات المتحدة في العراق على غرار ما كان معمولاً به في الجمهورية الرومانية القديمة: ممارسة السلطة في حالة الطوارئ من قبل شخص موثوق به لأغراض مؤقتة ومحدودة.
‘Dictatorship’ here is used with some licence. The intention is to characterise the rule of the US representative in Iraq along the lines applied in the ancient Roman Republic: the emergency exercise of power by a trusted person for temporary and limited purposes. cf Hal Draper, The ‘Dictatorship of the Proletariat’ From Marx to Lenin, (New York: Monthly Review Press, 1987), p 11-12.
[4] نشرت مقالة منعم الخفاجي، بعد كتابة هذا المدخل، كفصل مستقل تحت عنوان ” التـأمــين في العراق الواقـع والطموح [تعديل بعض مواد قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005]”. أنظر: مساهمة في نقد ومراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، كتاب جماعي، تحرير: مصباح كمال (2013)، ص 15-24.
[5] أنظر: الهامش رقم 4.
[6] أنظر: مصباح كمال، “السياسات الاقتصادية في العراق والخيارات البديلة: قطاع التأمين نموذجاً” الثقافة الجديدة، العدد 333-334، 2009). يمكن قراءة الموضوع في مدونة مجلة التأمين العراقي الإلكترونية
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/2009.html
[7] رابط المدونة: http://misbahkamal.blogspot.com/
[8] سبق وأن عرضنا معظم هذه العناوين الكبيرة في دراستنا: “السياسات الاقتصادية في العراق والخيارات البديلة: قطاع التأمين نموذجاً،” مصدر سابق، وقد توسعنا قليلاً في عرضها هنا.
[9] كقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006. تنص المادة 11 على أن المستثمر يتمتع ببعض المزايا ومنها “رابعاً: التأمين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمين وطنية او اجنبية يعتبرها [المستثمر] ملائمة.” وكذلك قانون الاستثمار في اقليم كوردستان – العراق رقم ( 4) لسنة 2006 الذي ينص في المادة السابعة على حرية المستثمر في الـتأمين على المشروع لدى “اية شركة تأمين أجنبية أو وطنية يعتبرها ملائمة، ويتم بموجبه تأمين :افة جوانب العمليات التي يقوم بها “.
[10] كتبت ورقة تحليلية بالإنجليزية عن هذا الموضوع في إطار بنود التأمين في عقود جولة التراخيص النفطية قد أضمها إلى كتاب لاحق في المستقبل.
[11] تبنت إدارة شركة التأمين الوطنية، بغداد، هذا الكتاب وقامت بطبعه سنة 2012 وبدأت بتوزيعه سنة 2013.

باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
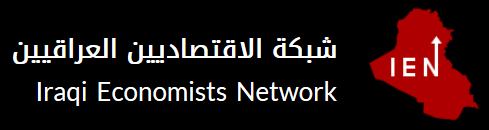


الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية