في التعريف بالهجرة
تُعرّف الأمم المتحدة الهجرة الدولية بأنها انتقال الموارد البشرية عبر الحدود القومية بشكل طاقة جسدية وعقلية. ولم تتوقف يوما ما الهجرة الدولية، وعلى هذا الأساس فإنها في كثير من حالاتها لا تمثل لغزاً كبيراً، فطالما شهد العالم موجات من الهجرة الجماعية لغرض تحسين فرص الحياة. أما الأسباب التي تقف وراءها فهي متنوعة: منها، شعور الإنسان بالتمييز العنصري أو الاضطهاد الديني أو العرقي أو السياسي. ولكن القراءة التاريخية تشير إلى أن الدوافع الاقتصادية هي الأكثر تأثيراً في دفع المهاجرين الذين يعيشون بعيداً عن أسواق العمالة التي تدفع أجورا مرتفعة نحو ترك بلدانهم الأم للتخلص من الفقر أو ربما ساعدت المجاعة في دفعها على ذلك.
إن الهجرة كظاهرة حديثة تخضع إلى نظامين: الأول يفرضه عرض المهاجرين والثاني يفرضه الطلب على المهاجرين. على الرغم من أن هذا المنطوق الاقتصادي لا ينطبق بشكل تام على موجات الهجرة التي حدثت في القرن التاسع عشر، عندما كانت تسود الأفكار الكلاسيكية حول التجارة الدولية، أفكار (ادم سميث) و (ديفيد ريكاردو) والتي افترضت عدم قدرة عنصر العمل للانتقال بين الدول، ولكنها بينت في الوقت نفسه المكاسب المتحققة من التجارة الحرة بعد تحقيق الزيادة في التخصص والحصول على الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، التي مثلت فيما بعد حافزاً إلى إدخال عنصر رأس المال، وبهذا تم الانتقال بالفكر الرأسمالي التقليدي إلى الفكر الأكثر حداثة (الاقتصاد الكلاسيكي الجديد). فبدلا من التركيز على جانب العرض فقط تم إضافة جانب الطلب ، فتصدت النظرية الحديثة للتجارة الدولية التي تنسب إلى الاقتصاديين (هكشر – أولين Heckscher-Ohlin theory) إلى هذه التطورات الجديدة في انتقال السلع إلى هذه التطورات الجديدة في انتقال السلع، ثم إلى إمكانية انتقال عناصر الإنتاج بين الدول المختلفة بعد تحسين وسائل النقل ومضاعفة دخول الأفراد، فبدأ سريان الاعتقاد بأن حركة عنصر الإنتاج إلى خارج موطنه الأصلي يؤدي إلى تقليل الندرة النسبية لذلك العنصر وارتفاع العوائد لصالح أصحاب عناصر الإنتاج الوفيرة والرخيصة، مما يترتب على ذلك تساوي عوائد أصحاب عناصر الإنتاج في الدولتين المرسلة والمستقبلة لتلك العناصر.
وتأسيساً على ذلك ساهمت الهجرة في تقليل الفقر في الدول المرسلة للمهاجرين (باعتبار أن أفقر الناس لم يكونوا في كثير من الأحيان جزءاً من الهجرة ) عند مقارنتها مع إسهام التجارة العالمية بالنسبة للدول في أسيا وافريقيا.
موجات الهجرة الجماعية
هناك اتفاق عام بأن العالم شهد موجات الهجرة الجماعية بعد أن حفز اكتشاف الأميركتين تدفقاً مستمراً من الهجرة الطوعية. وفيما يلي استعراضاً موجزاً عن الهجرة الجماعية، وكالاتي :
الموجة الأولى: حصلت هذه الموجه في أربعينيات القرن التاسع عشر واتسمت بالهجرة الطوعية للأوربيين الذين يعملون بوسيلة العقود والقسر (المحكوم عليهم بعقوبات من المحاكم) من اجل الاستخدام في العالم الجديد المحتاج إلى المزيد من العمالة، وقدرت أعدادهم بنحو 60 مليون مهاجراً أوربيا هاجروا بسبب الفقر ودون مساعدات حكومية. استوعبت الولايات المتحدة 64% من جميع المهاجرين إلى الأمريكيتين ثم الأرجنتين 17% والبرازيل وكندا أخذت الأعداد المتبقية. بعدها أخذت هذه الموجه في التقلص أثناء القرن ذاته، إلى جانب توقف زخمها نتيجة التدهور في نوعية المهاجرين على اثر المواقف السلبية تجاه الهجرة والتي ساعدت على تقوية المشاعر المعادية للمهاجرين وإحساس المواطنين الأصليين من مزاحمة المهاجرين لهم في الحصول على الوظائف، مما اجبر الكونغرس الأمريكي إلى إصدار شرط الموافقة لاستقبال المهاجر الإلمام بالقراءة والكتابة عام 1917، ثم تلا ذلك التقيد أكثر بنظام الحصص في الأعوام 1921، 1924، 1927، كما تم فرض الحظر على المهاجرين من آسيا.
الموجة الثانية: بدأت هذه الموجة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتدفق المهاجرين صوب دول أمريكا الشمالية والاوقيانوس. وقد عزز دافع هذه الموجة التغيرات الديموغرافية في الولايات المتحدة، إذ انخفضت نسبة سكانها من المولودين في الخارج من 15% عام 1910 إلى 4.7% عام 1970، مقابل ارتفاع حصة المولودين من الأجانب من 8% إلى 10% داخل الولايات المتحدة.
وفي منتصف السبعينيات من القرن المنصرم أخذت هذه الموجة بالتراجع بعد اكتمال بناء ما دمرته الحرب العالمية من البنى التحتية في أوروبا، وعودة رؤوس الأموال والذهب من الولايات المتحدة إلى الموطن الأصلي، أوروبا. وبعدها انهارت اتفاقية (بريتون – وودز) أو قاعدة الصرف (الدولار – الذهب) عام 1971 وتنامي الشعور القومي الأوربي بالوحدة بعد إعلان اتفاقية روما عام 1957 التي تمثل نواة قيام الاتحاد الأوربي الحالي والذي بلغ عدد أعضاءه (28) دولة أوربية بعد انضمام عدد من دول المنظومة الشيوعية (سابقا).
كذلك وضعت الدولة المستقبلة للمهاجرين العديد من الأنظمة للحد من تدفقهم حتى لا تصبح الصورة مخيفة عن أعدادهم. وفي الوقت ذاته ساهم عامل التحول الديموغرافي الايجابي والنمو الصناعي وزيادة معدل دخل الفرد الحقيقي في العديد من دول شرق – وجنوب شرق آسيا وحتى الدول الآسيوية الأكثر سكانا مثل الصين والهند وفي الدول الخليجية في الشرق الأوسط والتي سجلت نسبة سكان للحضر في بعض منها نحو 100% مثل الكويت وقطر والإمارات العربية، كذلك الحال في بعض دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل إلى الحد من الهجرة الجماعية.
الموجة الثالثة: حدثت هذه الموجة بعد تفكك الكتلة الشيوعية، وفي التاريخ القريب لهذه الموجة أصبح غرب وجنوب أوربا مقصداً للمهاجرين من آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. واستوعب غرب أوروبا مهاجرين من شرق أوربا، شمل ذلك جمهوريات الاتحاد السوفيتي (السابق) وترتب على ذلك تصاعد الهجرة السنوية الصافية إلى الاتحاد الأوربي، وتعززت أكثر عندما سقط سور برلين عام 1989، وتجاوزت أعدادها المليون مهاجر سنويا حتى عام 1993. واليوم تتفوق أوروبا على الولايات المتحدة في استقبال المهاجرين منتزعة بذلك (لقب دولة المهاجرين) من الولايات المتحدة والذي كانت تحتفظ به حتى عام 2000.
في هذه الموجة من الهجرة الجماعية حصل ازدهار حقيقي بعد أن جرت في مناخ اقل معاداة لسياسات الهجرة مثل ضرورة حصول المهاجر على التأشيرة أو الخضوع لنظام الحصص أو الحصول على وضع لاجئ أو الهجرة غير الشرعية أو التعرض إلى حواجز وأسلاك.
الموجة الرابعة: هذه الموجة تعد الإطلالة الأولى للهجرة الجماعية في القرن الحادي والعشرين، ونقطة انطلاق المهاجرين من الدول التي تقع في الشرق الأوسط بشكل خاص، بعد انهيار أنظمتها السياسية القائمة على أساس التخطيط المركزي على اثر الفشل الذريع في القيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، ومثل انهيارها حالة من الانفلات لأسس الدولة القائمة تحت ما يسمى بـ (الربيع العربي)، حصل الأسوأ منها في العراق وسوريا بعد احتلال التنظيم الإرهابي (داعش) مساحات واسعة من الدولتين، وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الأوضاع الداخلية فيهما، كانت في مقدمتها حصول موجات من الهجرة الجماعية في الداخل وبأعداد مليونية، والى الخارج بحجم بلغ إلى يومنا هذا بأكثر من نصف مليون مهاجر يمثل السوريون نحو 40% من هذا الحجم.
إن الأسباب التي تقف وراء هذه الموجة عديدة منها تعرض الأقليات الدينية غير المسلمة إلى الاضطهاد والتشريد والقتل، بالإضافة إلى الاقتتال الطائفي الواضح، وما تبع ذلك من انتشار الفقر والجوع والبطالة. وفي مرحلة لاحقة أدت هذه الأوضاع بالناس المتضررين إلى التفكير الجدي في ترك أوطانهم الأصلية والبحث في الهجرة إلى الدول الأخرى القريبة من الناحية الجغرافية لبلدانهم، وكانت في مقدمتها دول غرب أوروبا والتي تمتاز تركيبتها السكانية بوجود علاقة عكسية بين زيادة الأعمار (السكان ما فوق 65 عاما) وانخفاض معدلات الخصوبة. فعلى سبيل المثل، ستتضاعف نسبة السكان للفئة المشار إليها ممن تتراوح أعمارهم بين (20-65) عاما في كل من إيطاليا وبريطانيا 75% و47% عام 2050 بينما كانت هذه النسبة نحو 33% و27% عام 2005 على التوالي. هذا الواقع سيسمح بالمزيد من العمالة المهاجرة ما لم يتم زيادة معدلات الخصوبة التي تدور حول نسبة تبلغ 1،75%. ولكن في الحالتين سيسبب ضغطا كبيرا على نظام المعاشات والتقاعد ونسبة الانفاق على هذا النظام مقارنة بنواتجها المحلية الإجمالية. وعلى هذا الاساس فإن المشرفين على هذا النظام ينظرون الى المهاجرين على أنهم يعادلون مواطنين جدد ولدوا في المتوسط في أواسط الثلاثينيات من القرن المنصرم.
ويلاحظ أن في مقدمة الدول المستقبلة للمهاجرين لهذه الموجة ألمانيا التي تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو أربعة تريليون دولار سنويا، ومن ثم النمسا والدول الإسكندنافية وهي بذلك تماثل الموجتين السابقتين في اختيار المهاجرين لهذه المناطق من العالم للعيش والاستقرار فيها.
الهجرة في العراق
من الناحية التاريخية تمثل هجرة اليهود العراقيين الواسعة في خمسينيات القرن المنصرم، بعد صدور قانون إسقاط الجنسية عنهم عام 1950، أول هجرة جماعية إلى الخارج. أما الهجرة الداخلية فقد ارتبطت باكتشاف النفط الخام منذ بداية الثلاثينيات من القرن الأخير. وزادت هذه الهجرة في النصف الأول من عام 1958 وبلغت حدتها بعد تأميم النفط في سبعينيات ذلك القرن وأصبح العراق أمام مشكلة تحول ديموغرافي ناجم عن الانتقال غير المدروس من الريف إلى الحضر، فالتغير لصالح الحضر أربك مسألة التوزيع السكاني للعراق. ففي عام 1960 كانت النسبة السكانية تتوزع بين 43% للحضر و 57% للريف، وفي عام 1980 بلغت النسبة 66% حضر و 34% ريف. وتعقدت هذه المشكلة بعد عام 2003 بشكل مخيف، وأصبح سكان العراق يتوزعون بين 75% حضر و25% ريف، وهذه النسبة أعلى من مثيلاتها على المستوى العالمي البالغ نحو 52%، وبالتأكيد يمثل هذا تحدياً كبيراً للحكومات العراقية حيث يتطلب منها إيجاد فرص عمل للوافدين الجدد إلى المدن في ظل شحة الموارد المالية وارتفاع تكاليف إنشاء البنى التحتية.
وعادة ما يرتبط بهذا التغيير الديموغرافي، ارتفاع نسبة الإعالة الاجتماعية إذ يسجل العراق أعلى نسبة إعالة بين الدول العربية بنسبة تبلغ 70.4% وهذه النسبة تمثل الفئة المنتجة من السكان والواقعة بين (10 – 65) سنة التي تقوم بإعالة الفئتين الأخيرتين (اقل من 15 سنة) وأكثر من 65 سنة.
لقد افرز هذا التغير زيادة في أعداد العاطلين عن العمل بمعدلات مرتفعة ولا توجد أرقام حقيقية عن توزيعها بين الفئات العمرية بشكل عام وبين الخريجين من المعاهد والجامعات، وتشير أرقامها في احدث الإحصائيات المتوفرة عن البطالة عام 2008 أنها سجلت نسبة بلغت 16.1% بين حملة شهادة البكالوريوس توزعت ما بين الإناث بنسبة 23.1% و12.1% وسجلت نسبة 8.4% و 2.7% للماجستير والدكتوراه على التوالي.
وتمثل هذه الشرائح ما نسبته 72% من قوة العمل وهذا يعني أنها الأكثر تأثيراً في الحياة العامة. ان انتشار البطالة بينها تمثل تحدياً للسياسات الوطنية فهؤلاء يمثلون الطاقة الأكثر كفاءة وقدرة على العمل، كما ان انعدام الوسائل التي تعمل على بناء رأسمالهم البشري سواء عن طريق توفير فرص الحصول على التعليم الجيد النوعية أو من خلال سهولة الدخول إلى العمل والتوظيف، كل ذلك مثّل حافزاً لهجرة أعداد منهم لا تعرف أرقامها بعد.
إن هجرة العراقيين الى الخارج لا شك أنها تمثل نزيفاً للعقول والأدمغة أو ما يطلق عليها اصطلاحاً بالنقل المعاكس للتكنولوجيا الذي يربط بين متطلبات نقل الحزمة التكنولوجية من الدول الصناعية المتقدمة الى الدول النامية خاصة في المدة (1960-1970) مع تلك المتعلقة بهجرة الكفاءات (نزيف العقول) من الدول النامية الى الدول المتقدمة. وانطلاقا من أن التكنولوجيا هي معارف وخبرة وأن الكفاءات هي التي تولد المعارف والابداع، فإن هجرتهم تولد ظاهرة تسمى النقل المعاكس للتكنولوجيا والتي تشير الى فئة المهندسين والاطباء والفنيين الذين تلقوا المستويات التعليمية الاولية والجامعية في بلدانهم الأصلية، ثم بدأوا يعملون لصالح الشركات الأجنبية في الدول المتقدمة لاحقا.
والعراق كبلد نامي تعرّض الى عمليات منظمة من الهجرات (القسرية أو الطوعية) الى خارج العراق أثناء وبعد حرب الخليج الأولى (1980-1988) واتسمت في التسعينيات بالهجرة النوعية (أصحاب الكفاءات العراقية) وتركزت في الدول العربية خاصة (ليبيا، واليمن والاردن) ونسبة أقل في مصر والدول الخليجية علاوة على دول الاتحاد الاوربي (إنكلترا، المانيا، هولندا، الدنمارك، فرنسا، والسويد) وبنسبة أقل في الولايات المتحدة الامريكية، كندا وأستراليا.
وقد ساهمت البيئة الطاردة التي ولدت ما بعد عام 2003 نتيجة الإخفاقات المتكررة للحكومات العراقية المتعاقبة في إحداث النمو والتنمية في الاقتصاد العراقي إلى جانب ما تم ذكره هناك مجموعة من الدوافع الأخرى لهجرة العراقيين منها:
1. القوانين الاقصائية التي استبعدت الكفاءات العلمية والعسكرية تحت حجج انتمائها إلى النظام ما قبل عام 2003 دون تمييز وبقصد الانتقام من حقبة سابقة من التاريخ السياسي العراقي، في حين لم يحدث ذلك في مناطق أخرى من العالم حصل فيها التغيير السياسي كما هو حال دول جنوب إفريقيا، أو الدول الأوربية الشرقية (المتحولة)، فالأنظمة السياسية الجديدة في هذه الدول أوجدت قوانين واضحة للمسألة والحفاظ على كفاءاتها من الهجرة باعتبارهم عماد التنمية الاقتصادية وجزء من تكوين رأس المال الثابت للدولة، خصوصا العسكريين والأمنيين والأكاديميين ومختلف الاختصاصات.
2. سيطرة الأحزاب الحاكمة على مقدرات الدولة العراقية التي أخذت تعمل لصالح أجنداتها دون مراعاة المصلحة العليا للوطن.
3. استشراء الفساد الإداري والمالي في جميع القطاعات الحكومية. وقد سجل العراق مؤشرات فساد خطيرة جداً وكان انعكاس ذلك واضحاً على مناخ إقامة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذلك هروب رؤوس الأموال نحو الخارج وبمبالغ كبيرة جداً. وفي الواقع كانت هذه فرصة كافية جدا لخلق فرصة عمل للشباب العراقي تجعله لا يفكر بالهجرة .
4. زيادة نسبة الشباب (20 – 35) سنة بين الطبقة الفقيرة نظراً لتحسن المستويات الصحية وانخفاض معدلات وفيات الأطفال والتي تؤدي فيما بعد إلى وفرة من الشباب اليافعين وهم الأكثر استجابة لحوافز الهجرة.
5. فقدان الشعور الوطني لدى الإنسان العراقي الذي لا يجد أمامه غير المحسوبية في التعامل مع ابسط حقوقه في الحصول بسهوله على العمل والتوظيف، بعد أن اوجد النظام السياسي ما بعد عام 2003 مجموعة من القوانين تعمل فقط لصالح مؤيديها تحت شعار المظلومية.
6. استمرار العنف والإرهاب والحرب مع داعش وانعدام الرؤية إلى مستقبل واضح بين الشباب وهم الأقدر على تحمل مشاق الهجرة، مقابل الإغراءات المالية والمادية التي يمكن أن يحصل عليها المهاجر.
أستاذ التنمية الدولية/كلية الادارة والاقتصاد، جامعة القادسية (*)
الاراء الواردة في كل المواد المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة رأي هيئة التحرير وانما رأي كاتبها وهو الذي يتحمل المسرولية القانونية والعلمية
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 10 تشرين الأول 2015
أ.د.عبدالكريم جابر شنجار العيساوي: الهجرة الدولية في التاريخ والنظرية: قراءة في هجرة العراقيين إلى الخارج

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية
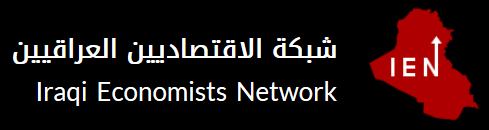

كتب الدكتور محمد على الجاسم استاذ الاقتصاد الدولى فى جامعة بغداد حول ظاهرة انتقال الاشخاص بين الدول ما يلى :
( لم يكن منطق التقليد العلمى فى معالجة مشاكل الاقتصاد الدولى هو الذى يستلزم ضرورة دراسة هذه الظاهرة فحسب وانما خطورة الموضوع هى التى فرضت نفسها ليحتل مكانا بين امهات المسائل الاقتصادية الدولية وقد نبه الى هذه الخطورة مساهمة هذه الظاهرة بصورة غير مباشرة فى الموازين الاقتصادية الدولية من جهة وتسرب اثارها الى السياسات الاقتصادية الدولية من جهة ثانية )
وحول معنى الظاهرة يذكر الدكتور محمد على الجاسم ( يطلق بعض الاقتصاديين على هذه الظاهرة اصطلاح الهجرة الدولية باعتبارها حالة انتقال مجموعة من الناس من دولة لاخرى فى سبيل الاقامة المستمرة فى البلد الجديد ومع اننا لا نعيب على هذه التسمية غير اننا نفضل لفظة – ظاهرة انتقال الاشخاص لان الهجرة لفظة تطلق على حالات الانتقال فى شىء من صفة الدوام اى الهجرة من مكان لاخر على اساس الرغبة فى المكوث الطويل وذلك يعنى ان الهجرة لا تشمل الانتقال الموْقت مثل حركات الاشخاص بين بلد واخر بقصد التجوال او الاستجمام او الاستشفاء او بقصد العمل او التوظيف او الاشتغال لفترات قصيرة محدودة )انظر الاقتصاد الدولى الكتاب الاول التبادل – الدكتور محمد على الجاسم – مطبعة دار الجاحظ – بغداد 1976
السوْال
هل انتقال بعض الاشخاص العراقيين من الرجال والنساء ( الشباب خاصة ) من العراق الى الدول الاخرى – المانيا والدول الاسكندنافية مثلا يدخل ضمن مفهوم ( الهجرة )
ارجو من الروفيسور عبد الكريم شنجار العيساوى الاجابة على ذلك
مع خالص تقديرى لمقاله القيم
ملاحظة : افضل اطلاق لفظة بروفيسور على استاذ الجامعة بدلا من لفظة ( استاذ ) التى اصبحت تطلق على كل ( افندى ) يلبس الزى الافرنجى
الأخ العزيز فاروق يونس المحترم
شكرا على مداخلتكم . أن هذة الظاهرة في أنتقال العراقيين الى هذة الدول المستقبلة لهم يعد نوع من الهجرة ، لأنها تدخل من باب الانتقال الجماعي للآسرة (العائلة) وهذا النوع من حركة البشر هو الاستعداد للاندماج في المجتمعات الجديدة . وكذلك الحال أنتقال الف
رادي للفئة العمرية النشطة أقتصاديا القادرة للعمل في البيئة الجديدة… وهذا يختلف عن الانتقال الموسمي أو المؤقت مثل الدراسة او العمل الدبلوماسي أو الدورات التدربية ، هذا النوع من عمل الاشخاص لا يدخل ضمن حسابات موازيين المدفوعات للدول المضيفة لهم ، في حين النوع الذي أشرت له هذا يدخل ضمن الحركات طويلة الآجل بقصد الاندماج النهائي لتكوين عرق أو جنس جديد…ومن الجدير بالذكر أن الاضطهاد والتمييز والعنف واحدا من الاسباب الدافعة للهجرة وهذه الحالة المميزة للهجرة التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وأفغانستانف