الاقتصاديون الشبابالجلسة الثالثة: استراتيجيّة التنويع الاقتصاديّ
18/04/2013

لمحة تمهيدية
ثمة ارتباط عضوي بين غياب مفهومي التنمية الاقتصادية والمواطنة، كمؤشرين خطيرين على تهديد وجود واستقرار الدولة العراقية.
وان التعقيد الذي يغلف طموحات التنمية ومعالجة اختلال الهيكل الاقتصادي، يفجر أسئلة عن مدى توفر الإرادة الوطنية على البناء، وعن وجود قوى تعمل على إجهاض تطلعات التنمية خوفا على مصالحها، بدليل تمكن العراق من بناء قطاع صناعي حيوي إلى جانب الحفاظ على فاعلية الزراعة في مراحل سابقة وبإمكانات اقل من الحالية بكثير، وكمدخل للحديث عن أزمة تنمية الاقتصاد الوطني ومعالجة، أحاديته الريعية، نستعيد معا محضر اجتماع البرلمان العراقي، بهدف معالجة ريعية الاقتصاد العراقي، الذي كان يعتمد على الزراعة بشكل أحادي، قبل الانتقال الى الريعية النفطية، حين أخذت لائحة قانون تشجيع المشاريع الصناعية لسنة 1929، في اليوم الثاني، من شهر كانون الثاني في ذلك العام، طريقها إلى التشريع في المجلس النيابي، بعد أن أوضح عبد المجيد علاوي نائب الديوانية ومقرر اللجنة الاقتصادية البرلمانية وقتها، ان اللائحة جائت للنهوض بالحركة الصناعية ومساعدة المتشبثين وفتح فرص عمل إمام العراقيين وأوصت اللجنة المذكورة بخفض نفقات تأسيس المشروع إلى (30 ألف روبية) بدل من (50 ألف روبية)، وخفض أجور النقل بالسكك الحديد بنسبة 30 بالمئة، كما أوصت بالإعفاءات الكمركية للمواد الخام المستوردة التي تحتاجها المشاريع الصناعية.
فيما ذكر جعفر أبو التمن النائب عن بغداد، أن اللجنة الاقتصادية ارتأت تقديم لائحة لتشجيع المشاريع الصناعية اليدوية، واقترحت تمديد الإعفاء من ضريبة الدخل الى عشر سنوات، ودعا البرلمان الى اقرار ما جاءت به اللجنة من توصيات، وصرحت اللجنة بعدم الاستفادة من اللائحة الا بعد إعداد لائحة جديدة تضم جميع توصياتها.
وبدوره أكد يوسف غنيمة على الاستفادة من القانون ودراسة توصيات اللجنة فيما لفت جميل الراوي، النائب عن الدليم نظر الحكومة إلى ضرورة تشجيع الصناعة.
وأثار الشيخ محمد رضا الشبيبي النائب عن بغداد، إن تشجيع الصناعة يكون على طريقتين، أولهما إعفاء الآلات والمكائن اللازمة للصناعة من الرسوم الكمركية وثانيها فرض ضرائب مضاعفة على المصنوعات المستوردة بهدف حماية المصنوعات الوطنية، لان البلاد بحاجة الى ذلك لاسيما وان حالة البلاد الاقتصادية ليست بالجيدة.
وعلق ياسين الهاشمي، وزير المالية في وزارة جعفر العسكري، في رده على ابو التمن، بالقول، ان ضريبة الدخل لا تقع ضمن الضرائب الأخرى، كالأملاك ورسم الوارد الكمركي، حيث تعطى قبل نجاح المشروع بهدف تشجيعه، وأما ضريبة الدخل فتستوفى بعد التحقق من أرباح، وفي تعليقه على الشبيبي ذكر الهاشمي، ان الحكومة تدرس حالة البلاد الاقتصادية، وان فرض ضرائب بنسبة 30 بالمئة، على الخام، يعني إرهاق الفلاح والعامل، وان فرض هذه الضرائب يتم في حال قيام صناعة محلية قادرة على تغطية السوق المحلية.
وبعد الدراسة قررت اللجنة تعديل المادة، بجعل مدة الضريبة، ست سنوات، ووافق النواب ووزير المالية، على التعديل، وقبلت اللائحة كليا.
واقترح النواب ضرورة شمول القانون لصغار الصناع من الحرفيين، والزام دوائر الدولة وافراد الجيش وطلاب المدارس بشراء حاجياتهم من المصنوعات الوطنية، وقد ثمن وزير المالية مقترحات اصف افندي ودعا الحكومة للاهتمام بهذه المقترحات وهكذا سن قانون رقم (14) لسنة 1929 لتشجيع الصناعة الوطنية.
والآن ونحن في عام 2013، نجد النخب الأكاديمية والرسمية تنشغل بمشكلة الاقتصاد الريعي الأحادي ذاتها، لكن على مستوى النفط بعد شبه انعدام الزراعة، ما يؤشر أن أحادية الاقتصاد العراقي لا ترجع الى الريعية بذاتها، حيث كان يفترض ان يضاف الريع النفطي مع الابقاء على الريع الزراعي على اقل التقادير، ليكون لدينا أكثر من مورد اقتصادي.
الفصل الأول/ نسيج الأزمة:
تتجلى أزمة التنمية الحالية في العراق في إهدار فرص استغلال الإمكانات المالية لتطوير الاقتصاد الوطني، وتحويله إلى قوة فعالة ومنتجة.
وان غياب الدقة في التشخيص، أو القدرة على الاعتراف بأزماتنا الاقتصادية، وبالتالي عدم وضع خطط موضوعية للمعالجة، أدى إلى ارتباك الرؤية لدى القائمين على الملفات الاقتصادية، وأوصل بعضهم إلى الخلط بين مفهومي التنمية والنمو.
ولا يستقيم حصر التنمية بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل حصة الفرد منه، من خلال زيادة في الموارد النفطية، تتم في ظل دولة أحادية الريع، باستنزاف الثروة الوطنية بنشاطات غير إنتاجية، وان تعاظم الإنفاق الاستهلاكي في جميع الاتجاهات، وارتفاع عدد موظفي الدولة من حوالي 850 ألف شخص عام 2004 الى نحو الخمسة ملايين شخص عام 2010، أدى لتضخيم جهاز الإدارة الحكومي وترسيخ ما يعانيه من بطالة مقنعة، وقد حصل كل ذلك استجابة للضغوط الكبيرة لامتصاص جزء من البطالة في العراق، والمعالجات الآنية لمشكلة الفقر، دون الالتفات الى مبدأ الكفاءة الاقتصادية واعتبارات الجدوى الاقتصادية في ادارة الجهاز، وهكذا نرى ارتفاع أعباء الدولة المالية المتعلقة بتغطية الرواتب والمخصصات التشغيلية، وفي نفس الوقت أدت هذه الحلول! إلى الارتفاع في نسبة البطالة المقنعة، وتعقيد عمل الجهاز الحكومي، وهكذا يتم ترسيخ اعتماد العدد الأكبر من الشعب العراقي على الحكومة.
وهكذا بإمكاننا تشبيه الإصرار الحكومي على التوسع الانفاقي ذي الآثار التضخمية بالمدخن الذي يعرف مضار التدخين ويستمر عليه هو الآخر.
فنتيجة لتعميق الإنفاق الحكومي الاستهلاكي، وعدم قدرة الإنتاج المحلي من تغطية الحاجات الاستهلاكية، ارتفعت استيرادات العراق من السلع والخدمات من حوالي 9,6 مليار دولار عام 2003 الى 58 مليار دولار عام 2010 والى 64 مليار دولار عام 2011 (حسب إحصائيات منظمة التجارة الدولية). ما ادى الى ظهور احتكار شبه كامل للنشاطات الاقتصادية من قبل القطاع التجاري، وتشكيل طبقة من التجار، مرتبطة باجهزة الدولة الادارية ضمن مصالح متشابكة تتقاطع مع التنمية، وتسعى بشكل جدي لإضعاف القطاعين الصناعي والزراعي، والحيلولة دون سلك خطوات جدية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، في القطاعين العام والخاص. ولم تنفذ السياسات الإستراتيجية المعلنة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمات دولية، بهدف القضاء على الفقر والبطالة وتنمية القطاعين العام والخاص وغيرها الكثير، نحو استغلال الموارد المتحققة من النفط حاليا في إنشاء مثل قاعدة تنموية، بتنويع مصادر دخل الدولة.
فالزيادة التي حصلت في الموارد النفطية والناتج المحلي الإجمالي التي يمكن أن تكون ركيزة للتنمية، ارتبطت بتدهور إسهام القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ليبقى المصدر الوحيد بنسبة (حوالي 95-96%).
فإسهام كل من القطاع الصناعي، الذي شكل نحو 13%، والزراعي الذي شكل زهاء 12,5% عام 2003، انخفض إلى حدود 1,5% واقل من 3% على التوالي. وان انخفاض نسبة القطاعات الإنتاجية غير النفطية أكثر من نسبة ارتفاع القطاع النفطي، وهو ما يثير القلق.
والعائق الأول في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق قاعدة إنتاجية واستعادة الزراعة قبل الصناعة، هو النقص الحاصل في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية، وأن تلكؤ الحكومة في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية، لازال يشكل خسارة كبيرة، وتحدي بوجه التنمية الاقتصادية.
وان ريعية الاقتصاد تعطل فاعلية السوق المحلية، فنسبة الإنفاق الحكومي، تبلغ 80 بالمائة الى الناتج المحلي الإجمالي، وثلث السكان يعمل في الزراعة التي لا تشكل اكثر من 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفضل التقديرات، فيما لاتصل نسبة الصناعات التحويلية الى 3 بالمئة، منه فيما يشكل القطاع النفطي أكثر من 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر نسبة قطاع الخدمات بـ 35 بالمائة،
الخدمات ترتبط بطبيعة الإنتاج، لذلك هي هامشية وغير منظمة، لان طراز سوق العمل المرتبط بها يقوم على الاستخدام الناقص للعمالة بنسبة 28 بالمائة، من الذين يعملون بعيدا عن اختصاصاتهم، وبساعات عمل قليلة وبأجور لا تتناسب مع كفاءاتهم.
الفصل الثاني/ مجال التنمية
لكي نعالج التشوهات البنيوية والهيكلية التي يعانيها اقتصادنا يجب بناء سوق يقوم على المنافسة وتكافؤ الفرص، وعملية بناء سوق فاعل، تحتاج لبناء مؤسسات انتاجية تعتمد على بعضها، لكي تنتهي حالة اللا يقين التي يعانيها الاقتصاد الوطني، عندما يتأكد المستثمر ان مخرجاته ستكون مدخلات لاستثمارات أخرى تعود عليه بتغذية عكسية Feedback، وقتها سينخفض متوسط الكلفة الإنتاجية وترتفع العوائد، بل ويتحرر القطاع الخاص من صورته السلبية المقاول المرتبط بجهاز الحكومة، وهنا يجب ان تشارك الدولة بشكل رشيد في العمل الاستثماري، لأنها الذراع الضارب في الاقتصاد بنسبة 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وان شراكة الدولة مع القطاع الخاص يجب ان تعتمد الشركات الخالقة للسوق، تبقى الدولة مسؤولة عن البنى التحتية التي تتكامل مع كل الشركات ونشاطاتها.
ونحتاج وزارة التخطيط لان تخطط بشكل استراتيجي، ونحتاج لاستعادة مجلس الاعمار، لمتابعة تنفيذ مشاريع إستراتيجية عابرة للأقاليم، وكذلك نحتاج لتنسيق عمل مشاريع الأقاليم.
ولدينا اراض زراعية شاسعة تكفي لبناء امننا الغذائي وقد تزيد على توفير حاجة البلاد لسبعة ملايين طن، بين خزن واستهلاك سنويا، ومن المؤسف ان نرى الخطط الحكومة تستهدف تحقيق ثلاثة ملايين طن سنويا اي اقل من نصف الحاجة رغم المساحات الشاسعة التي نمتلكها، ولان الزراعة لا تحتاج لأيد عاملة كثيرة فينبغي الاهتمام التركيز على الصناعات المرتبطة، بالنشاط الزراعي، وبناء علاقة تكاملية بين الصناعة والزراعة، لاسيما وان المشاريع الصناعية ستمتص عددا كبيرا من الأيدي العاملة، بعد تدريب وتأهيل، طالما لا يوجد تخطيط جدي، لن نستطيع إيجاد السوق، لأننا لا نحتاج تمويل بقد ما نحتاج لإرادة للتنمية ورؤية لتنظيمها وقيادتها.
ويجب الاتجاه نحو صناعات الإسكان والتشييد ولتكن لها الأولوية بعملية التنمية، وعمليا تمثل الصناعات المرتبطة بها 50 بالمئة من المشاريع الصناعية القائمة.
ونحتاج لمؤسسات سياسية مستقرة، لتأمين ضمانات سياسية طويلة الأجل، قبل الضمانات الاقتصادية، بمعنى مبدأ سيادة القانون.
ويجب ملاحظة الفارق بين تصميم الإصلاح، والانجاز الفعال للنتائج النهائية المرغوبة من جهة أخرى، فالعراق لن ينهض اقتصاديا بدون الاتجاه الجاد نحو بناء قطاعات عامة كفوءة مع دور أكبر للأسواق والمنافسة في تقرير تخصيص الموارد.
وعندما يتم تحويل القطاع العام الى القطاع الخاص (الخصخصة)، فأن الدول ربما تفشل في إدراك أن تغيراً بسيطاً في الملكية لا يضمن كفاءة أكبر.
ولننتبه الى ان الاقتصاديات الحرة لا تتطرف ازاء تدخل الدولة كما تم تصويره بعد 2003، وان تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي يصل الى 20 بالمئة في أميركا أم الرأسمالية، وان تشجيع القطاع الخاص بوساطة تحفيزه تنافسيا بإصلاح القطاع العام هما الخطوتان اللاحقتان باتجاه إرساء أو تأسيس الشروط الكافية للتنمية المستدامة والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وثمة دراسات او أبحاث قدمت في الفترة الاخيرة من قبل البنك الدولي تشير الى ان هناك إعادة نظر في تقدير دور الحكومة. وهو عامل ايجابي ينبغي ان تهتم به الحكومة، وليتمحور الهم حول التنمية المستدامة التي تحتاجها البلاد تتطلب خلق قاعدة اقتصادية يمكن الارتكاز عليها لتقليل النتائج السلبية على الاقتصاد في حال انخفاض العوائد النفطية.
الفصل الثالث/ التنمية والمواطنة:
إن تطور مفهوم المواطنة اقترن بتبلور الدولة الحديثة، التي لم يعد لجميع مواطنيها القدرة على المشاركة المباشرة في إدارتها كما في دولة المدينة أيام اثينا، بعد أن تجاوز عدد المواطنين عشرات أو مئات الملايين، مما رتب صعوبة إشراكهم جميعاً في إدارة الدولة بل وحتى صعوبة إجراء تواصل مباشر بين المواطنين ومن ينوب عنهم مما فرض تغيّراً في مفهوم المواطنة الذي كان يشترط المشاركة في إدارة الدولة كما في دولة المدينة، إذ أن هذه التطورات أضافت بعدين جديدين لمفهوم المواطنة هما البعد الاجتماعي بمعنى الانتماء والبعد القانوني- الحقوقي، إضافة إلى البعد الأول السياسي، ومع الاختلاف الكبير بين الباحثين في تحديد الإبعاد الثلاثة المكونة للمفهوم كما تبينه المناقشات الجارية بشأنه، فيمكن القول بأن المواطنة ببعدها السياسي القديم تعني حق المشاركة الفعالة في إدارة الدولة من حيث كون المواطن عضو في جماعة سياسية له حق المشاركة الفعالة في نشاطاتها.
أما في البعد الثاني لمفهوم المواطنة وهو البعد الاجتماعي فالمواطنة تعني العضوية في مجتمع سياسي (دولة) وان المواطن يحمل هوية هذا المجتمع ويخصه بالولاء، ان اهمية هذا البعد تكمن في تعزيز روح انتماء المواطن للمجتمع السياسي الذي ينتمي اليه ويحمل هويته أي تعزيز روح المشاركة الفعالة في أنشطة المجتمع ومؤسساته المدنية التي تضطلع لدور فعال في مراقبة اداء الدولة ومؤسساتها.
وان الاهتمام المبالغ فيه والفهم الخاطئ لهذا البعد، جعل تاريخ الدولة الحديثة يشهد تجاوزات على الاعتبارات الإنسانية إذ شهد انتهاك لمعايير العدالة في توزيع الثروات مع جرائم إبادة جماعية ضد الهويات المختلفة بحجة أنها جماعات تنتمي الى عصر ما قبل الحداثة وهي ضد مشروعه بل خارجة عن الشرعية أي هي ظواهر لامعقولة يجب إقصاؤها من مشهد الحياة الحديثة.
ورغم ان البعد الاجتماعي لمفهوم المواطنة يكتسي أهمية في تعزيز روح التضامن فيما بين المواطنين وعامل مهم لمشاركتهم الفعالة في إدارة الدولة لكنه ليس كافياً ما لم تكن الدولة ديمقراطية، لان المبدأ جُرّد من محتواه حين صار التركيز على هوية، مما يعني التركيز على عنصرية مكونة لها ومعبرة عنها مما سينتج بالضرورة فرز آخرين مختلفين غير ممثلين ولا حقوق لهم داخل اطار الدولة ذاتها.
وهذه نرجعها لأصل نشوء الدولة وعلة وجودها عند جان جاك روسو في نظرية العقد الاجتماعي الذي يحكم في الجوهر شكل الاتحاد الاجتماعي السياسي مثلما يحكم في الوقت نفسه مضمونه ودلالته.
وكل هذا يرتب عند روسو ان السلطة التنفيذية (حكومات ورؤساء) ما هم إلا موظفين لدى الشعب صاحب السيادة يقومون بضمان الحرية المدنية والسياسية وتنفيذ القوانين التي صنعها الشعب من خلال السلطة التشريعية، وكل خلط بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية (كما يحصل في العراق)هو بمثابة خرق للعقد الاجتماعي بنظر روسو.
وهنا تبرز الأهمية المحورية للبعد الثالث القانوني الحقوقي الذي يتمثل بمجموع الحقوق الاقتصادية الاجتماعية-السياسية- المدنية التي يتمتع بها المواطن ويضمنها له القانون وهذه الحقوق او المصالح تمثل علة الاجتماع السياسي.
وان تعزيز حقوق المواطنة لاسيما الاقتصادية منها، يخفف من حالة العنف السياسي الناتج عن التنوع العرقي والثقافي وتعدد الهويات “الاثنيات” داخل المجتمع الواحد، والتركيز على الهوية والانتماء والتماثل والانسجام اي البعد الاجتماعي لمفهوم المواطنة مع صيرورة تطور الدولة الحديثة الذي أبعدها من مبدأ العقد الاجتماعي، ولا تقتصر فائدة الحقوق الاقتصادية ومعايير العدالة على اساس الحق على تخفيف النتائج العنيفة للبعد الاجتماعي وإشكالية الهوية بل يتعدى ذلك الى الاسهام في تطوير الهوية وإعادة صياغتها.
إن العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم السياسة في العالم الحديث هي علاقة متبادلة أو مشتركة، إذ إن علم السياسة يقرر وعلى نحو كبير الاطار للنشاط الاقتصادي وتوجيهه في اتجاهات تنوي خدمة مصالح المجموعات المهيمنة وكما أن ممارسة السلطة بكل أشكالها هي مقرر رئيس لطبيعة النظام الاقتصادي. ومن الجهة الأخرى فان العملية الاقتصادية نفسها تميل الى اعادة توزيع السلطة او القوة والثروة، بمعنى انها تحول علاقات السلطة او القوة بين المجموعات.
خاتمة
يواجه مفهوم المواطنة تحديات كبرى، ترتبط باختلال وظائف الدولة المتعلقة بتأمين الحقوق الاقتصادية للمواطنين، بحسب البناء الجدلي الثلاثي (المواطنة،المجتمع ،الدولة)، وسيبقى عدم تأمين الحاجات الاقتصادي للناس، عوائق أساسية أمام بناء مفهوم المواطنة، وان امكانية العراق لجلب الاستثمارات وشراء المتطلبات تبقى متاحة بوصفه بلدا نفطيا، لكن لا يمكن شراء الإرادة الوطنية التي لا يمكن تحقيق اي نمو اقتصادي بغيابها، ولذا فالتنمية ستبقى مهددة في ظل تصاعد الروح الاثنية بتنامي الهويات الفرعية، وتوسيعها على حساب الهوية الوطنية العراقية، ولان توفير الحقوق الاقتصادية يمثل المحور الموضوعي لقيام المواطنة، فنحن بحاجة لوقفة جدية من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية، لتجنيب العراق المطبات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، التي من الممكن إن تزعزع كل الكيان العراقي، وتؤدي إلى تهديد يرتقي الى تهديد وجود الدولة.
وان تنمية الإمكانات الاقتصادية يتطلب استقرارا سياسيا وامنيا، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وسيادة القانون والامتثال لتطبيق بنوده، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، في إطار وطني تتفق عليه القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، وان ما يعانيه الاقتصاد العراقي من اختلال في إعادة توزيع الدخل، مع صور البطالة وازمة السكن ونقص الخدمات، تنعكس على الرضا الاجتماعي الذي يرتبط بمستوى الشعور بالمواطنة.
ومن هنا تنبع أهمية وجود رؤية اقتصادية واضحة مع ضرورة تجسيدها في إستراتيجية وخطط تنفيذية تعني بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرتبطة بجدول زمني وأهداف محددة قابلة للتنفيذ والرقابة والمحاسبة، تهدف الى تنويع الاقتصاد العراقي وتعزيز قدراته، مع برامج مكثفة لتدريب وتطوير الأيدي العاملة العراقية، بمختلف مستوياتها حسب متطلبات سوق العمل، سواء في القطاع النفطي ام في القطاعات الأخرى، مع ضرورة ربط الموازنة العامة للدولة بالخطط التنموية التي يجب ان تكون جدية وقابلة للتنفيذ.
قدم البحث الى الملتقى العلمي الاول لشبكة اللإقتصاديين العراقيين في بيروت 30/3 – 1/4/2013 ( *

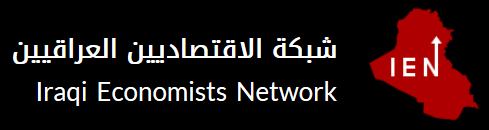

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية