الترجمة من الالمانية: د. حامد فضل الله / برلين
إن النتيجة الوخيمة لحرب الخليج سوف يكون لها أثر طويل المدى، فلقد أصابت أفئدة ووجدان كثير من المسلمين. إذ أنه من الواضح أنها كانت أكثر من هزيمة في موقعة بين جيشين مدججين بأحدث وسائل التسليح. أما المؤلم أكثر من ذلك فهو السؤال الذي يطرح نفسه حول العلاقة بين الإسلام والحداثة.
لقد حدد المثقف التونسي فوزي ميلة بدقة وإيجاز هذا الموقف المحير عندما كتب: “إذا كانت الحروب تسفر أحياناً عن ثورات، فذلك لأنها تحطم الأوهام. وإن النظرة المتخصصة تستطيع أن تكتشف تحت أنقاض حرب الخليج الأخيرة بقايا وهم ضرورة التكنولوجيا فقط من خلال أجهزة الدولة ذلك الوهم الكاذب الذي صوّر للعرب، منذ مائة عام الحداثة الغربية على أنها القوة (والقوة على أنها رمز التجديد)”. وليس صاحب تلك المقولة ممن يعادون الغرب، فإن غالبية المثقفين المسلمين غير غافلين عن حقيقة أن “الحداثة” و”التطور” ما زالا يخضعان لصياغة الغرب، وأن مقاييسهما في ذلك يحددها الغرب.
ولكن هل يعني التحديث إذن التسليم للغرب والتقليد الأعمى لسياسة التنمية، على طريقة صدام حسين مثلاً؟ إن نتيجة الحرب قد حطمت الوهم. ففي النهاية ظهر أن الأمر إنما هو صراع بين الغرب وصورة للغرب. إن الدول الإسلامية قد عاشت مائتي عام من الجمود، إذا أن عام 1798 يعتبر بحق تاريخاً مصيرياً في هذا الصدد. وقتها قاد نابليون حملة فرنسية على مصر هزم بها جيوش المماليك التي تصدت له، ومهد بذلك الطريق أمام إخضاع أجزاء من العالم الإسلامي للسيطرة الأوروبية. وكان على المسلمين ــ وهم أتباع دين عالمي وورثة ثقافة وحضارة عريقتين وأحفاد حكام امبراطوريات عالمية ــ أن يعوا بأن التقدم أصبح يفرضه الآخرون، أي غير المسلمين. وكانت الصدمة عميقة الأثر، فإن النبي محمداً، بشر في دعوته في نفس الوقت، بوضع أسس مجتمع متكامل. فأين إذن يكمن الخطأ؟ وما الذي كان يجب عمله لإعادة العلاقة بين العالم الإسلامي وغير الإسلامي إلى وضعها “الطبيعي”؟ ومنذ ذلك الحين أصبح التناقض يميّز موقف كثير من المسلمين تجاه الحداثة ذات الطابع الغربي: أخذ ما هو ضروري من الغرب حتى يمكن تجاوزه، أي اختراق تلك الحداثة للوصول بها إلى النظام الصحيح الذي يمكن أن يتفق مع الإسلام.
وإذا أردنا أن نعرض الأمر في صورة حسية يمكن أن نقول: كان المسلم في الماضي يملك قصراً منيعاً، ثم تضاءل هذا القصر حتى صار كوخاً ينظر منه المسلم الآن إلى بيت عظيم جديد يبدو حديثاً مثل كل بيوت المدينة، ولسوف يصير ملكاً له، إلا أنه موصد الأبواب ولا يملك المسلم المفتاح، ذلك المفتاح مصنوع من الحداثة الغربية، ولكن المسلم لا يملك فن صبه: الغرب كمدخل لعظمة جديدة للإسلام.
إذن أصبح الهدف هو تجاوز الغرب للتأهب لفترة ما بعد الحداثة. لذلك يحب كثير من المثقفين المسلمين موضوع ما بعد الحداثة: ففيها يصبح موقف الغرب نفسه محل تساؤل. وعلى ضوئها لا يبدو الغرب متفوقاً بشدة مثلما هو في الواقع. وتنفتح أمام المسلم أبواب الأمل في نظام يمكن أن يفي بكل مقاييس الحداثة ويكون بالرغم من ذلك متميزاً إسلامياً. ولكن ما الذي يعوق الكثيرين من المسلمين عن مواجهة الغرب بدون أية عقد وتحقيق القفزة إلى الحداثة، مثلما نجحت اليابان مثلاً في ذلك؟ وتحقيق شعار” أن نصير مثل اليابان”، أي النجاح تكنولوجياً والحفاظ في نفس الوقت على التراث. هذا هو ما يحلم به كثير من المسلمين منذ أن استطاع الأسطول الياباني هزيمة الأسطول الروسي عند تسوشيما Tssuschima. إن تحدي القوة الآسيوية بنجاح، لأوروبا كان له صدى هائل في العالم الإسلامي.
إن الإجابة على السؤال سهلة وصعبة في ذات الوقت: إن الدين الإسلامي نفسه هو الذي يغلق أبوابه أمام الحداثة ذات الطابع الغربي. فإن المسلم لا يمكنه أن يتخلى بسهولة عن القرآن والسنة كمعيار قياسي لفكره ومعاملاته في الدنيا، مع أن أي تجديد تسبقه عملية تمحيص ديني وإلقاء نظرة جديدة على فهم أسس الدين. كما أن جذور الأزمة في إطار التحديث ذي الطابع الغربي لا يمكن أن تكمن في جوهر الدين. فبكل حياد يكتب المصري رفاعة رافع الطهطاوي الذي أرسله حاكمه الخديوي محمد علي إلى باريس ليتعلّم من “الفرنجة”: ” لولا مساندة القدرة الإلهية للمسلمين ما كانوا يساوون شيئاً بالمقارنة بالأوروبيين”. فالأزمة قد نتجت عن تدهور سياسي واجتماعي نشأ عن تتالي تراكمات متزايدة من التقاليد في العالم الإسلامي. فالتحديث إذن هو عبارة عن تنقية التقاليد الدينية من الشوائب من أجل إبراز أسس العقيدة على السطح. وهنا يبرز سؤال: ماهي عناصر التقاليد التي يمكن تنقيتها، وأين يجب التوقف؟ هناك اختلاف في الآراء حول هذه النقطة. وتزداد صعوبة حسم هذا الخلاف نظراً لعدم وجود مؤسسة مركزية – عدم وجود ” فاتيكان”، أي سلطة دينية ومرجعية موحدة تصدر لكل المسلمين توجيهات ملزمة على الصعيد الديني أو الديني ــ السياسي.
إن تطور العالم الإسلامي في القرنين الماضيين هو عبارة عن تاريخ صراعه السياسي والفكري ضد الحداثة ذات الطابع الغربي. فحتى بداية الحرب العالمية الأولى كان المفكرون الإسلاميون يظنون أنه يمكن التغلب على التأخر الاقتصادي إذا ما تعلموا من الغرب سر تفوقه، بل إن أسباب تقدم الغرب موجودة أصلاً في الإسلام. إلا أن خيبة الأمل التي نتجت بعد الحرب العالمية الأولى قد تسببت في تفاقم الحالة النفسية لدى المسلمين. فقد تحطمت الامبراطورية العثمانية، آخر نظام إسلامي إمبريالي، وأصبحت قبضة الغرب أكثر شدة وإحكاماً.
واستنتجت فئات عريضة من النخبة بين المسلمين مما حدث أنه لم يعد هناك مجال للحل الوسط، وإنما يجب التقليد الحرفي للغرب، ومن ناحية أخرى إبعاد الدين كأداة للتنظيم السياسي والاجتماعي. وانتشرت العلمانية وفصل الدين عن الدولة، وكانت تركيا أكثر الدول تطرفاً في ذلك حيث قام كمال أتاتورك 1929 بإلغاء الخلافة رمز النظام الديني السياسي، وصارت نظريات أخرى ليس لها جذور في الإسلام عملات سياسية رائجة مثل القومية و الليبرالية والاشتراكية.
لقد استطاع العالم الإسلامي أن يحصل على استقلاله السياسي بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنه كان بالدرجة الأولى استقلالاً ظاهرياً. وقد تم اعلان الإفلاس في يونيو 1967، حين ثبت خطأ محاكاة التحديث على النمط الغربي وذلك عندما دمرت إسرائيل – تلك الدولة التي يعتبرها كثير من المسلمين شوكة زرعها الغرب في جسد الأمة الإسلامية- الجيوش “الحديثة” لمصر وسوريا والأردن. وهذا ما تكرر بعد ربع قرن ، على ضفاف دجلة و الفرات.
وبذلك حانت الفرصة للذين دأبوا على محاربة هذا الطريق وأصبح الكثيرون يرددون: إن الطريق القويم ليس هو فصل السياسة عن الدين، بل الاتحاد الذي لا انفصام لعراه، وليس هو استيراد الأيديولوجيات الغربية، بل أدلجة الإسلام نفسه. وصاروا يرفضون العلمانية وينادون بالإسلامية، ويرون أن طرح السلطة السياسية على أساس أيديولوجية إسلامية من شأنه حل مشكلة التحديث كما يرون إمكانية تحقيق الحداثة على دعائم ذات جذور في القرن السابع، السلطة كرمز للتجديد. وأوضح تجسيد لتلك الفكرة يتمثل في شخص آية الله خميني.
وحتى لا يكون أي مجال لسوء الفهم: ليست المشكلة في العناصر “المادية” للحداثة بمعناها الضيق، فالعِلم مقبول، مع الإشارة في كثير من الأحيان إلى ماضي الإسلام العريق، إذ لا حدود لتطور التقنية والتكنولوجيا. إلا أنه من الصعوبة بمكان أخذ التقنية والعلم عن الغرب دون التأثر في نفس الوقت بقيمه وعقائده. إذن فالتحدي الحقيقي الذي يواجه الإسلام من قبل الحداثة هو خلق نظام اجتماعي وسياسي ذي قيم يعيش فيه المسلم حياة حديثة من الناحية التقنية والعلمية، وفي نفس الوقت في إطار معايير وقيم إسلامية. ولا يوجد الآن نموذج يمكن احتذاؤه، لأن تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران لم يكتب لها نجاح “اقتصادي إسلامي”، وأصبح البلد الآن أكثر تخلفاً في عدد من المجالات عن وقت نهاية عصر الشاه. وعلى صعيد السياسة الخارجية تبذل إيران جهداً مضنياً للعودة إلى صفوف المجتمع الدولي الذي لا حل لمشاكلها إلا بمساعدته. ولكن الجمهورية الإسلامية كوهم قائم هي موضع تساؤل على الأقل. ومن ناحية أخرى فالواضح جلياً بأن طريق صدام حسين كان خاطئاً، ولقد سقط قناع التحديث عبر التعبئة الإجبارية للجماهير واستبدال شبكة التضامن التقليدية بنظام خنوع وولاء قسري، وانكشف وهم كل ذلك تحت وابل قذائف الحلفاء.
ولا تصلح ايضا السعودية كنموذج لاستراتيجية تحديث إسلامية: إن التحول التكنولوجي يسير هنا داخل إطار التقاليد الإسلامية. كما أن المكاسب المؤقتة الهائلة من البترول تتيح الفرصة لشراء تكنولوجيا العصر، إلا أن الدولة عليها أن تنفق أموالاً طائلة من اجل منع وقوع النظام القديم القائم تحت الضغط المتزايد لعملية التحديث التقني.
ولا يبقى أخيراً غير الطريق التركي للتحديث، ذلك الذي يحاول حصر الإسلام في زاوية التدين الخاص، فالأتراك الآن يطرقون أبواب المجتمعات الأوروبية، ولكن التاريخ دل على أن غالبية المسلمين لا يرون في تلك الخطوة طريقاً يحتذى. كما أنه من الواضح أن هناك موجة أسلمة، قد تجاوزت أتاتورك وغيرت بذلك صورة البلد.
إن البحث ما زال مستمراً عن نظام إسلامي ضمن إطار حداثة يحددها الغرب. بينما تسير عجلة التقدم العلمي والتقني في سرعة إلى الأمام فتزداد الهوة اتساعاً ليس بين الدول الإسلامية والغرب فحسب، بل بينها وبين الدول الصاعدة في الشرق أيضاً.
هل سيتمكن العالم الإسلامي من المشاركة الفعالة في تطور علمي ــ تقني أي حسب شعار “أن نصير مثل اليابان”، بأن نكون على مستوى الغرب ونكون جزءاً منه، فيما يتعلق بالحداثة، ورغم ذلك لا نفقد هويتنا؟ إلا أن هذه الصورة التي يتمناها العديد من المسلمين تزداد بعداً عن الواقع. وهذا الموقف المحير للإسلام في هذا القرن يمكن أن يتكرر في الجزائر. فبعد فشل الذين أرادوا تحديث البلاد عن طريق التحديث الأعمى للنظريات الغربية، يبحث الآن الأيديولوجيون الاِسلامويون عن فرصتهم تحت شعار “الإسلام هو الحل”. لاشك أن المسلم يحتاج إلى “نظام إسلامي” يمكن أن تتأخى فيه الحداثة مع الإيمان. ولكن ألا يحتاج الإسلام أيضاً إلى نهضة، أي مراجعة نقدية للمصادر؟ وهي نهضة ومراجعة ليس بمعنى فصل الحياة الاجتماعية عن الحياة الدينية كما هو الحال في أوروبا الحديثة، وانما بمعنى إعادة تعريف العلاقة بينهما، بمعنى توفيق إسلامي بين الديمقراطية، وسيادة الشعب وحقوق الإنسان.
بطلب منّا رجع الكاتب مشكورا لمقالته الأصلية ليتأمل خلاصاتها علي ضوء التطورات التي وقعت في ربع القرن الماضي وكتب الإضافة التالية:
بعد ربع قرن من نشر المساهمة أعلاه، تظهر لقارئ اليوم وكأنه سؤال مرعب بشأن المستقبل. لقد اتاحت التطورات منذ ذلك الحين ليتحول هذا السؤال إلى كابوس. صحيح لقد اختفى العديد من الحكام السابقين؛ لكن الديمقراطية وسيادة الشعب وحقوق الانسان ما زالت بعيدة عن الأنظمة السياسية. والآمال التي ارتبطت بـ “الربيع العربي”، تبين بأنها كانت ضربا من الوهم. والأسوأ من ذلك: بقيت العلاقة بين “الاسلام والحداثة” في يومنا هذا غامضة وأكثر من أي وقت مضى. اين هم علماء الدين، الذين يمسكون بأيديهم المرجعيات الدينية، من مناقشة هذا الموضوع؟ لقد ظلوا صامتين! لقد استفز البابا بنديكت السادس عشر ــ في محاضرته الشهيرة عن “الاِيمان والعقل” في أيلول / سبتمبر 2006 في مدينة ريغنسبورج ــ المؤسسة الدينية الاسلامية. ولقد تفاعل الكثير من فقهاء المسلمين في جميع أنحاء العالم وانطلق نقاش واسع حول هذا الموضوع. ولكنه سرعان ما عاد ليخبو من جديد. بدلا من ذلك تركوا الإجابة عن سؤال العلاقة بين “الاسلام والحداثة” لأولئك الذين يرونه ضمن نطاق السلطة. ولكن ليس في سلطة علمانيةٍ كعلمانية صدام حسين!، وانما في نطاق السلطة الدينية. لم يكن اهتمامهم بتحديد التوافق بين الديمقراطية وحقوق الانسان والاسلام، وانما كان اهتمامهم في المقام الأول عزل سلطة الشعب والديمقراطية من خلال “الحاكمية لله”، مما يعني دكتاتورية إسلامية. وطالما هي غير مهيمنة على كوكبنا الأرضي، سيبقى العنف استراتيجيتها المشروعة لإقامة “النظام الاسلامي”. ولكن لن تكون هذه اجابة دينية ــ لاهوتية للتحدي وإنما ردا إيديولوجيا. العنف لا يشكل حلا لمسألة العلاقة بين “الاسلام والحداثة”. إنه لن يؤدي إلى حوار عقلاني بين المسلمين للوصول لإجابة، ولا يساهم في ردم الهوة، بل في تعميقها، ولن يقود الى التنمية والتقدم، بل الى الركود والتراجع، ولن يؤدي إلى التسامح الديمقراطي وانما إلى الكراهية.
هل هناك أي منظور يدعو للتفاؤل؟ جاء في ديباجة دستور تونس 2014: “التمسك بتعاليم الاسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وبالقيم الانسانية ومبادئ حقوق الانسان الكونية”.
نعم يوجد باعث للتفاؤل!
(*) بروفسور ودكتور شتاينباخ باحث وكاتب متخصص في العالم الاسلامي والعربي، مدير معهد الشرق في هامبورغ سابقاً ويعمل حاليا في جامعة هومبولد فيادرينا للحوكمة في برلين كرئيس لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
(**) المصدر لالماني للمقال
Udo Steinbach, der Islam und die Moderne, der Spiegel, 4, 20.1.1992
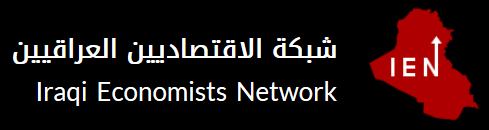


ملاحظات اولية
اولا – اقول للكاتب المحترم حسب راى المتواضع كان الافضل ان يكون عنوان المقال – الدول الاسلامية والحداثة وليس الاسلام والحداثة ذلك لان الدين الاسلامى يتضمن العبادات والمعاملات – اى يتقبل كل ما هو جديد فى معاملات الناس المدنية والتجارية عكس الديانة اليهودية او النصرانية التى اقتصرتا على علاقة الانسان بربه – فى الاسلام باب الاجتهاد مفتوح وهناك القياس وهناك الفتوى فالاسلام اقرب الى الحداثة من النصرانية ديانة الغرب المقتصرة على علاقة الانسان بالرب ولذلك كان من السهل فصل الدين عن السياسة بل كان من السهل ان يكون رجل الدين المسيحى او اليهودى علمانى دون اى اعتراض من الكنيسة – اقول ان الاستعمار الغربى هو الذى ابعد الدول النامية عن الحداثة وليس الديانة البوذية او الاسلام والحديث يطول فى هذا الموضوع
ثانيا – الازمة بداْت عشية هزيمة حزيران 1967 وجاءت حرب الخليج امعانا فى الهزيمة وللخروج من الازمة تركز الحديث حول الرجوع الى التراث الاسلامى اى الاسلام هو الحل مقابل من يقول ان القطيعة مع التراث هو الحل وهناك من يقول ان تجديد التراث هو الحل
طبعا المقال مختصر والموْلف معذور وشكرا للمترجم
مع التقدير