في سلسلة المناقشات التي دارت حول خطة التنمية الوطنية ضمن شبكة الإقتصاديين العراقيين كان هناك رأي مفاده أن الخطط الإقتصادية الكلية يجب أن تكون بشكل وثيقة إستدلالية عامة غير ملزمة قانونيا. وبني هذا الرأي على مقولة أن معظم الدول تخلت عن وضع الخطط الخمسیة بعد رواجها في عقدي الخمسینيات والستینيات وذلك لإستحالة توفر ما لا نهاية له من البیانات والتوقعات المؤثرة على السلوك الإقتصادي. في هذه المداخلة، نشير إلى أن السياسة الإقتصادية في البلدان الرأسمالية المتطورة تتطلب وتستخدم بيانات ومعلومات مفصلة عن النشاط الإقتصادي، وأن الخطط الإقتصادية في كل الأحوال لا يراد لها أن تكون المصدر الوحيد للمعلومات ولا أن تحل بديلا عن قرارات الأفراد والقطاع الخاص، ولا أن تلغي المبادرات الفنية والإدارية ضمن القطاع العام. بل على العكس من ذلك، فأن الخطط الناجحة تحفز وتساعد وتوجه، بل وتكون آمرة أيضا ولكن بما هو ممكن وعند الحاجة. وتبين مداخلتنا هنا أن الأسس الفكرية للتخطيط متضمنة في مبادئ علم الإقتصاد وفي كل مدارسه الجدية وهي موجودة أيضا في الفهم بكون السلوك الإقتصادي يتفاعل مع ويتأثر بالمؤسسات والعلاقات الإجتماعية والظروف السياسية. أما فشل وقصور تجارب التخطيط، فلا هو أمر حتمي وبديهي ولا هو من الأمور المبهمة غير معروفة الأسباب، فهناك الكثير من الفهم العلمي وإمكانية التقييم الموضوعي لتجربة بعينها ولكل من نجاحاتها وأسباب فشلها. وفي نفس الوقت، تزخر الأدبيات الإقتصادية بالدراسات التي تعنى بضعف كفاءة آلية السوق سواء على المستوى الجزئي أو الكلي.
أما الإبتعاد عن التخطیط الجاد بعد عقد السبعينات، فذلك لم يكن نتیجة تطور إيجابي في المعرفة بإدارة الإقتصاد، بل كان في الواقع نتيجة أزمات المديونیة التي عصفت بالبلدان النامیة والتي أخضعتها لسیاسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان أكدا على حل مشكلة المديونیة على حساب التنمیة والنمو. وتخلى البنك الدولي عن دعمه وإرشاده السابقين لخطط التنمية وتبنى نفس سياسات الصندوق وإملاءاته بشأن الإصلاح الإقتصادي وإعادة الهيكلة، مع إضافة برامج متفرقة في مجالات تشجيع المبادرات الفردية ونشر أفكار أفضلية سيادة السوق ووضع الإجراءات لمعالجة نتائج السياسات التقشفية ومعالجة بعض مظاهر إتساع الفقر الناتج عنها. وكل ذلك لا يشكل نسقا تنمويا على شاكلة الخطط التي كانت تنال دعم البنك في عقود سابقة، مما يشير إلى أن التراجع لم يكن نتيجة ضعف المعرفة بل لإختلاف الأهداف.
وقد ساهم سوء الإدارة الإقتصادية في البلدان النامية نفسها بما في ذلك سوء التخطيط بتعميق أزماتها الإقتصادية التي إتخذت أشكالا مختلفة كإرتفاع المديونية والتضخم النقدي والعجوزات ومختلف الإختلالات وتراجع النمو، إلا أن أسباب تلك الأزمات لا يمكن أن تعزى إلى إشكاليات التخطيط ولا حتى إلى ضعف السياسة الإقتصادية وحدهما. ومرت إثر تلك الأزمات الكثیر من البلدان بفترات طويلة من الركود وخاصة في عقد الثمانینات وتراجع دور الدولة الإقتصادي والإجتماعي وجرى تفكیك وخصخصة قطاعات واسعة من الإقتصاد تحت شعارات الإصلاح الإقتصادي والتكیف الهيكلي وفقدت البرامج الإنمائیة والخطط التنموية جدواها لأن الموارد وُجّهت لتسديد الديون أولا ولأن المشاريع الإنمائیة أصبحت رهينة مساعدات وبرامج خارجیة متفرقة وخاضعة لأولويات هذه الدولة المانحة أو تلك. ووفق طروحات ما يسمى “بإجماع واشنطن”، كانت السیاسات تركز على تأهيل الإقتصادات المعنیة لإستقبال رؤوس الأموال الخاصة وعلى وعود النمو من خلال نشاطاتها وبالتوجه نحو التصدير والإستيراد من خلال تحرير التجارة الخارجیة، وكل فشل في هذه السیاسات كان يقابل بالإدعاء أن تحرير الإقتصاد لم يكن كافیا.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود من هذه التجارب ومن إهمال التخطیط الوطني والقطاعي والبرامج متوسطة الأجل، نجد أن حصیلة هذه السیاسات كانت مزرية من حیث الأداء الإقتصادي والنتائج الإجتماعیة. وقد تخلى عدد كبیر من البلدان النامیة عن إتباع سياسات “إجماع واشنطن”، في حین دخل عدد كبیر آخر من البلدان في أزمات سیاسیة وإجتماعیة حادة كانت في الغالب نتائج لأنماط إندماجها ومواقعها الضعيفة ضمن النظام الإقتصادي العالمي.
ما ذكرناه أعلاه معروف، لكن المهم في مناقشتنا هذه أن مفاهيم وأفكار “إجماع واشنطن” التي طرحت في الثمانينات من القرن الماضي لم تعد تتمتع بنفس الهيمنة في أنحاء كثیرة من العالم. وهناك توجهات جديدة، منها ما يعرف بالتنموية الجديدة[1]New Developmentalism) ). وهذه توجهات آخذة بالتبلور وتتحدى الأفكار التي سادت في الفترة القريبة الماضیة، ومن مفاهيمها أن التنمية عملية داخلية تتطلب قبل كل شيء تعبئة الموارد والإمكانات المحلية وعدم الإعتماد بشكل أساس على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية التي قد تكون بطبيعتها مُخِلة بالتوازنات الإقتصادية حيث أن الإعتماد على الإدخارات الأجنبية لتمويل الإستثمار لا ينجح في معظم الأحوال إلا بزيادة المديونية وعدم الإستقرار المالي ويجر البلدان النامية نحو لعبة كسب ثقة رأس المال. أما الدول التي نجحت وبدرجات متفاوتة في الإستفادة من المساعدات أو الإستثمارات الأجنبية مثل كوريا الجنوبية والصين على التوالي، فقد كانت لها ظروف أو إمكانيات خاصة، ومع ذلك فهي لم تتبع سياسات الإنفتاح إلا وفق شروط صارمة مكنتها من الإستمرار في دعم صناعاتها الوطنية.
وفي إشارة ذات دلالة لحالة العراق، تحذر التوجهات التنموية الجديدة من تعزيز القوة الشرائية المحلية عن طريق الإعتماد على الدخل الريعي الذي يرفع قيمة العملة المحلية، وتقترح كبديل رفع مستويات الدخول الواطئة بطرق مختلفة، منها الإعانات ووضع حد أدنى للأجور والتوجه نحو الإستخدام الكامل للعمل لتعزيز كل من الإنتاج والطلب المحلي. وهي لا تهمل الإنفتاح على السوق الخارجية وتعتبره ضرورة، لكن مع توفر شروط داخلية وخارجية للإستفادة من هذا الإنفتاح ومنها أسعار صرف تراعي تحقق توازن تجاري ضمن القطاعات المنتجة، وخلق فرص إستثمارية منتجة لقطاع الأعمال الوطني الخاص ودعمه في تجاوز الحواجز التجارية وعقبات قوانين الملكية الفكرية المفرطة وتعزيز مصادره التكنولوجية وإمكانات توطينها وقدرات الإبتكار وتطوير المهارات، في حين أن مشورة المؤسسات الدولية تركز بشكل أساسي على جانب مهم واحد فقط وهو جانب الحماية القانونية للمستثمر، والمستثمر الأجنبي بشكل خاص.
لقد إبتعدت الكثیر من البلدان تدريجیا عن تطبیق برامج وإملاءات قوى المال والمنظمات الدولية وعادت للأخذ بسياسات تناسب أوضاعها الخاصة ومصالحها الوطنية متبعة أشكالا جديدة من التخطیط. ويمكن بهذا الصدد الإشارة إلى البرازيل كمثال مهم إضافة إلى التوجه العام الجديد في بلدان أمريكا اللاتینیة. كما كان لأزمة إقتصادات شرق آسیا في أواخر عقد التسعینات أثرها في الابتعاد عن وصفات صندوق النقد الدولي الجاهزة ونتائجها المدمرة. وشكلت سیاسة مالیزيا في حینها تحديا وصفعة لسلطة المال الدولي ولإملاءات الصندوق، إذ أنها رفضت تحرير ميزان المدفوعات وإعتمدت بنجاح نظام التحكم بتدفقات رأس المال لحين إجتياز الأزمة. كذلك كان أمر الأرجنتین التي دخلت أزمة خانقة نتيجة الإنفتاح اللامحدود وضمان وتثبيت تحويل عملتها الوطنية إلى الدولار، ولم تخرج من الأزمة إلا بعد رفضها الرضوخ لإملاءات الدائنین في عام 2001 وتخلفها عن دفع ديونها لسنوات عديدة وثم عودتها إلى إتباع سياسة الإحلال محل الواردات ودعم الإنتاج وزيادة الإعانات الإجتماعية وتخفيض العملة وتفعيل الطلب الداخلي على السلع الوطنية. ويمكن العودة إلى كتابات جوزيف ستكلیتز كبیر إقتصاديي البنك الدولي سابقا الذي خرج عن ھذه الأطر الفكرية لیقدم أشد النقد لبرامج الصندوق محملا إياها تبعة تعميق الأزمات وخاصة أزمة شرق آسیا في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. ومؤخرا أخذ كل من صندوق النقد والبنك الدولیین بتغییر بعض توجهاتهما ولكن بخجل، وأيضا بما لا يتعارض مع مصالح القوى الدولیة المهيمنة على هاتين المؤسستين.
إذن هناك الآن عودة إلى إتباع سیاسات وبرامج قطاعیة متسقة فيما بينها ضمن إطار سیاسة إقتصادية وطنیة تهتم بكل من النمو والتوازن العام، وذلك هو جوهر التخطیط. أما انعدام المعلومات والقدرات، فلا زال يشكل عائقا جديا ولكن من الممكن مواجهته عن طريق البدء بعدد قلیل من القطاعات والقضايا الرئیسیة والتدرج نحو خطط أكثر تفصیلا في مراحل لاحقة وحسب الضرورة. وكان ذلك هو ما إتبع في كل تجارب التخطیط بما فيها تجارب الدول الغربیة ومنها التخطیط الفرنسي الذي إبتدأ بستة قطاعات في الخطة الأولى وانتهى بأكثر من عشرين قطاعاً في الخطة السادسة.
والحقیقة أن التخطیط في معظم البلدان النامیة كان قد إستمر شكلیا ولكنه أفرغ من محتواه. أما الدول الرأسمالیة المتقدمة، فهي تتبع سیاسات أكثر نجاعة وكثیرا ما تكون ممارساتها عكس النصائح التي تقدم لبلدان العالم الثالث. فبريطانیا مثلا كانت قد تخلت رسمیا عن التخطیط إلا أنها أخذت بإتباع سیاسات إنفاق متوسطة الأجل، كانت
أولا بأفق زمني قدره ثلاث سنوات متحركة أي أن موازنة إنفاق السنة الثالثة يعاد وضعها سنويا، وجرى في أواخر التسعینات الإنتقال إلى تخطیط مالي أكثر صرامة بحیث يستمر الإلتزام ببرنامج الإنفاق حتى إنتهاء فترة السنوات الثلاثة. ومن الملفت للنظر أنه حتى بعد إجراء إنتخابات عامة وسقوط حكومة ما، فإن البرنامج الإنفاقي المشار إليه لا يلغى بسرعة وهو لا يُغیر في العادة من قبل الحكومة الجديدة ويستمر حتى إنتهاء مدته. وفي الفترة الحالية من حكم تحالف حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار تم وضع برنامج إنفاقي لأربع سنوات، أي إلى نهاية فترة الحكومة الحالية، وعلى دوائر الدولة وما تبقى من القطاع العام الإلتزام بالبرنامج طوال هذه المدة. إنها خطة مالیة صارمة متوسطة الأجل مبنیة على أساس أن السیاسة الإقتصادية يجب أن تأخذ مداها وألا تخضع للتقلبات المؤقتة في السوق.
هذا ما يخص الجانب المالي، أما في الجانب الحقيقي فمن المعروف أن حكومة حزب العمال الأخيرة 1997-2010 إتبعت سیاسة تحديد أهداف أداء كمية وُضعت بغاية التفصیل في مجالات قطاعات الخدمات الحكومیة وغیرها. والأمثلة على هذه عديدة ومتداولة على نطاق واسع في الإعلام، ويمكن أن يلحظها غير المتخصص، فهي جزء أساسي من الوعي العام ومن الخبرة العملية للأفراد وللعاملين في مختلف المجالات. ففي مجال الخدمات الصحية، يعي كل من الطبيب أو المؤسسة الصحية من جهة الواجبات المناطة بهم، والمواطن من الجهة الأخرى أن الخدمة يتوجب أن تقدم خلال فترة معقولة وبمواصفات معروفة. فمثلا يتوجب على خدمة الإسعاف الوصول إلى المريض خلال عدد محدد من الدقائق وفقا لدرجة خطورة حالة المريض، ويقوم المعنيون بتسجيل مواعيد وتفاصيل الإتصالات وحركة سيارات الإسعاف ومواعيد وصولها إلى المرضى وما إلى ذلك. وتُحاسَب دوائر الصحة على تخلفها عن الأداء المطلوب بما يزيد عن نسبة معينة عن الحالات وعن حالات القصور البالغة. والأمر مشابه في قطاع التعليم، فتحاسب المدرسة على ضعف أداء طلابها عن المتوقع، وتحاسب الجامعة وفقا لعدد من المعايير كعدد الطلبة المتقدمين للدراسة فيها ومستويات أدائهم وما توفره لهم من خدمات وإمكانيات، وما إلى ذلك من معايير تتطلب بيانات كمية محددة ومفصلة تطالب المؤسسة بتسجيلها ويقوم المعنيون بمراقبتها وتقييمها.
وتتسلسل الأهداف من المستويات العليا في المؤسسات حتى أدناها. فالأهداف الموضوعة لمؤسسة كبيرة تجزأ إلى أهداف لفروعها وأقسامها، فكل قسم عليه تحقيق أهداف كمية مع مراعاة مؤشرات نوعية، فمثلا يطلب من القسم إجتذاب عدد معين من الطلاب إلى برامجه الدراسية على أن لا ينحدر بالمستوى الأكاديمي المطلوب، ويحاسب القسم على تجاوز الأهداف كما يحاسب على التخلف عن تحقيقها، وفي نفس الوقت يخضع لتقييم دوري لنوعية أدائه. ومن القسم يتسلسل الهدف ليصل إلى وضع أهداف محددة لكل عضو من الهيئة التدريسية يتم التوصل إليها بخليط من الحوار والإتفاق والضغط. وللتأكيد، فإن وضع المعايير والأهداف هذه لا يقتصر على عدد محدود من المجالات بل يكاد يتسع إليها جميعا. فهناك أهداف دقيقة مطلوب تحقيقها من سلك الشرطة، مثل أن يقوم بتحقيقات ناجحة في عدد أكبر من المخالفات أو الجرائم وبأقل ما يمكن من الموارد، ونفس الحال ينطبق على الخدمات الأخرى، وحتى الجيش ووزارة الخارجية ومختلف أجهزة الدولة تخضع لهذا النوع من المعايير.
وقد لا يبدو كل ذلك بعيدا عن الأنظمة المعتادة في مختلف المؤسسات الحديثة العامة منها والخاصة، فتلك ممارسات وأساليب الإدارة الحديثة في المؤسسات الكبيرة. إلا أن ما تعنينا الإشارة إليه هو كون هذه الأهداف مستقاة من الأهداف المحددة للوزارات والتي هي بدورها خاضعة بشكل صارم لمعايير أداء مالية مركزية ومفصلة ومربوطة بالموازنة العامة للبلاد وخاصة تخصيصات برنامج الإنفاق الحكومي ذو المدى المتوسط. فهناك عدد كبير من الأهداف الكمية والمؤشرات النوعية التي توضع بإتفاق الوزارات المعنية مع وزارة المالية التي تقوم بتقييد الوزارات بالبرنامج الإنفاقي المار ذكره، وتقوم كل وزارة فيما بعد بوضع أهداف تفصيلية للمؤسسات في قطاعاتها وهلم جرا.
وبإختصار، هناك برنامج إنفاقي مركزي صارم ومفصل ومتوسط المدى يتحكم بنشاطات جزء كبير من الإقتصاد البريطاني ويؤثر ببقية الإقتصاد بأشكال مختلفة تكون دوما قيد الدراسة والمتابعة وتُجرى بين حين وآخر تعديلات على معايير الأداء لأجل تشذيبها وأخذ التغيرات الجارية في السلوك والعلاقات بعين الإعتبار بغية تحقيق الأهداف. ولا يقتصر التخطيط المالي على ضبط أداء القطاع العام، بل تصاغ السياسات من أجل الوصول إلى أهداف أخرى مثل تنشيط القطاعات المتلكئة في بقية الإقتصاد وتشجيع التطوير والبحوث ودعم القطاعات الواعدة، وكذلك تحقيق الأهداف الكلية المتعلقة بمستوى البطالة وإستقرار الأسعار وغير ذلك. ولا يخفى أيضا وجود عدد مهم من القطاعات التي تخضع بشكل مباشر للقرارات السياسية ومنها قطاع الزراعة المعتمد على سياسة الإعانات وهي سياسة أوربية مركزية، وكذلك قطاع صيد الأسماك، وهناك طبعا قطاع الطاقة وقطاع الصناعات العسكرية وكذلك نشاطات البحوث العلمية، ونضيف إلى ذلك أيضا التنمية الإقليمية، وتعتمد النشاطات القطاعية المذكورة ونشاطات محلية مختلفة لا على مستوى الإنفاق الحكومي العام فحسب، بل على ما تسعى إلى تحقيقه السياسة الحكومية أيضا وبشكل موجه.
وبشأن السياسة النقدية المتبعة، فرغم الإستقلالية التي منحتها الحكومة للبنك المركزي (بنك إنكلترة)، فإن على الأخير العمل بطريقته المستقلة وغير الخاضعة لتأثيرات الدورات الإنتخابية لأجل تحقيق أهداف عامة تضعها له وزارة المالية. ويركز دور السياسة النقدية على تحقيق إستقرار الأسعار بشكل رئيسي، إلا أن أدوات هذه السياسة في إقتصاد مثل الإقتصاد البريطاني عديدة ومعقدة، والأهداف هي أيضا ليست أحادية. فالسياسة النقدية خرجت مؤخرا هي الأخرى عن نطاقها المحدود وعادت لتستهدف مستوى البطالة كهدف بحد ذاته وكمؤشر لمستوى النشاط العام. وللسياسة النقدية أيضا مجموعة أدوات مؤثرة على مكونات الإنفاق المختلفة وحتى على النشاط القطاعي المعين، كقطاع الإسكان أو العقار بشكل عام وكذلك الصناعات الصغيرة أحيانا، ناهيك عن قطاع الوساطة المالية نفسه ذي الأهمية الخاصة في بريطانيا.
ولدى الحكومة سياسات يمكن وصفها بأنها قطاعية لكونها تبحث عن أساليب داعمة لقطاع معين دون أن تتعارض مع الإلتزامات القانونية الخاصة بإتفاقيات الوحدة الأوربية أو بإتفاقية العضوية في منظمة التجارة العالمية. وهذه السياسات كلها وخاصة تلك المرتبطة ببرامج الإنفاق الحكومية ذات المدى المتوسط تنبع أصلا من أهداف وأولويات موضوعة من قبل لجنة تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء ظهرت بشكل خاص خلال رئاسة بلير وكان الأخير يشرف شخصيا (كما أشرف على الغزو والتدمير في العراق) على وضع السياسات لحد الإهتمام بتفاصيل الكثير من الأهداف والمعايير المفصلة متوسطة المدى للوزارات ومؤسسات القطاع العام.
وتجري دائما تعديلات على أساليب الإدارة الإقتصادية وجرى بعض التراجع في الآونة الأخيرة عن بعض السياسات والأهداف شديدة التفصيل والإعتماد بشكل متزايد على ما تسمى “السوق الداخلية” حيث تقوم وحدات القطاع العام المختلفة بالتعامل مع بعضها البعض وفقا لسوق إفتراضي، ربما لحين ظهور سوق حقيقي في حال ولوج القطاع الخاص في مجال النشاط المعني. ويجري منح القطاع الخاص المحفزات للدخول في نشاطات محددة ضمن عمل المؤسسات الكبيرة والمعقدة في القطاع العام. ويبقى موضوع الأسعار في هذه السوق الإفتراضية، فهذه يتم تحديدها إداريا، ونعود بذلك إلى أساليب التخطيط السوفيتية التي إستخدمت مزيجا من الأوامر والأهداف والحوافز والأسعار المحددة إداريا، وطبعا قليلا من آليات السوق. وللأخير في بريطانيا بطبيعة الحال حيز كبير جدا، إلا إنه أيضا كما ذكرنا متأثر بسياسات موجِهة فعالة.
فلا عجب إذن أن نجد في الأوساط العلمية مقارنة صريحة بين “التخطيط” البريطاني الحديث والتخطيط السوفيتي الماضي، بل ونجد وصفا لنظام إدارة الأداء في بريطانيا بأنه نظام “هدف وإرهاب” (target-and-terror) في إشارة إلى شدة وقسوة النظام في محاسبته الإدارة والمؤسسات المتلكئة في تحقيق الأهداف.[2] إذن فدون تسمیتها خططا، هناك خطط فعلية غاية في الصرامة والتفصیل، وهي طبعا لا تلغي السوق ولا تستعیض عنه بالأوامر الإدارية، بل بالعكس إن السیاسة العامة المتبعة في البلدان الرأسمالیة هي سياسة تفعیل وتعمیق دور السوق بكل إيجابیاته وسلبیاته، ولكنها سوق تخضع لتدخل مؤسسي مبرمج وشديد ولسیاسات مفصلة في الكثیر من القطاعات. وكما أشرنا، فإن المعلومات المطلوبة لهذه البرامج والسیاسات هي في غاية التفصیل ولكنها ممكنة ويجري توجیه وإجبار المؤسسات على إعداد المطلوب منها.
ولا يقصد مما أوردناه من تفاصيل عن وضع وتطبيق السياسة الإقتصادية في بريطانيا كمثال للبلدان الرأسمالية الغربية عامة إلا أمرا واحدا وهو أن التخطيط الإقتصادي لا يتعارض مع السوق بل يتطلب معرفة دور وحدود كل من الخطة والسوق، وذلك يختلف من إقتصاد لآخر ومن مجتمع لآخر وكذلك من قطاع إقتصادي لآخر، ناهيك عن مؤثرات وأولويات القرار السياسي. وهذه الأولويات تخضع بالتأكيد لآليات النظام السياسي ولنتائج الإنتخابات في النظام الليبرالي، إلا أنها تخضع أيضا لمختلف هياكل السلطة في المجتمع والمؤثرة في محصلات القرار ومنها سلطة المال والهيمنة الفكرية وسلطة الإعلام وقدرات الجماعات المنظمة والنفوذ في أجهزة الدولة وفي النظام القانوني وحقوق الملكية وغيرها. وهذه المحصلة تحدد التوجهات الإستراتيجية، ونجد وفقا لذلك أن للقطاع الصحي مثلا أكثر من وجهة إستراتيجية واحدة وقد يسعى بدرجات متفاوتة إلى تحقيق أهداف متضاربة، وتتضمن الأهداف والمؤشرات المحددة لهذا القطاع إهتمامات ومصالح المجتمع من جهة، ومصالح شركات صناعة الأدوية وشركات الخدمات الصحية وأهدافها الربحية الخاصة ومعها أصحاب النفوذ والطبقة الحاكمة من الجهة الأخرى. وكذلك الحال في القطاعات الأخرى وتختلط المفاهيم والنظريات الإدارية بصراع المصالح، فالتخطيط إذن هو أسلوب عمل وليس أيديولوجية جامدة، وهو أيضا عرضة للفشل لأسباب عديدة ومنها عدم التوافق الإجتماعي وصراعات المصالح حول أهداف السياسة الإقتصادية.
وإذ تنئى السياسة الإقتصادية في البلدان الرأسمالية بنفسها عن التوزيع الكمي للموارد وعن التدخل المباشر في قرارات القطاع الخاص إلا فيما ندر، فإنها في واقع الحال تمارس مستوى عال من التدخل الهادف والفاعل في الإقتصاد ومن التنسيق فيما بين السياسات المختلفة على المستويات الكلية والقطاعية وحتى على مستوى المنشأة. أما في إطار التنمية وعمليات إعادة الإعمار في بلد كالعراق، فليس هناك من بديل عن التخطيط الإقتصادي الوطني بشكل وآليات مناسبة وعن دور إقتصادي فاعل للدولة بشكل خاص. وما الدعوة لإتباع آليات السوق لا كمساعد بل كبديل عن التخطيط إلا فكرة طوباوية. والتلويح بأن كل دعوة للتخطيط أو لتعضيد دور السياسة الإقتصادية هي دعوة مؤدلجة وعقائدية بائدة هو خطأ شائع. إن الدول والمؤسسات الغربية التي تروج لما أصبح نوعا من أصولية السوق هي نفسها التي تمارس في بلدانها سياسات مختلفة، كما أن الجمود الفكري والعقائدي في مجال السياسة الإقتصادية أصبح بعد عشرات السنين من التجارب الفاشلة ممثلا بدعوات إطلاق وتحرير الأسواق أكثر مما هو بالدعوة إلى التخطيط.
وعودة إلى موضوعنا، إن العراق الیوم بحاجة إلى خطة ملزمة أكثر من أي وقت مضى مع أحادية المورد ومع اتساع أدوار الحكومات المحلیة، فكیف من دون خطة ملزمة ورقابة جادة تعالج فوضى الصلاحیات والبرامج والمشاريع؟ وتنعكس هذه الفوضى على أشدها في السياسة النفطية حيث تطالب عدد من المحافظات بحق التعاقد مع الشركات الأجنبية على مشاريع إستغلال الثروة النفطية وتتخبط الحكومة نفسها في محاولات إرضاء المحافظات من جهة والشركات الأجنبية والمصالح الدولية من جهة أخرى. ويظهر عبث العقلية الرافضة للتخطيط في عقود جولات التراخيص النفطية التي إعتمدت مستويات إنتاج الذروة كنتاج عرضي لآلية الجولات نفسها، لتعود بعد فترة قصيرة للتفاوض ودفع ثمن باهض بغية التوصل إلى برنامج إنتاجي أكثر عقلانية وأقل إهدارا للموارد.
ودون شك أن الفساد والشلل في أجهزة الدولة والعملیة السیاسیة وتجربة عقود من الإستبداد أفقدتنا جمیعا الثقة بدور وإمكانیات الدولة. وجاء الإحتلال البغيض وما تبعه من دمار وفوضى ليعمل على تقويض البناء المؤسسي للدولة. ولكن لا سبیل دون إصلاح الدولة وإعادة فاعلیتها التنموية، أما الفساد فموقعه لیس في الدولة وحدها بل في العلاقة والتداخل بین الدولة والمصالح الخاصة وما يعنیه هذا، هو أن إضعاف دور الدولة لیس حلا بحد ذاته وأن السیاسة الإقتصادية والتخطیط يتطلبان وعیا ومشاركة إجتماعیة واسعة إضافة إلى جانبهما الفني. أما ما يذكر حول أرجحیة عجز مؤسسات الحكم عن الإتفاق على قانون خطة إقتصادية، فهي نفس المعضلة التي ستواجه أية سیاسة إقتصادية عقلانیة. فهل سيكون مقبولا التخلي عن هذه السياسات العقلانية لمجرد مصاعب في الإتفاق عليها؟
*) باحث وكاتب اقتصادي
**) أشكر د. علي خضير مرزا ود. فاضل عباس مهدي على ملاحظات قيّمة أبدياها حول صيغة سابقة لهذا المقال دون إلزام بمحتواه
[2] أنظر http://www.lse.ac.uk/study/executiveEducation/customisedExecutiveEducation/INAP/Targetworld.pdf
الاراء الواردة في هذا المقال لاتعكس وجهو نظر شبكة الإقتصاديين العراقيين وانما وجهة نظر الكاتب والذي لوحده يتحمل المسؤولية عن المحتوى
لتنزيل المقال كملف بي دي أف انقر هنا

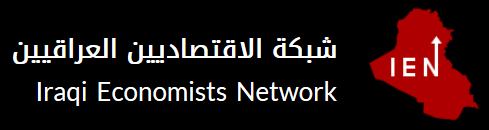

اولا وقبل كل شيىء اتفق كامل الاتفاق مع استاذى الباحث حيث يقول ( وما الدعوة لاتباع اليات السوق لا كمساعد بل كبديل عن التخطيط الا فكرة طوباوية والتلويح بان كل دعوة للتخطيط او لتعضيد دور السياسة الاقتصادية هى دعوة موءدلجة وعقائدية بائدة هو خطاء شائع )
وثانيا – اتفق تمام الاتفاق مع استاذى الباحث حيث يقول ( العراق اليوم بحاجة الى خطة ملزمة اكثر من اى وقت مضى )
لننظر الى بلدنا العراق اين هو موقعه بين الدول من حيث مستوى الدخل
دول عالية الدخل
دول متوسطة الدخل
دول منخفضة الدخل
لننظر الى بلدنا العراق وفقا لمعايير النمو
دول متقدمة
دول نامية
لننظر الى تقسيم اخر للدول النامية
دول ذات دخل منخفض
دول ذات دخل متوسط
دول صناعية جديدة
دول الاوبك
نعم العراق دولة نفطية من دول الاوبك لدينا موارد مالية جيدة والحمد للله
كم نخصص من هذه الاموال للاستهلاك وكم نخصص من هذه الاموال للاستثمار
نحن بحاجة الى تحويل الاقتصاد العراقى من اقتصاد نفطى وحيد الجانب الى اقتصاد صناعى – زراعى متعدد الجوانب
نحتاج الى استثمارات فى البنية التحتية المادية والى استثمارات فى بنية الانسان – فى التعليم – فى الصحة – فى البحث العلمى – فى توفير مياه الشرب النقية – فى خدمات الصرف الصحى – فى المحافظة على البيئة – فى الاتصالات والمواصلات – فى تنمية الارياف العراقية – نحتاج الى الصناعات البتروكيمياوية – الى الاسمدة – الى المنتجات النفطية — الى — الى
استاذى الفاضل د. كامل مهدى
العراق كان وما يزال بلد غنى بموارده البشرية والمادية ولم يكن وسوف لن يكن يوما ما معنيا بما سمى ( اجماع واشنطن )