مقدمة:
دخل علم الأجتماع كفرعٍ مهم من فروع المعرفة الأنسانية الى المؤسسة الأكاديمية العراقية أولاً من خلال بوابة كلية الآداب، جامعة بغداد عام 1954، ليظهر كقسمٍ علمي جذاب وممتع ومفيد. وسرعان ما أجتذب القسم الناشئ الفتي أعداداً متزايدة من الطلبة المريدين والراغبين والطامحين على السواء، وإنضم اليه عدد من التدريسيين اللامعين الشباب ممن كوّنوا لبنة علماء الأجتماع في العراق من أمثال علي الوردي وعبد الجليل الطاهر وقيس النوري ومتعب السامرائي وتبعهم آخرون. أما وقد أتم القسم عامه الستين فأنّ من المتوقع أنْ يبرز أكثر رسوخاً وقوة وإنتشاراً إلا أنّ واقع الحال لا يشير الى ذلك. فالأغلبية الساحقة من الطلبة المقبولين في السنة الأولى في أقسام علم الأجتماع في مختلف الجامعات العراقية الحكومية في الغالب[2]، تظهر سمات السخط والقنوط لقبولهم هنا، حيث يوزع الطلبة مركزياً من قبل دائرة التوزيع المركزي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويستسلم البعض الآخر لواقع الأمر كمن رضي بنصيبٍ لم يكن ليخير فيه. لقد بهتتْ الأضواء وتوارتْ الأفكار ولم يعد البعض ليطمح الى أكثر من شهادة جامعية لتأمين الحصول على وظيفة حكومية تؤمن دخلاً متواضعاً إنّما مستقراً.
نحاول في هذه الدراسة التعرف على إحتمالات المستقبل بالنسبة لأقسام علم الأجتماع في العراق. لقد إعترت العلم مشكلات كثيرة يظهر تأثيرها واضحاً من خلال قلة، وفي الأقل غياب وهج التميز الفكري والعلمي في الدراسات الأجتماعية التي لم يصل معظمها خارج حدود الكلية أو القسم المعني. وإختلط صوت المحلل والمفسر السوسيولوجي للعالِم أو الطالب في مجال علم الأجتماع بأصوات المختصين في مجالات معرفية أخرى كالسياسة والتاريخ والدين والفلسفة واللغة بل وضاع بعضها في أتون تفسيرات العامة. وفيما إزدادت أعداد الطلبة المسجلين في أقسام علم الأجتماع في مختلف الجامعات العراقية على مستوى الدراسات الأولية والعليا على السواء وإزدادت معها أعداد الرسائل والأطاريح المجازة لغرض الحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه التي تقترب بسرعة من سقف الخمسمائة رسالة وأطروحة[3]، إلا أنّ القليل منها فقط إستطاع أنْ يشق طريقه ليقول شيئاً ما ويسهم بصنع الأمل لتقديم شخصية علمية معروفة من وزن شخصية د. علي الوردي الذي فاق بشهرته ومتعة محاضراته ومؤلفاته الآفاق. ولعل من سوء حظ العلم أنْ يتأسس القسم على يد الدكتور علي الوردي الذي سنّ سنّة ظهر فيما بعد أنّ من الصعب مجاراتها وموازاتها.
تنطلق الدراسة الحالية من تساؤل رئيس حول مستقبل علم الأجتماع في العراق! فهل يستطيع هذا العلم أنْ ينهض ويحقق إختراقاً في الوعي الفكري والثقافي العراقي كما يفترض أنْ يفعل كل المشتغلين في مجال العلوم الأنسانية الأخرى على وجه العموم وكما فعل د. علي الوردي في خمسينات وستينات القرن الماضي. ما هي المشكلات التي تواجه نهضةً وأختراقاً مفترضاً من هذا النوع! وهل كان لعلماء الأجتماع الرواد في العراق ممن ينظر اليهم عالياً دور في هذا الأشكال! ويكمن السبب في هذا التساؤل في أنّ علماء الأجتماع المحدثين في العراق درسوا على أيادي أولئك العلماء الرواد وقرأوا لهم ومنهم وعملوا بأشرافهم ونالوا تواقيعهم. لماذا يعاني الطلبة المحدثون والحائزون على شهادات الماجستير والدكتوراه في مجال علم الأجتماع من مشكلات مهنية كثيرة لعلّ أشدها خطورة على مستقبل العلم تلك التي تبدأ بالأطار النظري والمنهجي الفضفاض الذي يترك الطالب نهباً لأسلوب السرد والعرض المفتوح ويجعله يمر عبر طقوس الكتابة المهلهلة وغير المتماسكة حتى بلوغ إشكالات التوثيق العلمي ورصد المصادر وما اليها. لماذا يعاني طلبة علم الأجتماع في العراق من ضعف القدرة على التحليل العلمي المهني الجيد والمتسلسل والمتين. لماذا تعتمد معظم الرسائل والأطاريح على طرق منهجية نمطية كما في طريقة المسح الأجتماعي وإستخدام أبسط الطرق الأحصائية في التحليل كالنسب المئوية دون غيرها الى جانب طرق إحصائية وصفية لا تتجاوز ما يوجد في الفصل الأول من أي كتاب في الأحصاء الأجتماعي كالمعدل والنمط والأنحراف المعياري ومعدل كاي وما اليها. والأنكى من هذا أنّ كثيراً من الطلبة يستخدمون هذه الطرق دون أنْ يدركوا وظيفتها العلمية حتى لكأنّها تستخدم بطريقة لا يمكن للرسالة أو الأطروحة أنْ تجاز بدونها – نوع من إسقاط فرض. ثمّ لماذا ينشغل الطلبة بأسلوب الحشو والسرد الرتيب كما في شرح معنى العينة على وجه العموم وطريقة قياسها ومعنى النظرية السوسيولوجية العلمية بحد ذاتها ووظيفتها وما الى ذلك مما يفترض أنْ يكون الطالب أتقنه وأستوعبه في السنة التحضيرية التي تسبق مرحلة كتابة الرسالة أو الأطروحة. وفيما يتعلق بالدراسات السابقة، غالباً ما تظهر أنماط متحجرة في العرض والتحليل حيث يطلب من الطلبة مراجعة دراستين ‘دوليتين’، وأخريين عربيتين ودراستين عراقيتين. فيما يتعلق بالأخيرة (دراسات عراقية) غالباً ما يراجع الطلبة دراسات تمّ القيام بها من قبل زملائهم الطلبة ممن أنجزوا رسائلهم أو أطاريحهم العلمية دون إهتمامٍ يذكر بما تنطوي عليه مثل هذه الرسائل والأطاريح التدريبية على إشكالات نظرية ومنهجية. أما الخلاصة فأنّها في الغالب مشتتة وغير دقيقة وبخاصة تلك التي تكتب باللغة الأنكليزية بغية تقديم العمل لجمهور أوسع. يظهر الأساس لعديدٍ من مثل هذه المشكلات في أعمال علماء الأجتماع الرواد. لذلك، فأنّ الدراسة الحالية تقترح العودة الى عينات مختارة من أعمال أولئك العلماء الرواد والجيل الذي تبعه وصولاً الى عدد من علماء علم الأجتماع المحدثين بغية التأمل في أعمالهم وإنجازاتهم وإسهاماتهم التي يمكن أنْ تساعد على إستكشاف جذر المشكلة. عندها قد نتمكن من أنْ نقول شيئاً عمّا يمكن عمله وإلا فأنّ آفاق المستقبل للعلم قد لا تكون مدعاةً للدعة والطمأنينة وبخاصة في ضوء التنامي الواسع والمتسارع لمختلف فروع المعرفة الأنسانية والحاجة الى حضور فاعل وقوي حمايةً للعلم أولاً، ودعماً لدوره الفاعل والمؤثر في المجتمع، ثانياً.
تركز هذه الدراسة على علماء علم الأجتماع العراقيين ممن عملوا في العراق ولا زالوا يعملون فيه. معروف أنّ هناك الكثير من الأجتماعيين العراقيين اللامعين ممن يعملون خارج العراق في جامعات أمريكية وأوربية مرموقة، إلا أنّ هؤلاء سيستثنون من هذه الدراسة لأسباب واضحة لعل من أبرزها أنّهم عملوا ويعملون في مؤسسات أكاديمية ذات قواعد عمل راسخة ومحددة سلفاً وأنّهم صاروا بمحض الحصول على فرصة عمل في أيٍ من هذه المؤسسات جزءاً من بنية إجتماعية تقف بصلابة ورسوخ. يختلف الوضع في العراق من حيث أننا لا زلنا نتمتع بقدرٍ كبير من الحرية المرغوب بها أو غير المرغوب بها للتلاعب ببنية المؤسسة، أو، أحياناً الخضوع لها خضوع العبد لسيده إبان العصور الوسطى. بمعنى أنّه بينما يحظى التدريسي أو الأكاديمي العراقي بقدرٍ من القدرة على التأثير في صياغة ما يقوم به فأنّه أيضاً يخضع لبيروقراطية متزمتة لا تتيح إلا قدراً محدوداً من الحرية للتطوير والتغيير. وتكمن في هذه الصيغة المتناقضة بطبيعتها واحدة من أهم المشكلات التي تواجه تطور علم الأجتماع في العراق.
أولاً: علي الوردي
معروف أنّ علي الوردي كان أول من حصل على شهادة دكتوراه فلسفة في علم الأجتماع من جامعة تكساس، أوستن الأمريكية عام 1950 عن أطروحته الموسومة، ‘تحليل إجتماعي لنظرية إبن خلدون: دراسة في علم إجتماع المعرفة’[4]. وكان لعودة الوردي أثرٌ مهم بل وحاسم لتقديم علم الأجتماع والعمل على تأسيسه في العراق من خلال فتح قسم علم الأجتماع الذي بدأ بالتكامل من خلال إجتذاب أعداد متزايدة على نحوٍ حذر ودقيق في حينها لأساتذة أكفاء من أمثال عبد الجليل الطاهر وقيس النوري ومتعب السامرائي وآخرون أنضموا اليهم كما سنأتي على ذلك تباعاً.
أرسى د. علي الوردي القواعد الأولى لعلم الأجتماع والتي تتضح معالمها في أطروحته للدكتوراه المشار اليها أعلاه. وتظهر مراجعة الأطروحة القدرة الفذة للوردي في المناقشة والتحليل والتفسير ومن ثم الأضفاء وتوظيف الأفكار. كما تظهر الأطروحة قدرة الوردي على الدعوة للبحث عن مسلمات نظرية شرقية عربية إسلامية مختلفة عن المسلمات النظرية السوسيولوجية السائدة في الغرب، ليس على أساس المواجهة والخصومة والتفنيد والتسفيه وإنّما على أساس البحث عن مسببات تنسجم مع الواقع الأجتماعي والثقافي للمجتمع العراقي بأعتباره ميدان العمل الأول الذي يمكن أنْ ينفتح لدراسة المجتمع العربي الكبير في أعمال مستقبلية. وقد لاحظ هذا المنحى لدى د. الوردي مختصون يعملون في مجالات علمية أخرى[5]. ومثل أي أطروحة دكتوراه من جامعة رصينة بدا واضحاً أنّها كتبت بطريقة تعبر عن الألتزام العلمي العالي بقواعد العمل الأكاديمي من حيث التنظيم والتصنيف وتسجيل المصادر وما اليها. ومن حيث يدري أو لا يدري، أشار الوردي في معرض مناقشة موضوع النظرية الى ما أسماه (محاضرات د. لويس فرث) صاحب النظرية الحضرية في الولايات المتحدة. إلا أنّ هذه الأشارة سرعان ما أصبحت حجة لدى بعض طلبة الدراسات العليا في العراق ممن أصبحوا يشيرون الى محاضرات أساتذتهم في القسم على أنّها مصدر لا يرقى الشك الى مصداقيته. وجرى التنبيه الى هذه الظاهرة الخطيرة والتأكيد على عدم سلامتها من حيث أنّ محاضرات فرث أو ميد شئ ومحاضرات آخرين لم ينتجوا نظرية وإنّما توقفوا عند حدود نقل المعرفة النظرية ومن مصادر ثانوية في الغالب شئ آخر.
وجاءت فيما بعد أعمال د. الوردي وأولها، ‘شخصية الفرد العراقي’[6]، وهي المحاضرة التي ألقاها في كلية الملكة عالية عام 1952 والتي إنطوت بالأساس على فكرة التعريف بأهمية الموضوع ولفت الأنتباه لأهمية العوامل النفسية والأجتماعية التي يمكن أنْ تلعب دوراً في بلورتها. وكان الوردي بذلك بنى على أفكار عالمة الأنثروبولوجيا الأمريكية المعروفة، روث بيندكت. وفي أعماله الأخرى من أمثال, ‘خوارق اللاشعور’[7]، ‘وعاظ السلاطين’[8] وغيرها، إكتفى الوردي بالأشارة الى المصادر الرئيسة التي بنى عليها كما في ماكس فيبر وفكرة الفهم والمعنى والفهم الذاتي وروث بيندكت ومفهوم الشخصية القومية ووليام أوكبرن وفكرة التخلف الثقافي التي يصر الوردي على ترجمتها بـ ‘الأزدواج’. يتقدم الوردي مع ذلك على غيره في أنّه إهتم بصورة صادقة بالمجتمع العراقي وحاول فهمه وإفهام الآخرين به. وهذا ما جعل منه إستثناءاً للقاعدة.
كان علي الوردي أنثروبولوجي المنهج سوسيولوجي النظرية. فقد إعتمد الموروث الشعبي والأمثلة الدارجة والمقولات الشائعة لدعم فرضياته وقناعاته فيما يتعلق على سبيل المثال بشخصية الفرد العراقي وما أسماه طبيعة المجتمع العراقي والتوجهات النفسية والأجتماعية السائدة فيه. وأظهر نقداً واضحاً لطرق البحث العلمي الحديثة وفي مقدمتها المسح الأجتماعي بطريقة إستخدام إستمارة الأستبيان لأسباب ترتبط في جلّها بأمية المجتمع وعدم تعاونه مع الباحث العلمي وتكتمه وتمسكه بالقيم المحافظة التي تحول دون التوصل الى نتائج يمكن الوثوق بها. وكما سيتضح، فأنّ ميزة الوردي على من تبعه من علماء الأجتماع في العراق أنّه كان بحد ذاته شخصية ناجحة. على الرغم من أنّه تأخر في الألتحاق بالمدرسة بدايةً بسبب عدم إنتشار المدارس الأبتدائية والمتوسطة والأعدادية في زمانه إلا أنّه ما أنْ دخل المدرسة حتى تفوق فيها. وعندما توفرت له فرصة للدراسة في الولايات المتحدة في أربعينات القرن الماضي إستخدم الوقت إستخداماً ناجحاً وفعالاً فكان أنْ حصل على ماجستير في علم الأجتماع بطريقة (MA) أو ماجستير آداب وليس ماجستير علوم (MS) وهي الطريقة التي لا تتطلب رسالة نظرية معقدة وإنّما تكتفي بوضع عمل أشبه ما يكون بالتقرير أو بحث التخرج الجيد[9]. وهذا ما وفر له الوقت إذ لم يستغرق في هذا المجال أكثر مما كان محدداً وهو فترة السنة الواحدة. بدأ بعدها الوردي على الفور بأنجاز أطروحته المشار اليها من قبل وهو الذي يعرفها ويعرف موضوعها وقرأ فيها ولها كما يستدل على ذلك من خلال النظر في مصادره العربية وقراءاته الواسعة المهيئة من قبله مسبقاً في هذا المجال المحدد. بمعنى أنّه كان يعرف ما يريد مما أسهم بتسريع وصوله الى الهدف الرئيس في الحصول على شهادة الدكتوراه في فلسفة علم الأجتماع (Ph. D) ومن ثم عودته المباشرة الى العراق وإصراره على العمل فيه وتحمله الأستفزازات والتجاوزات من مختلف الفئات الأجتماعية وبخاصة المحافظة منها سواء على صعيد المجتمع أو على صعيد المؤسسة الدينية والأكاديمية وغيرها. العبرة أنّه كان صاحب رسالة تفانى في حملها. وعندما لم يلق من يدعمه مادياً ومعنوياً ليؤلف وينشر ما يؤلفه أنفق على ذلك من جيبه الخاص فكان يؤم مدن العرب الساطعة، بيروت أو القاهرة أو الأسكندرية وبخاصة في فترات العطلة الصيفية حيث تتوقف الدراسة في الجامعات العراقية ليتفرغ للكتابة ويجهز مؤلفاته ويعود الى العراق ليطبعها على نفقته الخاصة. مقابل الأستفزازات والتجاوزات من قبل البعض حظي الوردي بمحبة بالغة وأحترام طاغي من قبل فئات متنوعة من جمهور القراء في العراق ممن تلقوا أعماله بشغف ومحبة وإستمتاع فكان أنْ حملوه الى الآفاق الرحبة للشهرة والأحترام على المستوى العربي والدولي. بالتأكيد كان لغزارته في الكتابة وحضوره في أذهان القراء ودأبه ومثابرته دور مهم في دعم مكانته العلمية والثقافية الآخذة في التوسع، الأمر الذي لم يتمكن منه حتى اللحظة كل من أعقبه من التدريسيين والمتخصصين في مجال علم الأجتماع في العراق. توفي علي الوردي بعد صراع مع المرض صيف 1995 في داره بالأعظمية ببغداد.
لقد وضع الوردي سنّة في مجال الكتابة والبحث الأجتماعي نجحت في إستقطاب إهتمام نظرائه من الزملاء والتدريسيين بدليل أنّ كثيراً من هؤلاء وكما سنأتي على توضيحه أتبعوا طريقته أو كرسوا أعمالهم لمحاججته ونقده وأقتراح البدائل لأفكاره فلم يزد معظمهم على أنْ يكون صدى له، شئ لم يستطيعوا الفكاك منه. ومع أنّه لم يلق منهم المودة والأعتراف والتقدير الذي يستحقه بدليل شغبهم عليه حتى على مستوى الطلبة ممن كانوا ينقلون للوردي ما يسمعونه ويتفكهون به، إلا أنّه بالنهاية نجح فيما لم يتمكنوا من النجاح فيه. على سبيل المثال، دُرِسّت مادة علم النفس الأجتماعي التي قدمها ودرسها د. علي الوردي أولاً في قسم علم الأجتماع من قبل تدريسية شابة في حينهاJ[10] بعد أنْ أحال نفسه على التقاعد بطلبٍ منه عشية تعيينها تدريسية في القسم عام 1972، إلا أنّها لم تضف شيئاً يذكر بدليل عدم قيامها بتأليف أو نشر أي عمل في هذا المجال فضلاً عن إخفاقها في المحافظة على حيوية المادة في أذهان الطلبة فكان أنْ تغاضوا عنها ولم ينجحوا في تكريس أيٍ من النظريات أو التوجهات النظرية في ميدان علم النفس الأجتماعي على مستوى رسائلهم أو أطاريحهم أو أعمالهم المستقبلية.
ثانياً: عبد الجليل الطاهر
عاد د. عبد الجليل الطاهر الى العراق بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في مجال علم الأجتماع من جامعة شيكاغو عام 1952 عن أطروحته الموسومة، ‘الجاليات العربية في أمريكا’[11] وسرعان ما عمل مع الوردي على تأسيس قسم مستقل لعلم الأجتماع في كلية الآداب التي كانت قد تأسست قبل جامعة بغداد عام 1949. قدم الطاهر عدداً من الأعمال كان أولها مجموعة من التراجم كما في ‘العشائر والسياسة’[12]، ‘المزارع التعاونية الجماعية’[13]، ‘أصول فلسفة الطبقة الوسطى في عصر التنوير’[14]، و‘العشائر العراقية’[15]. ولديه أعمال أخرى حاول أنْ يعلن من خلالها إنتاجه العلمي وأولها كتابه الموسوم، ‘التفسير الأجتماعي للجريمة’[16]. ينطوي هذا الكتاب على محاولة لتحليل المشكلات الأجتماعية في بغداد والعراق وهي المحاولة التي إمتزجت بتقديم أفكار عدد من علماء الأجتماع الأمريكان ممن أهتموا بالجريمة وبخاصة أولئك الذين عملوا في الجامعة التي تخرج منها، جامعة شيكاغو. إستخدم الطاهر في هذا الكتاب طريقة الحكايات المنقولة التي عبر فيها عن التأسي على قيم الماضي في التماسك الأجتماعي حيث ذهبت بحسب تعبيره العائلة الممتدة أدراج الرياح وعمّ الفساد وضاعت العفة نتيجة الأختلاط بين الجنسين. إفترض الطاهر في هذا الكتاب أنّ المشكلات الأجتماعية في العراق لا تختلف عن تلك التي يعاني منها المجتمع الأمريكي بأستثناء “أنّهم” يملكون الأحصاءات الدقيقة لتقدير ما يمرون به فيما لا نملك ذلك في العراق. وفعل شيئاً مماثلاً في تناول نظرية الأنحراف لروبرت ميرتون التي قدمها في كتابه الموسوم، ‘المشكلات الأجتماعية في حضارة متبدلة’[17]. عرض الطاهر لنظرية ميرتون في الأنحراف على نحوٍ دقيق وبحسب الجدول الذي تضمن تسمية الأهداف المحددة ثقافياً وأنماط السلوكيات الأجتماعية المتوقعة والتي أوردها على ما هي عليه وبحسب ترجمته (التوافق؛ الأبداع؛ الطقوسية؛ الأنطوائية؛ الثوروية)، إلا أنّه إكتفى بالأشارة عند رأس العنوان الى أنّ “هذه النظرية تستفيد من ميرتون” حتى لكأنّ النظرية نظريته وأنّه لم يفعل أكثر من أنْ “يطلع” على ميرتون. وكذلك الحال في إستخدامه لأفكار من كتاب ‘الأنتحار’[18] لدوركهايم في معرض تناوله لموضوعة النظام الأجتماعي وأنماط التكيف، إذ يضع الطاهر هامشاً يقول فيه “إعتمد الكاتب في عرض هذا المفهوم على مقال الأستاذ دوركهايم[19]. بل وخلت قائمة المراجع الخاصة بالفصل من الأشارة الى إيٍ من ميرتون ودوركهايم. وكذلك هامشه في معرض الفصل السادس الموسوم، القوى الأجتماعية وسيكولوجية الجماهير، إذ يشير الهامش الى مراجعة نفس الكتب …[20] إنّما أي كتب!
ولعل أهم ما قدمه الطاهر كتابه الموسوم، ‘أصنام المجتمع: بحث في التحيز والتعصب والنفاق الأجتماعي’[21]. يقع الكتاب في (147) صفحة من القطع المتوسط وأنّ أهم ما ميز الكتاب أنّه خلا من تسجيل أي مصدر فيما وضعت قائمة بالمصادر في نهاية كل فصل دون أنْ تربط على نحوٍ دقيق ومحدد بما تمّ التطرق اليه في متن الكتاب. كان على القارئ – كما يبدو – أنْ يحدس لمن تعود هذه الفكرة أو تلك. أما الأنطباع الرئيس الآخر الذي يكوّنه القارئ ساعة تصفح كتاب ‘الأصنام’، أنّه صدى مباشر لكتاب ‘وعاظ السلاطين’[22]، الذي صدر قبله بعامين (1954) لعلي الوردي. يعترف الطاهر في هذا الكتاب أنّه مدين الى الفيلسوف الأنكليزي فرنسيس بيكون (1561- 1626) في إختيار العنوان والذي كان قد حذر فيه من وجود نوع من الآلهة الكاذبة. ويوضح الطاهر المعنى الذي تنطوي عليه فكرة الآلهة الكاذبة وهي بنظره ‘الأصنام’، التي تتركز حولها الأفكار المغلوطة المشوهة المحرفة التي يعتنقها الفرد بوعي أو بدون وعي عن الواقع الأجتماعي[23]. ويظهر تأثره بـ ‘وعاظ السلاطين’، بقوله: “أو يلتمس كاتب آخر السبب في ‘وعاظ السلاطين’، الذين ينشرون الأوهام والأباطيل للدفاع عن الوضع الراهن وحمايته وإلقاء المسؤولية على عاتق المجرمين”[24]. وعلى الضد من أسلوب الوردي الكيّس في الكتابة، يظهر الطاهر ميلاً تعبوياً متشدداً وصارماً، يفقده القدرة على جذب القارئ، بمثل ما يفعل الوردي كقوله: “إنّ البحث في أثر الأصنام بالمعرفة من أقدس واجبات المتعلم، فيجب عليه أنْ يتعقب أصول المزالق والمهاوي التي قد يقع في حضيضها، ليجتث جذور الأوهام حتى تسلم المعرفة من الشوائب والنقائص، ويتخلص الأنسان من كل أنواع التحيز والتعصب والتعرض، فيرى الحقيقة الواقعية ناصعة منعزلة من كل ما يلصق بها من أحكام ذاتية”[25]. يظهر للقارئ فيما بين السطور، أنّ الطاهر أستهدف في كتاب ‘الأصنام’، نقد القادة الدكتاتوريين من أمثال هتلر وموسوليني مؤكداً على أهمية الحرية والحق في إبداء الرأي كقوله: “لا يمكن أنْ يتكون صنم إجتماعي عن طريق حرية الرأي والتعبير والمناقشة والجدل والأقناع والأعتقاد وإنّما بأستعمال القوة والزجر والدعاية والتزكية والسلوك الرعاعي”[26].
يلاحظ القارئ أيضاً أنّ كتاب ‘الأصنام’، لا يتصف بوحدة الفكرة والمنهج إنّما هو وعاء لكثيرٍ من الأشياء. عموماً، فأنّه ينطوي على إظهار لمعرفة الكاتب بعدد من الكتاب والمنظرين والفلاسفة من أمثال نيتشة، باريتو، فرويد، فيبر، مانهايم، سوروكن وتوينبي. من جانبٍ آخر فأنّه يستخدم مقاربات دون الأشارة الى صانعيها كما في إستخدامه مقاربة إيميل دوركهايم لشرح الظاهرة الدينية إنطلاقاً من المجتمع البدائي الميكانيكي دون إفصاح. فهو يحاول أنْ يفسر في صفحات قليلة علامات التحيز والتعصب فيما أسماه “المجتمع البدائي” تماماً كما فعل دوركهايم في ‘الأشكال البدائية للحياة الدينية’[27]، إنّما دون تسمية. وخصص الطاهر الفصل السادس من ‘الأصنام’، لعرض فكرة كارل مانهايم في أثر المركز الأجتماعي على تطور أفكار الفرد والجماعة ثمّ ينتقده على عجل ليقدم فكرة بيتريم سوروكن في هذا المجال عن الثقافة الروحية والثقافة المادية. وفي الفصل الأخير الذي جاء بعنوان “مجتمع بدون أصنام”، يقدم الطاهر رأيه في أنّه لا يمكن لأي مجتمع أنْ يخلو من الأصنام بما في ذلك المجتمع اللاطبقي الذي لا ينجو بنظره من ذلك، إنّما الأمل الوحيد في الأبتعاد عن تأثير الأصنام والأوهام يكمن في البحث عن الحقائق لبلوغ الحرية – حرية التفكير والضمير والمناقشة وإبداء الرأي والتصويت[28]. وفي مكانٍ ما ودون سابق إنذار، يعبر الطاهر عن رفضه لأستخدام “الأحصاء… في معرفة آراء الناس في العدالة الأجتماعية، وفي التعصب العنصري والطائفي، وفي الديموقراطية”[29].
لم يقدم الطاهر في مقالته الموسومة، ‘علم إجتماع المسرح: بحث في الأشباح الجماعية’[30]، أكثر من تفسير وصفي بأسلوب إنشائي بدرجة كبيرة لدور المسرح في المجتمع. لعل الملفت للنظر أنّ المقالة برمتها خلتْ من أي مصدر بأستثناء (23) هامشاً كانت عبارة عن شروحات غير موثقة من قبل الكاتب لبعضٍ مما ورد من أسماء كتاب، فلاسفة أو سلاطين وما اليهم. على سبيل المثال، يشرح كلمة (تراجيديا) في هامش. أو يترك هامشاً آخر رقم (15) لتوضيح ما هو المقصود بمفردة إطار التفكير “الفيبري” ويقول “نسبةً الى العالم الأجتماعي الألماني الكبير، ماكس فيبر صاحب الأعمال الكثيرة التي ترجم العديد منها الى اللغة الأنكليزية”[31]، دون أنْ يعطي ولو مصدر واحد لفيبر بصورة دقيقة. يبدو لي أنّ هذه الطريقة تمتّ عن الرغبة في عدم تمكين الطالب من الأحاطة بالموضوع بصورة كافية وتساهم بتكريس فكرة إبقائه / إبقائها عبداً لمن يملك مفاتيح اللعبة (الأستاذ). وهذا أسلوب أتبع بدرجة كبيرة في قسم علم الأجتماع ولا يزال يتبع بحجة عدم تمكن الطلبة من العودة الى المصادر الأصلية التي كتبت باللغة الأنكليزية. ويمضي الطاهر في هذا العمل ليشرح ويقدم أفكاره بطريقة تعليمية تلقينية مباشرة موضحاً ومفسراً لبعض المفردات والأسماء وبالنهاية يسعى الى الوصول الى ما يشغل باله وهو توجيه النقد الحاد الى الأنظمة الأستبدادية والدكتاتورية. ولكنّه على الضد من علي الوردي الكيّس وغير المباشر لا يصل الى قلب القارئ وعقله. إنّه يكتب بطريقة تقليدية تقوم على مبدأ تكديس المعلومات ومراكمتها حتى لكأنّه المصدر الوحيد الذي لا يضاهى. وهذه بحد ذاتها مشكلة مورست وتمارس وقد تكون المسؤولة عن محدودية الأبتكار في الدراسات الأجتماعية حيث لا يشجع الطالب على التفكر والتأمل فيما يقرأون من جانب، أو تطوير نظرة نقدية لما يقرأون من جانبٍ آخر. ولنا أنْ نستشهد بالطريقة التي خرج فيها روبرت ميرتون على أستاذه تالكوت بارسونز لينتج نسخته هو للـ “وظيفية”. تلك هي إذن مسألة نمط ومنهج تعليمي يقوم على مبادئ مختلفة تشجع التفكير والمحاججة العلمية ولا تتطير من الأختلاف وعدم الأتفاق وبالتالي التميز. وكان ذلك ما أسماه د. علي الوردي “المنهج العلمي الحديث” الذي أكسبه المحبة والأحترام لأنه شارك الناس بأحدث ما تعلمه وتعلمه العالم المتقدم من قبل.
قد يفسر هرب الطاهر للعمل في ليبيا عشية مضايقات سياسية شرسة ضده في العراق وعودته التي لم يطل له بها المقام حيث توفي عام 1973 وهو بعد في بداية الخمسينات من العمر، قد يفسر هذا نزعة التأليه التي يحيطه بها طلابه ممن عرفوه إنساناً طيباً ومواطنأً فذاً لخدمة بلده ومجتمعه العراقي.
ثالثاً: حاتم الكعبي
إلتحق بعد عبد الجليل الطاهر عالم إجتماع عراقي آخر هو د. حاتم عبد الصاحب الكعبي الذي نال شهادة الدكتوراه في مجال علم الأجتماع من جامعة شيكاغو عام 1954 عن أطروحته الموسومة، ‘التحليل النفسي الأجتماعي للحركة القومية في العراق’[32]. وسرعان ما أستطاع الكعبي إثبات حضوره من خلال أعماله العلمية والتي إتسمت بمسحة علمية منهجية صارمة. كانت كتاباته دقيقة، سهلة وموثقة بدرجةٍ كبيرة بالمقارنة مع كتابات الطاهر. وكان من أوائل ما نشره الكعبي كتابه الموسوم، ‘في علم إجتماع الثورة’[33]. يقع الكتاب في (70) صفحة من القطع المتوسط ويتوزع ما بين تسعة فصول قصيرة وهي تعريف الثورة؛ أسباب الثورة؛ معالم الفترة التي تسبق الثورة؛ مراحل الحركة الثورية، قادة الحركة الثورية وأتباعها؛ دور المثقفين والمفكرين في الحركة الثورية؛ ما تتوخاه الحركة الثورية وما تتمخض عنه؛ أنواع الثورات وأخيراً، مقارنة الحركة الثورية بالحركة الأصلاحية. أقر الكعبي في معرض التقديم للكتاب أنّه كتبه أصلاً كمقالة أعدت للنشر في العدد الخاص بثورة 14 تموز عام 1958 في مجلة “المعلم الجديد”، إلا أنّ ذلك لم يحصل مما أدى به الى نشرها بنفسه بصيغة كتاب. يلاحظ أنّ الكعبي نحا في هذا الكتاب نحو من سبقه منهجياً وبخاصة عبد الجليل الطاهر في أنّه قدم أفكاراً وآراء لعدد من علماء علم الأجتماع البارزين في زمانه من أمثال بلومر، لنت، مانهايم، ديفس، ملر، بارك، سوريل، فيبر وصولاً الى لينين ومن قبله كارل ماركس[34]. ولا يصل الكتاب الى نتيجة معلومة ليترك إنطباعاً في أنّه جزء من مشروع ستتم العودة اليه فيما بعد. وهكذا فعل الكعبي في أعمال أخرى كما في قائمة الأعمال التي وعد بأنجازها ولم يفعل إذْ وافته المنية وهو بعد لمّا يبلغ الستين من العمر، عام 1971. وخلا كتابه الآخر الموسوم، ‘نمو الفكر الأجتماعي’[35]، الذي يقع في (100) صفحة من المصادر بل وحتى من جدول المحتويات. لقد كان هذا الكتاب مراجعة نظرية عامة شاملة ألحق في نهايتها عدداً من المصادر الأجنبية ذات الصلة بنمو الفكر الأجتماعي الغربي، حصراً.
وراجع الكعبي فكرة “المنقذ المنتظر”، في مقالته الموسومة، ‘من آثار الأتصال والأحتكاك الأجتماعي والحضاري: الحركات الأجتماعية التي تدور حول منقذ منتظر’[36]. وهنا أيضاً، كان كل ما فعله الكعبي أنّه قدم أفكار عدد من المنظرين الغربيين ومن أبرزهم لنتون، باير ولوي، مستخدماً طريقة دوركهايم بالتركيز على المجتمع البدائي على إفتراض أنّ هذا أسهل. وخلص الكعبي في هذا المجال الى فكرةٍ مفادها أنّ إنتشار الشعور بالأضطهاد يؤجج الحاجة الى دور ‘المنقذ’ الأجتماعي.
يمثل كتاب ‘حركات المودة’ للكعبي[37] الذي يقع في (248) صفحة المرحلة الأكثر نضجاً في أعماله. إلا أنّه في هذا الكتاب أيضاً نحا نحو من يضع كتاباً منهجياً مصمماً لتعريف الطالب بموضوعة المودة مما يتضح من خلال النظر الى محتويات الكتاب الرئيسة: 1. تعريف بالمودة؛ 2. نبذ مختصرة (العقل الجمعي، التقليد، الأيحاء، اللاعقلانية، نظرية التوتر …)؛ 3. تغير المودة؛ 4. المودة والبنية الأجتماعية؛ 5. حركات المودة. من جانبٍ آخر، خلا هذا الكتاب من ثبت المصادر على الرغم من إشارته بالمتن الى أسماء مهمة وذيل الكتاب بـ (18) مصدراً من الكتب الشائعة في هذا المجال. والظاهر أنّ الكعبي بلغ ذروة النضج الأكاديمي مقتبل السبعينات كما يتضح في آخر ما نشر له بعد وفاته في الكتاب الموسوم، ‘السلوك الجمعي’[38]. يقع الكتاب في (600) صفحة وكتب على غلافه، الجزء الأول إلا أنّ الجزء الثاني لم ير النور قط. بلغ عدد المصادر في هذا الكتاب (83) مصدرا ووضع الكتاب في ثلاث أبواب رئيسة هي: السلوك الجمعي من ملحظ تاريخي؛ طبيعة السلوك الجمعي ونشأته؛ التجمعات الجمعية البدائية. يذكر أنّ هذا الكتاب أستخدم ككتاب أساسي منهجي في مادة السلوك الجمعي على مستوى الدراسات الأولية والدراسات العليا منذ صدوره عام 1973 حتى اللحظة.
رابعاً: علماء الأجتماع والأنثروبولوجيا العراقيون في الستينات
عاد الى العراق مقتبل الستينات عالم الأنثروبولوجيا الشاب في حينها، د. قيس النوري بعد نيله شهادة الدكتوراه في مجال علم الأنثروبولوجيا من جامعة واشنطن، سياتل عن أطروحته الموسومة، ‘الصراع والمثابرة: الأستيعاب الثقافي للعراقيين الكلدان’[39]. وهذه دراسة أنثروبولوجية ميدانية لجماعات المهاجرين الكلدان الذين نزحوا من قرية في شمال العراق، الموصل وأقاموا في ديترويت. وفيها يطور النوري مقاربة جديدة تأملت في الصلة بين الأستيعاب الثقافي والأستمرارية العرقية على الضد مما كان شائعاً آنذاك في الأدبيات العلمية والتي كانت تهتم بمسألة الأستيعاب الثقافي وديناميكيات التغير لدى الجماعات المهاجرة الى الولايات المتحدة.
على الضد ممن سبقوه، وبخاصة الوردي والطاهر أظهر د. النوري من البداية إهتماماً بالنشر في دوريات علمية محكمة عربية ودولية. ووضع عدداً من الكتب المنهجية لعل من أبرزها كتابه الموسوم، ‘مدارس الأنثروبولوجيا’[40]. يقع الكتاب في (400) صفحة وكتب النوري في مقدمته التمهيدية “لقد آلمني طويلاً أنْ أرى مكتباتنا الجامعية والعامة وهي تفتقر الى كتاب بالعربية يتناول آفاق الأنثروبولوجيا وتياراتها الفكرية. وقد دفعني هذا الشعور الى الأقدام على هذه المحاولة …”[41]. يظهر الكتاب منهجياً بأمتياز وهو مصمم لطلبة الدراسات الأولية ويتناول التيارات والتوجهات الرئيسة بحسب الكاتب في مجال علم الأنثروبولوجيا. وفيه، إنتقل النوري من التعريف ببدايات الأنثروبولوجيا الى تقديم بعض المدارس المعروفة كالتطورية والأنتشارية ومدرسة الثقافة والشخصية والبنوية الفرنسية والمدرسة البريطانية الى جانب أفراد من العلماء والمنظرين الذين أسهموا في صعود علم الأنثروبولوجيا ومنهم بحسب الكاتب هربرت سبنسر، كروبر ولوي. لم يوثق الكتاب وإنّما ذيلت فصوله بسبعة الى ثمانية مصادر لكل واحدٍ منها وعددها (16) فصلاً. الملفت للنظر، أنّ النوري كتب لمجلات علمية عربية ودولية محكمة كما في مقالته الموسومة، ‘آفاق الديموقراطية والتركيب الثقافي العربي’[42]. أو ‘مشخصات الأغتراب الأكاديمي العربي’[43]. ومقالته ‘التوجهات النقدية فيما بين القبليين المتحضرين في الشرق الأوسط بالتركيز على العراق’[44] وغيرها. إلا أنّه لا يعبر عن كثيرٍ من الأهتمام بتوثيق وتنقية الكتب المنهجية التي ينشرها وبخاصة في العراق مما ساهم بتقديري في ترهل مستوى أداء طلبة الدراسات الأولية والعليا على حدٍ سواء وأدى الى تخرج أشخاص لا يظهرون حساسية لمثل هذا الجانب المهم في العمل العلمي. بالتأكيد، يمكننا والحالة هذه أنْ نتوقع مزيداً من الترهل بل والأخفاق في تحقيق التراكم العلمي اللازم لتحقيق خطوات متقدمة بالأتجاه الصحيح، أو في الأقل العمل على تحسين مستوى الأداء، ما لم يصار الى معالجة الأمر.
أشتهر عالم إجتماع عراقي معروف آخر هو د. متعب السامرائي بكتابين رئيسيين هما كتابه الموسوم، ‘ثورة على القيم’[45]، وكتاب ‘الواقع الفكري والمجتمع العربي الجديد: هل يستطيع العرب فهم ماضيهم وتقييم حاضرهم والأنطلاق نحو مستقبلٍ أفضل’[46]. يلاحظ على نحوٍ ممتع أنّ د. السامرائي أظهر حساً مرهفاً بالجندر منذ ذلك الحين إذْ تقرأ أنّه يضع جهداً ليذكّر بحضور المرأة كقوله التلميذ والتلميذة، المعلم والمعلمة، علماً بأنّه تحمل كثيراً من النقد والتقريع على مستوى العامة بشأن مواقفه من المرأة التي قُرِئت كما لو أنّها معادية لها. وكان كتاب ‘الواقع الفكري والمجتمع العربي الجديد’ أقرب الى الرسالة السياسية التعبوية بأتجاه تدعيم الفكر القومي العربي ضد الفكر الأوربي الحديث منه الى التحليل السوسيولوجي للقوى الأجتماعية المؤثرة في المجتمع. وفي هذين الكتابين أيضاً لم يظهر السامرائي مثل من سبقه من زملاء المهنة والأختصاص إهتماماً يذكر بالمصادر وتسجيلها والتحقق منها الأمر الذي وجد صداه على الفور في عشرات الرسائل والأطاريح لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه في مجالي علم الأجتماع والأنثروبولوجيا التي أجيزت في قسم علم الأجتماع في كلية الآداب، جامعة بغداد ومنها حملت الى الأقسام المستحدثة لعلم الأجتماع في عدد من الجامعات العراقية كجامعة الموصل، القادسية، بابل، واسط والأنبار ومنذ العام الماضي جامعة تكريت في محافظة صلاح الدين.
خطفت السياسة والعمل في المؤسسات الحكومية أحد ألمع الحاصلين على شهادة دكتوراه فلسفة في مجال علم الأجتماع من جامعة ميريلاند الأمريكية عام 1960 وقبلها شهادة ماجستير آداب في علم الأجرام من جامعة بيركلي / كاليفورنيا الأمريكية عام 1958. فقد إنشغل د. محمد المشاط بالوظائف الرسمية إبتداءاً من مدير بعثات ثم وكيل وزارة المعارف عام 1963 وتدرجه في المسؤولية حتى عمله سفيراً للعراق في عدد من البلدان الأوربية وأخيراً سفير جمهورية العراق لدى الولايات المتحدة الأمريكية للفترة من 1989 – 1991[47]. كان من الطبيعي والحالة هذه أنْ لا تتوفر للدكتور المشاط فرصة للأنتاج العلمي المميز والمستقل بأستثناء مشاركته في تأليف كتاب بعنوان، ‘مبادئ علم الأجتماع’، مع د. حاتم الكعبي[48].
وبرز في هذه الفترة أيضاً د. شاكر مصطفى سليم كأحد أكثر علماء الأنثروبولوجيا تميزاً من حيث مستوى الأداء على صعيد المحاضرة المنهجية المنظمة والعمل المكتوب الموثق على نحوٍ إستثنائي بالمقارنة مع من سبقه من الزملاء والأقران. نال د. سليم شهادة الدكتوراه من جامعة لندن عن أطروحته الموسومة، ‘سكان الفرات لدلتا الفرات’، عام 1955 والتي نشرت من قبل مطابع الجامعة عام 1962[49]. وساعدت جامعة بغداد على نشر الأطروحة باللغة العربية والتي أخذت عنواناً آخر، ‘الجبايش: دراسة أنثروبولوجية لقرية في أهوار العراق’[50]، عام 1970. وضع د. سليم بعض الأعمال المترجمة المتميزة وفي مقدمتها كتاب كلايد كلوكهون الموسوم، ‘الأنسان في المرآة: علاقة الأنثروبولوجي بالحياة المعاصرة’، والذي نشر بالمشاركة مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر[51]. كما ترجم الكتاب الموسوم، مقدمة في الأنثروبولوجيا الأجتماعية’[52]، مذيلاً الترجمة بالشروحات اللازمة والمستمدة بالأساس من كتابه اللاحق، ‘قاموس الأنثروبولوجيا’. ولعل أهم ما نشره د. سليم قاموسه الشهير الموسوم، ‘قاموس الأنثروبولوجيا’[53]، الذي يقع في (1060) صفحة وضم أكثر من (5055) مصطلح دققت حسب أفضل المراجع العلمية المتوفرة في هذا المجال منها (683) تعريف بالقبائل البدائية و(155) تعريف وتقديم لعلماء أنثروبولوجيا، أثنولوجيا وأثنوغرافيا متميزين. وساعدت جامعة الكويت على طبعه عام 1981 بعد أنْ قضى في العمل عليه ما يزيد على الأربع سنوات. توفي شاكر مصطفى سليم عن عمر ناهز السادسة والستين وهو في عز عطائه العلمي والفكري ليلتحق بزميليه الطاهر والكعبي ممن توفيا مبكرا كما أراد الله لهما أنْ يفعلا.
خامساً: الجيل الوسيط من علماء الأجتماع والأنثروبولوجيا في العراق
ظهر في السبعينات من القرن الماضي ما يمكن أنْ يسمى “الجيل الوسيط” من علماء الأجتماع والأنثروبولوجيا المحدثين في العراق. وكان من أبرز أولئك الأكاديميين د. عادل شكارة، د. عبد المنعم الحسني، د. يونس حمادي التكريتي، د. قحطان سليمان الناصري ود. إحسان محمد الحسن. بأستثناء الأخير ساهم العلماء الأربعة الأوائل بعدد من الكتب المنهجية المهمة والتي رأت النور مطلع الثمانينات والتسعينات. مثلّ طبع الكتب المنهجية ظاهرة جديدة في القسم إذ قضت أجيال من الطلبة قبل ذلك التاريخ لما يقدر بثلاثين الى أربعين عاماً منذ تأسيس القسم فترات الدراسة دون كتب منهجية محددة يمكنهم العودة اليها. وبقي أولئك الطلبة حتى ثمانينات القرن المنصرم بأستثناء أعمال د. حاتم الكعبي تحت رحمة المحاضر أو الأستاذ للسنوات الأربعة التي قضوها في الكلية.
إشترك د. عادل شكارة ود. عبد المنعم الحسني في وضع كتاب ‘التخطيط الأجتماعي’[54]. كتب الكتاب بطريقة تعليمية مباشرة وضم عشرة فصول بدأت بتقديم أنواع التخطيط، مستوياته، أسس التخطيط ومبادئه، مراحل التخطيط، التخطيط في النظام الرأسمالي والأشتراكي، التخطيط للتنمية في الدول النامية، التخطيط للتنمية الأقتصادية والأجتماعية في العالم العربي وأخيراً التخطيط للتنمية الأجتماعية والأقتصادية في العراق. يقع الكتاب في (341) صفحة. كما في الكتب المنهجية المشار اليها أعلاه إعتمد الكاتبان على أفكار وإسهامات علماء الأجتماع الغربيين من أمثال مانهايم وخلا الكتاب في الوقت نفسه من التوثيق الجيد للمصادر.
وظهر في هذه الفترة أيضاً د. يونس حمادي التكريتي الذي وضع أحد أضبط الكتب المنهجية في مجال علم السكان معتمداً على أحدث المراجع العلمية في هذا المجال[55]. الى جانب هذا الكتاب وكما أطلعني هو شخصياً فقد أُشغِلَ التكريتي وأنشغل بعددٍ لا حصر له من ورش العمل والمؤتمرات والدورات والندوات العلمية التي كانت وزارة التخطيط العراقية خلال السبعينات تدعو اليها وتحتم عليه كأستاذ جامعي ومختص أنْ يحضرها ويشارك فيها خاصةً وأنّه كلف للعمل كمستشار في شؤون السكان بالوزارة آنذاك. وكان هذا كما يتضح أحد أهم الأسباب التي حالت دون أنْ يترك مزيداً من الأعمال ذات الصلة في هذا الميدان المهم، علم السكان أو الديمغرافية، كما كان يحلو له أنْ يسميه. تضمن الكتاب ثلاثة عشر فصلاً غطت القضايا الجوهرية في مجال علم السكان كما في بيانات ومصادر البحث الديمغرافي؛ النظريات السكانية؛ نمو السكان؛ الخصوبة والولادات؛ الوفيات؛ الهجرة؛ توزيع السكان والتحضر؛ تركيب السكان؛ القوى العاملة، الخصائص الأجتماعية والأقتصادية؛ السكان والعائلة والسياسات السكانية. بسبب مواقفه العلمية المتشددة أحيل د. يونس حمادي التكريتي على التقاعد في تسعينات القرن الماضي وهو يقيم اليوم – حسب علمي – في الولايات المتحدة الأمريكية ليقضي بقية حياته محدقاً في العراق وقسم الأجتماع الذي ساهم في بنائه في كلية الآداب، جامعة بغداد من على بُعْد.
في هذه الفترة أيضاً عاد الى العراق د. قحطان سليمان الناصري بعد نيله شهادة الدكتوراه من جامعة درهام البريطانية عام 1978 في علم الأنثروبولوجيا عن أطروحته الموسومة، ‘الأقطاع، الأفخاذ والأصلاح الزراعي في قرية عراقية’[56]. لولا أنّه هو أيضاً وقع ضحية الوظيفة الحكومية والمسؤوليات الأدارية والسياسية الملحقة بها كما حدث مع زميله السابق د. محمد المشاط، كان يمكن لـ د. الناصري أنْ يسجل إضافة مهمة في مجال دراسة المجتمعات المحلية وما أكثرها في العراق، إلا أنّه لم يفعل ليس لشئ إنّما لعدم توفر الوقت والمجال اللازم. فقد عمل الناصري لما يقرب من خمسة وعشرين عاماً عميداً لكليتي التربية والآداب في جامعة البصرة على التوالي، كانت كافية لتجهض إمكاناته العلمية وتصرفه بأتجاهات أخرى. وعندما عاد من البصرة الى بغداد عمل عميداً لكلية التربية للبنات في جامعة بغداد وأخيراً عميداً لكلية الآداب في جامعة بغداد حتى إحالته على التقاعد قسراً في أعقاب حرب 2003. وبذلك خسر القسم والكلية علماً من أعلامه المرفرفة وبخاصة في ضوء تقاعد ووفاة العدد القليل من علماء الأنثروبولوجيا في العراق قبل ذلك التاريخ وبعده. وضع الناصري عدداً محدوداً من البحوث والدراسات المنشورة وغير المنشورة وبمشاركة آخرين أحياناً، إلا أنّه بالمحصلة بقي خزيناً علمياً شخصياً يجلس في داره اليوم يصارع المرض وإنعدام الراحة، في أقل تقدير.
برز في هذه الفترة أيضاً د. إحسان محمد الحسن الذي هيمن بنشاطه ومطبوعاته التي زادت على السبعين كتاباً خلال عشرين عاماً حتى بداية التسعينات من القرن الماضي عندما بدأ نجمه بالأفول بسبب إكتشاف نزعة التكرار والعمومية والكمية في أعماله، إضافة الى عوامل أخرى تتعلق بشخصيته وميله الى التبسيط والأيجاز والتساهل. أثبت د. الحسن حتى خروجه القسري من القسم حوالي 2005 نتيجة مضايقات وضغوط طلابية وإنتشار شائعات غير مؤكدة بمقتله على يد جماعات إرهابية مسلحة أنّه الأكثر إنتاجاً وأنّه يفوق في الكم الذي نجح في طباعته ونشره ما فعله الوردي – مع الفارق في التشبيه -. إذْ لم يترك الحسن ميداناً من ميادين علم الأجتماع إلا وطرقه مدعياً بلا تردد أنّه يتضلع فيه سواء كان في ميدان علم الأجتماع الصناعي أو علم إجتماع العائلة أو علم الأجتماع السياسي أو الحضري والديني وما اليها بل وحتى في ميدان علم الأجتماع العسكري وعلم إجتماع الممارسات الرياضية. ولم يغفل الحسن مسألة الترجمة فكان أنْ وضع عدداً من الأعمال المترجمة بمفرده أو بالتعاون مع آخرين. من هذه التراجم، ‘معجم علم الأجتماع’[57]، و‘إتجاهات جديدة في علم الأجتماع’[58]، وغيرها.
إلا أنّ العمل الذي ميّز د. الحسن – بتقديري -، إنّما هو كتابه الموسوم، ‘الأنبياء عراقيون’[59]، مما يؤهله لمراجعة موجزة هنا. تجاوز الحسن في هذا الكتاب زملائه من علماء علم الأجتماع في العراق ممن أتينا على ذكرهم وإعطاء خلاصات موجزة عن أبرز أعمالهم ونشاطاتهم الأكاديمية. ففي معرض تقديمه لفحوى الكتاب يقدم الحسن أفكار عدد من علماء الأجتماع الغربيين ويدعم ذلك بتقديم كتبه كمراجع أساسية إضافة الى إستخدام مصادر حكومية حزبية لا تمتّ الى العلم بصلة من حيث أنّها كتبت من وجهة نظر آيديولوجية منحازة في الغالب. يصف الحسن الكتاب بقوله: “يُعدّ هذا الكتاب الأول من نوعه باللغة العربية بل وحتى في اللغات الأخرى الشرقية ومنها والغربية”[60]. ويضيف أنّ هذا الكتاب يمثل حقلاً جديداً في مجال علم الأجتماع يقوم من حيث الأساس على فكرة أنّ “أنبياء الله سبحانه وتعالى هم عراقيون إما بالولادة أو بأنحدار النسب …”. ويبرر الكاتب إختيار العراق مهبطاً للرسل والأنبياء وهي بنظره: 1. أنّ العراق موطن أولى الحضارات البشرية؛ 2. أخلاق العراقيين الفاضلة؛ 3. أنّ العراقيين يكرهون كل ما يتسم بالصفات السلبية كالكذب والرياء والخيانة والغدر”[61]. ويختتم الحسن ‘أطروحته’ بالقول “لم يكن العراق مهبط الرسالات السماوية وموطن الأنبياء والرسل والصالحين بل كان أيضاً مبعث القادة والعظماء والأبطال عبر التاريخ كحمورابي ونبوخذنصر وأبو جعفر المنصور وهارون الرشيد وصلاح الدين الأيوبي وصدام حسين[62].
اليوم، يبرز ثلاثة من علماء الأجتماع المحدثين في العراق ممن تتلمذوا على أيادي معظم من مرّ ذكرهم وهؤلاء حسب التسلسل الزمني لتخرجهم وحصولهم على شهادات الماجستير والدكتوراه في مجال علم الأجتماع: د. كريم محمد حمزة؛ د. ناهدة عبد الكريم؛ د. عدنان ياسين مصطفى. زخر الباحث الشاب في حينها د. كريم محمد حمزة بأمكانات وطاقات ممتازة على صعيد العمل الميداني السوسيولوجي المتقد حماساً وحيوية وبخاصة في صفوف الفئات الأجتماعية المهمشة كالبغايا والمتسولين. وكان حصل على شهادة الماجستير في مجال علم الأجتماع من قسم الأجتماع، كلية الآداب، جامعة بغداد عن دراسته الموسومة، ‘البغاء السري في بغداد: دراسة ميدانية’[63] عام 1974. وكانت الدراسة دراسة إستطلاعية بأمتياز تضمنت إستكشاف المهنة قبل البغاء، مبررات الممارسة، شبكة العلاقات الأجتماعية، الدخل والأنفاق، أماكن الأقامة والممارسة وما اليها. وضع حمزة عددا من الأعمال البحثية خاصةً وأنّه عمل باحثاً علمياً في المركز القومي للبحوث الجنائية لعدد من السنوات. كما حاول تطوير منهجيات البحث العلمي حيث نشر مقالته المعروفة في تحليل المضمون[64] وقام بدراسات تقويمية عديدة لدور الرعاية الأجتماعية والطفولة وما اليها. إلا أنّ وقوعه في الأسر الأيراني عشية مشاركته في الحرب العراقية الأيرانية كجزء من الخدمة الألزامية (1982 – 1990) كان كافياً لتحجيم إمكاناته وأولها الحيلولة دون إتمام دراسته العليا لنيل شهادة الدكتوراه في مجال علم الأجتماع التي لم تحصل له حتى صيف 1995.
حصلت د. ناهدة عبد الكريم على شهادة الماجستير عام 1975 عن رسالتها الموسومة، ‘دراسة حالة الرعب الجمعي في مدينة بغداد’[65]، وأشرف عليها د. حاتم الكعبي. كتبت د. عبد الكريم في مجالاتٍ عديدة جداً وبخاصة في مجال المنهج وطرق البحث العلمي. ونشرت في عدد متنوع من المجلات العلمية العراقية المحكمة وقامت بتدريس مادة طرق بحث وتصميم بحوث وكتبت عن المرأة والتنمية المستدامة والطفولة والشباب والرعاية الأجتماعية والمسنين وما اليها. حصلت على شهادتها للدكتوراه عام 2000 عن أطروحتها الموسومة، ‘ثورة العشرين: الأسباب والآثار الأجتماعية’[66].
عاد د. عدنان ياسين مصطفى الى العراق عام 1990 بعد نيله شهادة الدكتوراه في مجال علم إجتماع التنمية من جامعة هل البريطانية عن أطروحته الموسومة، ‘النساء والتنمية في سياق حضري: دراسة للنساء المهاجرات في مدينة الموصل’[67]. إهتم د. مصطفى بمشكلات المجتمع الحضري والسلوك المنحرف وظهور المجتمع المدني إضافة الى قيامه بمراجعة تراجم بعض الكتب وبخاصة تلك التي صدرت عن بيت الحكمة الى جانب عمله كتدريسي في كلية التربية للبنات، جامعة بغداد.
عموماً، فأنّ القاسم المشترك بين هؤلاء العلماء المحدثين الثلاثة هو أنّهم أُشغِلوا وأنشغلوا بالمشاركة بعشرات الندوات والمؤتمرات وورش العمل العلمية والتدريبية على الصعيدين المحلي والعربي مما حال – كما يبدو – دون التفرغ لأعمال كبيرة ومؤثرة، أو في الأقل متابعة ما تمّ البدء به في مرحلة البداية. بقيت على سبيل المثال، دراسة د. كريم محمد حمزة في ‘البغاء السري’، يتيمة دون أنْ تلحق بدراسة أخرى تستطلع التغيرات التي أصابتها أو تطويرها بأتجاه تحليلي يأخذ بالأعتبار جوانب لم تدرس بعد!
الخاتمة: كلمة بشأن المستقبل
كما يتضح مما سبق، فقد تمّ التركيز على دور الأشخاص والأفراد ممن نالوا شهاداتهم العلمية في مجال علم الأجتماع في الغالب من جامعات أجنبية مرموقة، إلا أنّنا لم نقل شيئاً عن أقسام علم الأجتماع كتنظيمات مؤسساتية يفترض أنْ تكون قادرة على وضع أسس وقواعد عمل تحمي المستفيدين من طلبة وتدريسيين من مغبة الأبتعاد عما هو ضروري لتطور العلم ووظيفته في الحياة العامة للمجتمع. وكان للسياسة المركزية الصارمة المتبعة في العراق لعقود من الزمن أنْ صنعت أقساماً متطابقة الى حد الرتابة على الرغم من الأختلافات الثقافية والأجتماعية النسبية للجامعات التي تقوم فيها هذه الأقسام بقدر ما يتعلق الأمر بالمحافظات التي تأسست فيها. فكان أنْ درست مواد علمية مماثلة كما في مواد المداخل في مجال علم الأجتماع، علم النفس، الفلسفة، الخدمة الأجتماعية، الأنثروبولوجيا، مصطلحات ونصوص باللغة الأنكليزية، الحاسوب وحقوق الأنسان على مستوى المرحلة الأولى للدراسات الأولية. ودرست مواد المشكلات، علم الأجتماع الريفي، علم الأجتماع التربوي، علم الأجتماع الأقتصادي، الأنثروبولوجيا الأجتماعية، علم النفس الأجتماعي وطرق البحث على مستوى المرحلة الثانية وهكذا وصولاً الى المرحلتين الثالثة والرابعة. وحدث أنْ شذّت بعض الأقسام وبخاصة في أقليم كردستان العراق مؤخراً عن هذا التطابق كما في قسم علم الأجتماع في كلية العلوم الأنسانية في جامعة السليمانية وهي أحد أبرز جامعات الأقليم. إذ قدمت مادة جديدة حملت عنوان (جندر وعنف) الى جانب مادة علمية أخرى تدرس في كل الأقسام العلمية على مستوى الجامعة وهي مادة (جدل علمي) لتشجيع الطلبة على تطوير مهاراتهم الجدالية وإكسابهم الشجاعة الأدبية للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وقناعاتهم[68]. وأدخلت مادة جديدة غير مطروقة في قسم علم الأجتماع في كلية الآداب، جامعة صلاح الدين في أربيل عاصمة الأقليم بعنوان (كردولوجي) بهدف تعريف الطالب الكردي بنشأة اللغة الكردية وتطورها الى جانب الأهتمام بخصوصية المجتمع الكردي وحاجاته[69]. وهذه مبادرات تستحق التقدير بنظري لكونها تبحث عن التميز الذي يفترض أنْ يطبع كل الأقسام بحسب حاجاتها وتطلعاتها المجتمعية والثقافية.
لعل مستقبل علم الأجتماع في العراق سيبقى رهين التلكؤ والمراوحة في أحسن الأحوال إذا لم يصار الى الأعتراف بأخطاء الماضي والأبتعاد عن تأليه الأشخاص وفي مقدمتهم علماء الأجتماع الرواد ممن تجاهل بعضهم أو ربّما تقصد الأمتناع عن تسليم مفاتيح اللعبة للطلبة من خلال تقديم أعمال ترتقي الى مستوى الأعمال العلمية الرصينة التي مارسوها في كتابة أطاريحهم ولا بدّ أنّهم عانوا من عدم الألتزام أو التفريط بها. لا ريب والحالة هذه أنْ نجد طلبة اليوم يقفون حيارى أمام الأنتقادات التي توجه لهم في مناقشة رسائلهم وأطاريحهم لأنّهم كانوا ثمرة إعداد وتأهيل لم يألوا جهداً في إستيعابه إنّما تكمن الأشكالية في نوعية ما تلقوه ووجهوا اليه وليس في إهمالهم وعدم إكتراثهم كما يبدو على السطح. وهذه – بنظري – إحدى أهم الأسباب التي تحول دون أنْ يتمكن الطالب والتدريسي العراقي من تحقيق حضور قوي ومستدام على مستوى الكتابة في المجلات العلمية خارج العراق. لا يكفي والحالة هذه أنْ تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم المحفزات والمكافآت المادية للتشجيع على المشاركة عربياً ودولياً كما تفعل بسخاء منذ أكثر من عام لأنّ المشكلة أعمق مما يعتقد وبخاصة على مستوى الدراسات الأجتماعية والأنسانية على وجه العموم بالمقارنة مع ما يجري على مستوى الدراسات العلمية والتطبيقية الأخرى. وإذا كان يمكن تبرير الماضي وما حدث فيه من فشل وإخفاق في إرساء قواعد العمل العلمي السليم بسبب حداثة العلم وضغط العمل وما اليه فأنّ أختصاصيي اليوم المطلعون على ما هو صحيح ممن يعلمون علم اليقين الطريق الى الحقيقة يتحملون مسؤولية علمية وأدبية لتصحيح المسار وبالطريقة التي تحدث نقلة جادة على مستوى الحضور العلمي على المستوى العربي والدولي بأعتباره المقياس والبرهان الذي لا يرقى الشك إليه. إلى جانب هذه القضايا الفنية التقنية ذات العلاقة بالمنهج وطرق التسويق والتقديم المناسبة فأنّ المتخصصين الحاليين مطالبين بتوجيه الأهتمام لعدد من القضايا الجوهرية على مستوى النظرية التي يمكن أنْ تقدم بصيغة أسئلة. ما هو الموقف من قضية ‘الثقافة’ و‘البنية الأجتماعية’! الى أي درجة يتطلب إيلاء الأهتمام بما يسمى ‘الصيرورة’، على الضد من ‘الثبات والسكون’، في وقتٍ يمور فيه المجتمع بشتى الغليانات على صعيد العرق والقومية والجندر والمنطقة والدين والمذهب والسياسة وما اليها. كيف تتجلى حكمة الزمان والمكان في مجتمع اليوم! كيف تسجل ‘المحلية’ حضورها في وجه جريان ‘العولمة’ الجارف لكل ما يصادفه! كيف يؤثر التقدم المهول في أجهزة الأتصال الحديثة على سلوك جماعات واسعة من السكان ممن يتعلمونها اليوم كما تعلموا من قبل قيادة السيارة بالخبرة والممارسة وليس بالقراءة والتعلم وتفهم النظام القيمي والأدبي المرافق لها وما الأشكالات التي تترتب على هذا النوع من التعلم والتلقي! كيف السبيل الى الخروج من البحث في إعتقادات الناس وتصوراتهم الى البحث عن الحقيقة بطرق جديدة ومبتكرة من حيث أنّ ما يقولونه شئ وما يفعلونه حقيقةً شيئاً آخر! كيف تفسر المطالبات بالتدخل الأجنبي العسكري من قبل الجيل الذي نشأ على مقاومة الأستعمار والتحرر الوطني والقومي! هذه وغيرها من الأسئلة يمكن أنْ تساعد على تطوير وجهات نظر يجاب عليها من خلال البحث العلمي الميداني وصولاً الى مستوى إنتاج الدليل وليس فقط البحث عما يدعم الأفتراض والتصور العام الشائع والمسلم به. حتى نبلغ ذلك، فأنّ أمامنا الكثير مما يتحتم علينا عمله.
*) كلية الآداب، جامعة بغداد
العنوان الألكتروني للكاتبة lahay2010dami@yahoo.com
الهوامش
[2] لم تفتتح أي جامعة أهلية خاصة – حسب علمي – قسماً لعلم الأجتماع فيها.
[3] حنتوش، د. خالد ساجت، النتاج البحثي في القسم الأم لعلم الأجتماع في العراق: دراسة تحليلية – إحصائية لما أنتج في الدراسات العليا (1972 – 2011) (بحث مقبول للنشر في بيت الحكمة)، بغداد، 2013
[4] Wardi, Ali Husayn, A Sociological Analysis of Ibn Khaldun’s Theory: A Study in the Sociology of Knowledge, University of Texas (Unpublished Dissertation), 1950
[5] النقيب، د. مرتضى حسن، على الوردي والتحديث في المجتمع العراقي (بغداد: كلية الآداب، جامعة بغداد، 2013) (بحث غير منشور)
[6] الوردي، علي حسين، شخصية الفرد العراقي (بغداد: مطبعة الرابطة، 1951)
[7] ——————-، خوارق اللاشعور أو أسرار الشخصية الناجحة (مستنسخ) (بغداد: بلا مطبعة، 1952)
[8] ——————-، وعاظ السلاطين (مستنسخ) (بغداد: بلا مطبعة، 1954)
[9] Wardi, Ali Hussain, A Study in the Sociology of Islam, University of Texas, (Unpublished Research), 1948
[10] فوزية العطية تدريسية أحيلت على التقاعد عام 2012 لبلوغها السبعين من العمر
[11] Al- Qazzaz, Ayad, Sociology in Underdeveloped Countries: A Case Study of Iraq, The Sociological Review, Vol. 20, No. 1, 1972
[12] الطاهر، د. عبد الجليل (ترجمة) العشائر والسياسة (بغداد: مطبعة الزهراء، 1958)
[13] —————————-، المزارع التعاونية الجماعية (بغداد: مطبعة العاني، 1960)
[14] —————————-، أصول الطبقة الوسطى في عصر التنوير’، (بغداد: مطبعة الرابطة، 1960)
[15] —————————-، العشائر العراقية (بيروت: مطابع دار لبنان، 1972)
[16] —————————-،التفسير الأجتماعي للجريمة (بغداد: مطبعة الرابطة، 1954)
[17] ————————— المشكلات الأجتماعية في حضارة متبدلة (بغداد: دار المعرفة، ص 195، 1953)
[18] Durkheim, Emile, Suicide: A Study in Sociology (Translated by John A. Spauling & George Simpson)(New York: A Free Press, 1951)
[19] مصدر سابق، الطاهر، المشكلات الأجتماعية في حضارة متبدلة، ص 203، 1953
[20] ———————————————————–، ص 247، 1953
[21] الطاهر، د. عبد الجليل، أصنام المجتمع: بحث في التحيز والتعصب والنفاق الأجتماعي (بغداد: مطبعة الرابطة، 1956)
[22] الوردي، د. علي، وعاظ السلاطين (مستنسخ) (بغداد: بلا مطبعة، 1954)
[23] مصدر سابق، الطاهر، أصنام المجتمع، ص 3
[24] ———————————–، ص 4
[25] ———————————–، ص 6
[26] ———————————–، ص 39
[27] Durkheim, Emile, The Elementary Forms of Religious Life (Translated from the French by Joseph Ward Swain) (London: The Free Press, 1915)
[28] مصدر سابق، الطاهر، أصنام المجتمع، ص 132
[29] ———————————–، ص 133
[30] الطاهر، د. عبد الجليل، علم إجتماع المسرح: بحث في الأشباح الجماعية، مجلة الآداب، العدد 12، ص 65 – 110
[31] ——————————————————————————————، ص 81
[32] Al- Qazzaz, Ibid, 1972
[33] الكعبي، د. حاتم عبد الصاحب، في علم إجتماع الثورة (بغداد: مطبعة الزهراء، 1959)
[34] ——————-، في علم إجتماع الثورة، ص 30، 1959
[35] ——————-، نمو الفكر الأجتماعي (بغداد: المكتبة العصرية، 1964)
[36] ——————-، من آثار الأتصال والأحتكاك الأجتماعي والحضاري: الحركات الأجتماعية التي تدور حول منقذ منتظر، ص 200 – 217، مجلة الأستاذ، المجلد الثالث عشر بعدديه الأول والثاني، مطبعة الحكومة، بغداد، 1965 – 1966
[37] ——————-، حركات المودة (الديوانية: مطبعة الديوانية الحديثة، 1971)
[38] ——————-، السلوك الجمعي (الجزء الأول) (الديوانية: مطبعة الديوانية الحديثة، 1973)
[39] Qais, Alnouri, Conflict & Persistance: The Iraqi Chaldean Acculturation, University of Washington, Seattle, 1964 (Unpublished Dissertation)
[40] النوري، د. قيس نعمة، مدارس الأنثروبولوجيا (بغداد: دار الحكمة للطباعة والنشر، 1991)
[41] ——————————————، ص 14
[42] ———————، آفاق الديموقراطية والتركيب الثقافي العربي، ص 38 – 49، مجلة الفكر العربي، العدد 85 – 86، 1996
[43] ———————، مشخصات الأغتراب الأكاديمي العربي، ص 64 – 75، دراسات عربية، العدد 1- 2، 1996
[44] Al Nouri, Qais N., Pecuniary Trends Among the Urbanizing Tribals in the Middle East Focusing on Iraq, pp. 75 – 90, International Journal of Contemporary Sociology, Vol. 35, No. 1, April 1998
[45] السامرائي، متعب مناف، ثورة على القيم (بغداد: بلا مطبعة، 1965)
[46] ———————-، الواقع الفكري والمجتمع العربي الجديد: هل يستطيع العرب فهم ماضيهم وتقييم حاضرهم والأنطلاق نحو مستقبلٍ أفضل (بغداد: مطبعة العامل، 1966)
[47] المشاط، محمد، كنت سفيراً للعراق في واشنطن: حكايتي مع صدام في غزو الكويت (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2008)
[48] ————————————————————————————————————–، ص 17
[49] Salim, S. M., Marsh Dwellers of the Euphrates Delta (Monographs on Social Anthropology, No. 23) (London: The Althone Press, University of London, 1962)
[50] سليم، شاكر مصطفى، الجبايش: دراسة أنثروبولوجية لقرية في أهوار العراق (الطبعة الثانية) (بغداد: مطبعة العاني، 1970)
[51] كلوكهون، كلايد، الأنسان في المرآة: علاقة الأنثروبولوجي بالحياة المعاصرة (ترجمه وعلق عليه د. شاكر مصطفى سليم) (بغداد: المكتبة الأهلية، 1964)
[52] مير، لويس، مقدمة في الأنثروبولوجيا الأجتماعية (ترجمة وشرح شاكر مصطفى سليم) (بغداد: دار الشؤون الثقافية، 1983)
[53] سليم، د. شاكر مصطفى، قاموس الأنثروبولوجيا (أنكليزي – عربي) (الكويت: جامعة الكويت، 1981)
[54] شكارة، د. عادل ود. عبد المنعم الحسني، التخطيط الأجتماعي (بغداد: دار الحكمة للطباعة والنشر، 1992)
[55] التكريتي، د. يونس حمادي، مبادئ علم الديمغرافية: دراسة السكان (بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بلا سنة)
[56] Qahtan, Al Nasri, Landlords, Lineages & Land Reforms in an Iraqi Village, University of Durham, 1978 (Unpublished Dissertation)
[57] ميتشيل، دينكن (تحرير)، معجم علم الأجتماع، (ترجمة د. إحسان محمد الحسن) (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1981)
[58] ————، إتجاهات جديدة في علم الأجتماع (ترجمة د. إحسان محمد الحسن وآخرون) (بغداد: بيت الحكمة، 2001)
[59] الحسن، د. إحسان محمد، الأنبياء عراقيون، (بغداد: مطبعة الحضارة، 2000)
[60] —————————————، ص 8
[61] —————————————، ص 79 – 90
[62] —————————————، ص 176 – 200
[63] حمزة، د. كريم محمد، البغاء السري في بغداد: دراسة ميدانية، قسم علم الأجتماع، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1974 (رسالة ماجستير غير منشورة)
[64] ——————-، دراسات تحليل المضمون، الجزء الأول والثاني، مجلة البحوث الأجتماعية والجنائية، المركز القومي للبحوث الأجتماعية والجنائية، العدد 1، السنة الرابعة، 1975
[65] عبد الكريم، د. ناهدة، دراسة حالة الرعب الجمعي في مدينة بغداد، قسم علم الأجتماع، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1975 (رسالة ماجستير غير منشورة)
[66] ——————، ثورة العشرين: الأسباب والآثار الأجتماعية، قسم علم الأجتماع، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2000 (أطروحة دكتوراه غير منشورة)
[67] Yassin, Adnan Mustafa, Women & Development in an Urban Context: A Study of Migrated Women in Mousil City, Sociology Department, University of Hull, 1990 (Unpublished Dissertation)
[68] إتصال هاتفي برئيسة قسم علم الأجتماع في كلية العلوم الأنسانية، جامعة السليمانية دة. جوان بختيار، 7 أيلول، 2013
[69] إتصال هاتفي برئيس قسم علم الجتماع سابقاً في كلية الآداب، جامعة صلاح الدين (أربيل) د. صباح النجار، 8 أيلول، 2013
المراجع
Wardi, Ali Husayn, A Sociological Analysis of Ibn Khaldun’s Theory: A Study in the Sociology of Knowledge, University of Texas (Unpublished Dissertation), 1950
حنتوش، د. خالد ساجت، النتاج البحثي في القسم الأم لعلم الأجتماع في العراق: دراسة تحليلية – إحصائية لما أنتج في الدراسات العليا (1972 – 2011) (بحث مقبول للنشر في بيت الحكمة)، بغداد، 2013
النقيب، د. مرتضى حسن، على الوردي والتحديث في المجتمع العراقي (بغداد: كلية الآداب، جامعة بغداد، 2013) (بحث غير منشور)
الوردي، د. علي حسين، شخصية الفرد العراقي (بغداد: مطبعة الرابطة، 1951)
——————-، خوارق اللاشعور أو أسرار الشخصية الناجحة (مستنسخ) (بغداد: بلا مطبعة، 1952)
——————-، وعاظ السلاطين (مستنسخ) (بغداد: بلا مطبعة، 1954)
Wardi, Ali Hussain, A Study in the Sociology of Islam, University of Texas, (Unpublished Research), 1948
Al- Qazzaz, Ayad, Sociology in Underdeveloped Countries: A Case Study of Iraq, The Sociological Review, Vol. 20, No. 1, 1972
الطاهر، د. عبد الجليل (ترجمة) العشائر والسياسة (بغداد: مطبعة الزهراء، 1958)
—————————-، المزارع التعاونية الجماعية (بغداد: مطبعة العاني، 1960)
—————————-، أصول الطبقة الوسطى في عصر التنوير’، (بغداد: مطبعة الرابطة، 1960)
—————————-، العشائر العراقية (بيروت: مطابع دار لبنان، 1972)
الطاهر، د. عبد الجليل، التفسير الأجتماعي للجريمة (بغداد: مطبعة الرابطة، 1954)
الطاهر، د. عبد الجليل، المشكلات الأجتماعية في حضارة متبدلة (بغداد: دار المعرفة، ص 195، 1953)
الطاهر، د. عبد الجليل، أصنام المجتمع: بحث في التحيز والتعصب والنفاق الأجتماعي (بغداد: مطبعة الرابطة، 1956)
الطاهر، د. عبد الجليل، علم إجتماع المسرح: بحث في الأشباح الجماعية، مجلة الآداب، العدد 12، ص 65 – 110
Durkheim, Emile, Suicide: A Study in Sociology (Translated by John A. Spauling & George Simpson)(New York: A Free Press, 1951)
Durkheim, Emile, The Elementary Forms of Religious Life (Translated from the French by Joseph Ward Swain) (London: The Free Press, 1915)
الكعبي، د. حاتم صاحب، في علم إجتماع الثورة (بغداد: مطبعة الزهراء، 1959)
——————-، نمو الفكر الأجتماعي (بغداد: المكتبة العصرية، 1964)
——————-، من آثار الأتصال والأحتكاك الأجتماعي والحضاري: الحركات الأجتماعية التي تدور حول منقذ منتظر، ص 200 – 217، مجلة الأستاذ، المجلد الثالث عشر بعدديه الأول والثاني، مطبعة الحكومة، بغداد، 1965 – 1966
——————-، حركات المودة (الديوانية: مطبعة الديوانية الحديثة، 1971)
——————-، السلوك الجمعي (الجزء الأول) (الديوانية: مطبعة الديوانية الحديثة، 1973)
Qais, Alnouri, Conflict & Persistance: The Iraqi Chaldean Acculturation, University of Washington, Seattle, 1964 (Unpublished Dissertation)
النوري، د. قيس نعمة، مدارس الأنثروبولوجيا (بغداد: دار الحكمة للطباعة والنشر، 1991)
———————، آفاق الديموقراطية والتركيب الثقافي العربي، ص 38 – 49، مجلة الفكر العربي، العدد 85 – 86، 1996
———————، مشخصات الأغتراب الأكاديمي العربي، ص 64 – 75، دراسات عربية، العدد 1- 2، 1996
Al Nouri, Qais N., Pecuniary Trends Among the Urbanizing Tribals in the
Middle East Focusing on Iraq, pp. 75 – 90, International Journal of Contemporary Sociology, Vol. 35, No. 1, April 1998
السامرائي، متعب مناف، ثورة على القيم (بغداد: بلا مطبعة، 1965)
———————-، الواقع الفكري والمجتمع العربي الجديد: هل يستطيع العرب فهم ماضيهم وتقييم حاضرهم والأنطلاق نحو مستقبلٍ أفضل (بغداد: مطبعة العامل، 1966)
المشاط، محمد، كنت سفيراً للعراق في واشنطن: حكايتي مع صدام في غزو الكويت (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2008)
Salim, S. M., Marsh Dwellers of the Euphrates Delta (Monographs on Social Anthropology, No. 23) (London: The Althone Press, University of London, 1962)
سليم، شاكر مصطفى، الجبايش: دراسة أنثروبولوجية لقرية في أهوار العراق (الطبعة الثانية) (بغداد: مطبعة العاني، 1970)
كلوكهون، كلايد، الأنسان في المرآة: علاقة الأنثروبولوجي بالحياة المعاصرة (ترجمه وعلق عليه د. شاكر مصطفى سليم) (بغداد: المكتبة الأهلية، 1964)
مير، لويس، مقدمة في الأنثروبولوجيا الأجتماعية (ترجمة وشرح شاكر مصطفى سليم) (بغداد: دار الشؤون الثقافية، 1983)
سليم، د. شاكر مصطفى، قاموس الأنثروبولوجيا (أنكليزي – عربي) (الكويت: جامعة الكويت، 1981)
شكارة، د. عادل ود. عبد المنعم الحسني، التخطيط الأجتماعي (بغداد: دار الحكمة للطباعة والنشر، 1992)
التكريتي، د. يونس حمادي، مبادئ علم الديمغرافية: دراسة السكان (بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بلا سنة)
Qahtan, Al Nasri, Landlords, Lineages & Land Reforms in an Iraqi Villege, University of Durham, 1978 (Unpublished Dissertation)
ميتشيل، دينكن (تحرير)، معجم علم الأجتماع، (ترجمة د. إحسان محمد الحسن) (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1981)
————، إتجاهات جديدة في علم الأجتماع (ترجمة د. إحسان محمد الحسن، د. عبد المنعم الحسني، د. حمدي حميد يوسف، إبراهيم عبد الرزاق) (بغداد: بيت الحكمة – 2001)
الحسن، د. إحسان محمد، الأنبياء عراقيون، (بغداد: مطبعة الحضارة، 2000)
حمزة، د. كريم محمد، البغاء السري في بغداد: دراسة ميدانية، قسم علم الأجتماع، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1974 (رسالة ماجستير غير منشورة)
——————–، دراسات تحليل المضمون، الجزء الأول والثاني، مجلة البحوث الأجتماعية والجنائية، المركز القومي للبحوث الأجتماعية والجنائية، العدد الأول، السنة الرابعة، 1975
عبد الكريم، د. ناهدة، دراسة حالة الرعب الجمعي في مدينة بغداد، قسم علم الأجتماع، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1975 (رسالة ماجستير غير منشورة)
——————، ثورة العشرين: الأسباب والآثار الأجتماعية، قسم علم الأجتماع، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2000 (أطروحة دكتوراه غير منشورة)
Yassin, Adnan Mustafa, Women & Development in an Urban Context: A Study of Migrated Women in Mousil City, Sociology Department, University of Hull, 1990 (Unpublished Dissertation)
لتنزيل البحث كملف بي دي أف انقر هنا

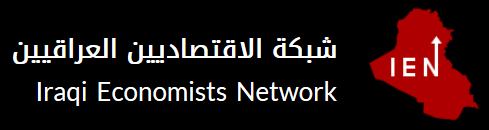

أشكر الدكتورة لاهاي على اقدامها في طرح الموضوع لأهميته الكبيرة ومحاولتها تحقيق الشمولية في مناقشته ، وساتوقع منها انتظار وقبول ماسيرد على الموضوع من ملاحظات واراء اضافية بقصد الأغناء وزيادة الدقة ، وسأبادر بتقديم بعض الملاحظات .
1 – عند استعراض الماضي لعلم الأجتماع من خلال بدء تأسيس قسم علم الأجتماع في كلية الآداب في جامعة بغداد مطلع الخمسينات من القرن الماضي ، تضمن هذا الأستعراض اسماء الأساتذة الرواد ممن ساهموا في مسيرة القسم المذكور ، ولاحظت في هذا الأستعراض مايلي :
أ / اغفال أسماء أساتذة مهمين لا يفترض تجاهلهم الذي بدى هنا مقصودا” مع الأسف الشديد وفي مقدمتهم
+ الأستاذة بهيجة أحمد شهاب (رحمها الله) التي عملت في القسم منذ تاسيسه في عام 1954
ولغاية عام 2006 أذ تقاعدت من الوظيفة بعد خدمة تجاوزت (50) عاما” .
وكان لها ادوارا مهمة في تطوير مناهج علم الأجتماع ، بل وكانت العنصر المهم في تاسيس
قسم الخدمة الأجتماعية ( أستكمالا” لدور قسم علم الأجتماع ) الذي أغلق في عام 1969 ،
ثم استمرارها بنشاط متواصل في قسم علم الأجتماع لتدريس طلبة البكالوريوس والدراسات
العليا، اذ كانت موضع احترام وتقدير ومحبة من الجميع اساتذة وطلبة ، وقد تكون الدكتورة
لاهاي أحدى طالباتها في مرحلة البكلوريوس التي انهتها في عام 1977 ، ولعلها زاملتها
كتدريسية في السنوات (92-1988) و (2001-2006) ، لذا أجد أن مثل هذا الدور يجب
أن لايغفل بل على العكس من ذلك أذ يجب ان يوضح لتبيان البيئة العلمية ورصانة القسم
الذي تنتمي اليه ايضا الدكتورة لاهاي.
+ الدكتورة فتحية الجميلي : كانت من أساتذة قسم علم الأجتماع منذ الثمانينات .
+ الدكتورة فوزية العطية : من أساتذة قسم علم الأجتماع وتولت رئاسة القسم لعدة سنوات ، والغريب هنا
هو الأشارة اليها بصورة باهتة (بدون ذكر اسمها ) على انها شابة تعينت حديثا” في القسم و دَرست
المادة التي اخذت من الدكتور علي الوردي وفشلها في الحفاظ على حيوية المادة .
+ الدكتورة فهيمة المشهداني : لم تذكر أيضا” .
بـ / عدد أخر من الأساتذة لم يرد ذكرهم مع اعتقادي بأهمية أدوارهم و سنوات وجودهم في القسم (بعضهم
منذ الستينات و السبعينات ) مثل :
الأستاذ عبد الجبار عريم ، الأستاذ خلوف ، د. علاء البياتي ،د. مازن بشير ، د. نبيل نعمان ، د. صبيح
شهاب ، د. عبد اللطيف العاني وتولى رئاسة القسم لعدة سنوات ، وربما هنالك غيرهم الكثير.
علما” أنه تم ذكر اسماء اساتذة التحقوا مؤخرا” في القسم بعد منتصف التسعينات مثل د. كريم حمزة
و د. عدنان ياسين
2 – لاحظت تفاوت في مساحة ما كتب عن من ذكرت اسمائهم بالرغم من أهمية دور كل منهم :
د. علي الوردي / 49 سطر
د. علي جواد الطاهر / 69 سطر ، تضمنت 29 سطرا” نقدا” لكتابه ( اصنام المجتمع )
د. حاتم الكعبي / 30 سطر ، د. قيس النوري / 21 سطر ، د. متعب السامرائي / 11 سطر
د. شاكر مصطفى سليم / 13 سطر
ولا حظت اشارات سلبية متعددة في وصف اداء وانتاج د. علي جواد الطاهر وخصوصا” بشأن كتابه
(اصنام المجتمع) ، وتلك الأشارات السلبية كانت بصيغ حادة وغير متوقعة بالنسبة للأنتاج الغزير
للدكتور الطاهر، اذ وصف هذا الكتاب في (29) سطرا” من مجموع (69) سطرا” كتبت عن الطاهر،
ومن الجمل التي ذكرت في هذا الوصف :
( لا يتصف الكتاب بوحدة الفكرة والمنهج انما هو وعاء الكثير من الأشياء )
اما عن مقاله الموسوم (علم اجتماع المسرح) فوصف بأن أسلوبه انشائي ، وهو على الضد من علي
الوردي الكيس !
3 – أقتصر موضوع الكاتبة الدكتورة لاهاي على حال قسم علم الأجتماع في كلية الأداب في جامعة
بغداد مع ان العنوان عن (علم الأجتماع في العراق) ، فلم اجد شيئا” مهما عن اقسام علم الأجتماع
في الجامعات الأخرى كما لم أجد دورا” لمؤسسات معنية اصلا” بالبحث الأجتماعي او المشاكل المجتمعية
كوزارة العمل والشؤون الأجتماعية ( التي تعتبر مراكزها حقول ميدانية خصبة للبحوث الأجتماعية )
ولا لمراكز اخرى لعلها عراقية او اقليمية او دولية قد تكون لها مشاركات او ادوار في بعض المراحل
متعلقة بعلم الأجتماع في العراق واتوقع ان الدكتورة لاهاي قد يكون لديها معلومات عنها وبادوارها .
4 – لم أجد توصيف وتحديدواضح للتحديات
5 – لم أجد أي شيء عن افاق الحل كما يشير العنوان
ان المتعارف عليه ان البحث الأكاديمي يتصف بالعلمية والدقة والحيادية في العرض والمناقشة والأستنتاج
أشكر السيدة الباحثة عن جهدها وادعوها للأستفادة من هذه الملاحظات ان رغبت بذلك
مع تقديري
عنوان مقال الاستاذة الدكتورة ( مستقبل علم الاجتماع فى العراق : التحديات وافاق الحل) لا يتضمن بحث فى علم الاجتماع فى العراق – لم يتناول البحث الواقع الحالى لعلم الاجتماع كعلم له اصوله وطرقه فى البحث العلمى كما لم يتناول المقال التحديات التى تواجه علم الاجتماع من منظور عراقى والانكى من ذلك ان المقال لم يقدم للقارىء اى شيىء ملموس عن ماهية افاق الحل —
اولا – ما علاقة كلية الادب ؟ تقول الباحثة دخل علم الاجتماع عن طريق بوابة كلية الاداب عام 1954 وهذا خطاء تاريخى
فى تاريخ العراق الحديث فان الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم هو اول من الف كتابا فى علم الاجتماع – مقدمة فى علم الاجتماع –
ثانيا – ذكرت الباحثة الاساتذة التدريسيين لعلم الاجتماع واشادت بهم ومن ناحية اخرى اشارت الى واقع القبول فى قسم الاجتماع وتوصلت الى مستقبل هذا العلم فى العراق – لا سيدتى انكى تتحدثين عن واقع التعليم الجامعى وهذا موضوع مهم تكلمتى عنه بوضوح اما علم الاجتماع ومستقبله فلدينا علماء كبار انا فى غنى عن ذكر اسمائهم وربما تكون الباحثة الكريمة احداهم وهولاء هم الذين يوسسون لعلم اجتماع معاصر فى العراق