المقدمة
كشفت سنوات العقوبات الاقتصادية 1991 – 2003 عن مدى هشاشة الاقتصاد العراقي بدون النفط. فقد أدى تراجع تصدير النفط إلى انخفاض حاد في نصيب الفرد من الدخل من 3,512 دولاراً عام 1990 إلى 180 دولاراً فقط عام 1995. وهذه الحقيقة أكدت على أن الثروة النفطية الهائلة التي يملكها العراق ليست سوى مورد مالي يمول الإنفاق العام. فقد أدى سوء التصرف بهذه الثروة الناضبة، وعدم توظيفها لصالح النهوض بقطاعات الإنتاج ، الى جعل النمو الاقتصادي نموا هشا وغير مستدام فضلا عن كونه نمواً لا يولد فرص عمل ، الامر الذي أسهم في استفحال ظاهرة البطالة والهجرة بين الشباب منذ العام 1991 ولحد الان (2016 ).
وعلى الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على إقرار دستور العراق 2005، الذي يشير الى ضرورة إرساء مقومات التحول من اقتصاد ريعيّ إلى اقتصاد متنوع، الا ان الذي حدث هو ترسيخ مؤسسات الدولة الريعية من خلال سياسة الموازنة العامة، التي تعتمد اعتمادا مطلقاً على إيرادات النفط ، وبذلك ازداد الاعتماد على قطاع النفط مع تراجع مساهمة الأنشطة السلعية غير النفطية.
إن القطاع النفطي الذي لا تقل حصته عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي يشغل أقل من 2% من اجمالي قوة العمل، في حين إن 98% من القوى العاملة يعمل في قطاعات منخفضة الإنتاجية لا تتعدى مساهمتها 30% من الناتج المحلي الإجمالي. واثرت طبيعة الهيكل الإنتاجي الريعي على هيكل التشغيل وحجم ونوعية فرص العمل التي يولدها النمو الاقتصادي. ومن المتوقع استمرار بقاء الإيرادات النفطية في موقع الصدارة والتأثير في الاقتصاد العراقي خلال سنوات الخطة 2013-2017، في ظل التحسن المستمر في القدرات الإنتاجية للقطاع النفطي إلى جانب تنفيذ ما تم توقيعه من العقود مع الشركات الأجنبية لزيادة كمية الإنتاج والصادرات.
بناءا على تلك الحقائق يمكن القول إن ظاهرة البطالة وهجرة الشباب تعد من أبرز الدلائل على الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي، فضلا عن دلالتها على حالة الانفصام القائمة ما بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل. ونظرا لدور التوظيف في ترسيخ حالة الاستقرار والاندماج الاجتماعي، لكونه يعكس مستوى تمكين الشباب ومدى شعورهم بالاستقلالية والثقة بالنفس والرضا، يمكن بالتالي أن نعد الارتفاع في معدلات البطالة مؤشرا لما وصلت اليه حالة الإقصاء والفقر والتهميش الاجتماعي. ومن الطبيعي أن يدفع ذلك نحو ارتفاع معدلات هجرة الشباب إلى الخارج في محاولة للتخلص من تلك الأوضاع والاستفادة من منافع العولمة والحصول على فرص عمل أفضل.
بناءا على ما تقدم يمكن القول إن العامل الاقتصادي – وتحديدا اختلال الهيكل الإنتاجي وضعف مستوى الاقتصاد العراقي – يمكن أن يفّسر ظاهرة الهجرة الطوعية للشباب والكفاءات وبخاصة بعد فرض العقوبات الدولية على العراق للمدة (1991-2003). غير ان العامل الاقتصادي لم يعد كافيا لوحده لتفسير نمط هجرة العراقيين وبخاصة الشباب بعد العام 2003 بعد أن أصبحت هذه الهجرة قسرية وحدثت بشكل موجات خصوصاً بعد العام 2006 هروبا من العمليات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والعنف الطائفي والتهجير القسري.
وبالرغم من عدم وجود أرقام رسمية دقيقة تفصح عما وصلت إليه البيانات عن المهاجرين العراقيين، إلا أن ما يلاحظ في التقارير والدراسات الدولية يدعونا إلى الاستنتاج التالي: إن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق منذ العام 2003، قد غذت الرغبة في الهجرة نحو الخارج ، وهذا ما يفسر تصاعد معدلات الهجرة بين شريحة الشباب (الذكور خصوصا) وعلى مختلف مستوياتهم التعليمية، لاسيما الكفاءات الوطنية وبالأخص هجرة الكفاءات العاملة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبحث العلمي، التي تركت اثرا سلبيا على أداء هذه القطاعات. ويتحمل النظام التعليمي قسماً من المسؤولية في هجرة الشباب، نتيجة لضعف التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الذي ادى الى ضعف فرص توظيف الخريجين. وقد تناسبت معدلات البطالة طردياً مع ارتفاع المستوى التعليمي لشريحة الشباب بعمر 15- 29 سنة، حيث تتزايد في فئات الحاصلين على التعليم الجامعي.
مشكلة البحث: أدت حالة الجمود والشلل التي اصابت الاقتصاد العراقي بشكل عام وقطاعات وأنشطة الناتج غير النفطي بشكل خاص بعد العام 2003، الى تغذية عناصر الاقصاء والتهميش والفقر لعنصر الشباب، فضلا عن تأثيرات حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي ورغبة المهاجرين في حياة مستقرة ومستوى معيشي افضل )وهو احتمال الحصول على دخل أعلى أو فرص عمل أفضل (
فرضية البحث: أسهمت ظاهرة ترييع الاقتصاد العراقي بعد العام 2003 المتمثل بالتركيز على قطاع النفط وإهمال بقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى تعميق الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتغذية عناصر الاقصاء والتهميش والفقر لعنصر الشباب، مما أدى الى ارتفاع معدلات الهجرة لعنصر الشباب خاصة.
هدف البحث: التعريف بأهم التحديات الاقتصادية التي أسهمت في تغذية عناصر الاقصاء والتهميش والفقر والبطالة، وأدت الى ارتفاع معدلات الهجرة لعنصر الشباب، الامر الذي يمكن أن يساعد صانع القرار في وضع الحلول والمعالجات الملائمة لتلك الظاهرة.
أهمية البحث: تأتي أهمية البحث من استفحال ظاهرة البطالة والهجرة بين الشباب في العراق وبخاصة من مخرجات التعليم والكفاءات والخبرات والمهارات.
الاستنتاجات : من أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة حول التفسير الاقتصادي لهجرة الشباب في العراق:
1-إن العامل الاقتصادي، وتحديدا اختلال الهيكل الإنتاجي وتراجع مساهمة القطاع غير النفطي، قد جعل النمو الاقتصادي في العراق لا يقترن بتوفير فرص العمل؛ وهذا العامل يفّسر الى حد كبير الهجرة الطوعية للشباب والكفاءات وبخاصة بعد فرض العقوبات الدولية على العراق خلال المدة (1991-2003).
2-أصبحت هجرة الشباب بعد العام 2003 قسرية وحدثت بشكل موجات وخصوصاً بعد عام 2006 وذلك هروبا من العنف المتمثل بالعمليات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والعنف الطائفي والتهجير القسري.
3-إن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق منذ العام 2003، قد غذت الرغبة الهجرة نحو الخارج، وهذا ما يفسر تصاعد معدلات الهجرة بين شريحة الشباب (الذكور خصوصا) وعلى مختلف مستوياتهم التعليمية، سيما الكفاءات الوطنية وبالأخص هجرة الكفاءات العاملة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبحث العلمي، مما كان له تداعيات سلبية عدة على أداء هذه القطاعات. كما ان ارتفاع معدلات البطالة لكافة الأعمار في سن العمل أدى الى ارتفاع معدلات بطالة الشباب.
4-يتحمل النظام التعليمي قسماً من المسؤولية في هجرة الشباب، فضعف التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ادى الى ضعف فرص توظيف الخريجين، وتناسبت معدلات البطالة طردياً مع ارتفاع المستوى التعليمي لشريحة الشباب بعمر 15-29 سنة، حيث تتزايد هذه المعدلات في فئات الحاصلين على التعليم الجامعي. فقد شكلت نسبة العاطلين عن العمل من حملة الشهادة الابتدائية 15.4% من مجموع العاطلين عن العمل في حين بلغت نسبة العاطلين ممن يحملون الشهادة الجامعية فأعلى 31.6% أي ما يقارب الضعف. كما أن نسبة العاطلين عن العمل من حملة الشهادة الإعدادية فما دون بلغت 13%، بينما أرتفع المعدل عند حاملي شهادات أعلى من الإعدادية إلى 24%. إن نسب البطالة لشريحة الشباب مرتفعة في الحضر 20% وتنخفض في الريف إلى 14.9%، إلى جانب ظاهرة البطالة المقنعة. كذلك فان نسبة بطالة الشابات أعلى في الحضر 58% عن الريف 10% وهي نسب تعكس الواقع، إذ أن مشاركة المرأة الاقتصادية هي أعلى بكثير في الريف من المصرح به في الأرقام الرسمية التي تعتمد التعريفات الدولية.
5-إن وصول القطاع العام الى نقطة التشبع من القوى العاملة وتفاقم ظاهرة التضخم الوظيفي في جميع مؤسسات الدولة، قد اقترن بندرة ذوي المهارات من الخريجين، وضعف فرص العمل وإمكانات التوظيف خارج القطاع الحكومي، ولم يعد متاحاً امام الخريج غير الاعمال الهامشية والمنخفضة الإنتاجية، وهذا ما يفسر أيضا انتشار ظاهرة البطالة البنيوية (الناقصة والمقنعة) في العراق، وتلك الظروف مهدت الأرضية لتزايد معدلات الهجرة
6-إن المعالجات غير الناجحة التي تبنتها الحكومة من أجل التصدي لمشكلة البطالة تفسر إلى حد ما ارتفاع معدلات العمالة الناقصة بين صفوف الشباب العاملين في القطاع الحكومي ومن هذه الإجراءات:
أ-اعتماد أسلوب العقود الوقتية كصيغة من صيغ التشغيل من أجل الحد من معدلات البطالة الظاهرة، وشملت هذه العقود الشباب الخريجين بشكل خاص، وإعادة توزيع موظفي الوزارات الملغاة.
ب-سياسة التوسع في التوظيف في القطاع الحكومي التي تبنتها الدولة بعد عام 2005 والهادفة اضطراراً إلى زيادة أعداد المشتغلين في الدولة سيما في الجهاز الأمني.
ج-إن اعتماد سياسات قصيرة الأمد لاستيعاب جزء من البطالة الظاهرة أو الصريحة أدى إلى تحويلها إلى عمالة ناقصة وذلك من خلال توفير فرص عمل وقتية للعاطلين وبساعات محدودة للحد من فقر الدخل.
التوصيات
أصبح من الصعب التوجه نحو الحل المناسب للمشكلة الاقتصادية للشباب بدون النهوض بالطاقات الإنتاجية لأنشطة الناتج غير النفطي وبخاصة الصناعة التحويلية والزراعة والخدمات والإدارة الحكومية، من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وبخاصة المشروعات الصغيرة والمشروعات الكثيفة العمل وهذا الامر يتطلب
- هناك حاجة ملحة لتوجيه نسبة كبيرة من التخصيصات الاستثمارية للنهوض بقطاعات الإنتاج وبخاصة الصناعة التحويلية والزراعة
- ضرورة قوية الصلة بين الجامعة والواقع الإنتاجي، بالاعتماد على حاضنات الأعمال المرتبطة بالجامعة مما يجعلها إحدى أعمدة التنمية الاقتصادية، وكذا مساعدة الخريجين على بناء مؤسساتهم الخاصة.
- ضرورة تهيئة الظروف المادية والبشرية لإنشاء حاضنات الأعمال على مستوى الجامعات.
وتفعيل دور حاضنات الأعمال، في عملية التنمية، وذلك من خلال توفير بيئة تشريعية وقانونية تعطي لهذه الحاضنات دورا أكبر في العملية التنموية.
- ضرورة الاستفادة من الكفاءات المحلية والمهاجرة، والاستفادة من ثورة المعلومات، من أجل المساهمة في بناء مؤسسات تكنولوجية تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
- ضرورة توفير الدعم والتمويل لمشروعات الشباب بشكل عام وللمشروعات الصغيرة بشكل خاص
- ضرورة تأهيل جيل من أصحاب الأعمال ودعمهم ومساندتهم لتأسيس أعمال جادة وذات مردود، مما يساهم في تنمية الإنتاج وفتح فرص للعمل للشباب والنهوض بالاقتصاد.
- ضرورة التطبيق المكثف لبرامج التنمية البشرية وبرامج إعادة تأهيل المهارات وتحسين الإنتاجية ؛ وإدخال التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الإنتاج والاتصالات والمعلومات
- ضرورة إعادة توزيع القوى العاملة الفائضة على الأنشطة الاقتصادية في ضوء احتياجاتها الفعلية، وبما يكفل زيادة مستويات الكفاءة الإنتاجية للعاملين، وإضفاء نوع من المرونة على سياسات التشغيل والتوظيف التي وخاصة في مجال الاستغناء عن خدمات العمالة الفائضة.
(*) أستاذ مساعد /قسم الاقتصاد/كلية الإدارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية
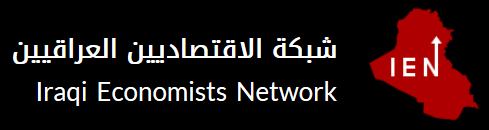


Nice topic Dr Fallah, Could you please send me the link where I can find the whole topic please? I’m writing about the same problem in Libya and It is useful for my references .