مقدمة
شهد الاقتصاد العراقي في بداية القرن الماضي نمواً بطيئاً بمجمل مرافقه البسيطة آنذاك، وأستمر ذلك بوتيرة متصاعدة ومستقرة نسبياً بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة. فازداد نمو قطاع الزراعة بعد تنفيذ بعض مشاريع الري والبزل والتحكم بمياه الأنهار وإنشاء السدود بمعدل 3% سنوياً قبل الخمسينيات لتصبح الزراعة الرافد الأكبر للاقتصاد. لذا صُنف العراق كبلد زراعي حيث كان سكان الريف يشكلون ثلاثة أرباع السكان، حتى وصل الإنتاج الزراعي في سنة 1953 إلى 32.2% من الناتج الإجمالي المحلي.
كذلك ازداد نمو قطاع النفط تدريجياً إثر إنتاجه وتصديره سنة 1927 ولكن حصته في الناتج الإجمالي كانت ضئيلة بالبدء نتيجة العقود غير المنصفة وطنياً مع شركات الاستثمار في فترة الانتداب البريطاني آنذاك. وأخذت بالازدياد ببطء لتصل نسبة 15.7% سنة 1950، ونتيجةً لتطبيق مبدأ نسبة الـ(50-50) إثر أحداث مصدق في إيران عام 1951 وصراعه مع شركات النفط، فقد ارتفعت حصته سنة 1953 إلى 45.7%(1&2).
ولكن بعد التغيير السياسي الاجتماعي الذي شهده العراق سنة 1958 وتوسع مرافق الحكومة وخدماتها وتوسع المدن على حساب الأرياف، أخذت حصة الإنتاج الزراعي بالهبوط إلى 20.6% سنة 1961 ثم إلى 16.7% سنة 1970 ثم إلى 14.3% سنة 2003 وصولاً إلى 4.8% سنة 2013، ثم إلى 2% فقط في النصف الأول من 016 (11). بينما ازدادت بالمقابل حصة عائدات النفط بالصعود إلى نسبة 61.4% من إجمالي الدخل سنة 1979 و63.5% في 2016(11)، وشكلت تلك العائدات أكثر من 95% من مجموع دخل العراق من العملة الصعبة، والمتبقي أقل من 5% من كل صادرات العراق!(2).
وبهذا التغيير الجذري للمجتمع وللدولة، فقد تحول العراق تدريجياً من دولة منتجة زراعياً إلى دولة ريعية بدءاً من أواسط ستينيات القرن الماضي وما زال، وخاصة في العقود الأربعة الأخيرة، حيث يعتمد اقتصاده كلياً على عائدات النفط المُصدر للسوق العالمي المتغير وفقاً لقانون العرض والطلب ومتغيرات السياسة الدولية، مما يفسر تذبذب اقتصاد العراق بين سنوات تقشف حاد وبين سنوات رفاهية نسبياً، إذ بقيت حصص روافد الاقتصاد الأخرى بالناتج الإجمالي تراوح بدون نمو مؤثر، بل تراجعت حصة الصناعات التحويلية من 9.6% من كامل الدخل في الستينات والسبعينات لتهبط إلى 4.3% سنة 2003 ثم إلى 2.4% في 2013(1)، ثم إلى 0.9% فقط وكذلك حصة الكهرباء في 2016(11).
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل ملف بي دي أق سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Karim Al-Sabaa – Energy Industries in Iraq final
كريم مجيد السبع: صناعات الطاقة بالعراق

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية
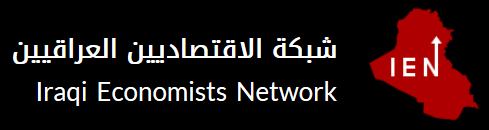

إدارة الخطر والتأمين – مطلب مهم في صناعة النفط العراقية
قدّم لنا المهندس السيد كريم مجيد السبع في مقالته “صناعات الطاقة بالعراق” عرضاً شمل جوانب تاريخية لصناعة النفط والغاز، وتحول الاقتصاد الزراعي إلى اقتصاد ريعي، والتغييرات في مستويات الإنتاج وتقلبات الأسعار، وطبيعة العقود النفطية مع الشركات الأجنبية، ومجموعة متميزة من المقترحات (13 مقترح).
لم تضم هذه المقترحات، التي وصفها بالضرورية، مقترحاً حول سياسة إدارة الخطر والتأمين التي يمكن لوزارة النفط، أو شركة النفط الوطنية العراقية التي يقترح إعادة تأسيسها، أن تتبناها. وهذا ليس بالمستغرب لأن موضوع إدارة الخطر والتأمين غائبة في جلّ الكتابات المنشورة عن صناعة النفط وحتى في مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية (أنظر مصباح كمال: مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية وغياب التأمين في التشكيلات الإدارية للشركة:
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/(
وبودي، لذلك، التقدم باقتراح حول دراسة موضوع تأسيس قسم أو إدارة متخصصة للتأمين وإدارة الخطر على مستوى وزارة النفط، إن كان شراء الحماية التأمينية مركزياً. أو على مستوى شركة النفط الوطنية العراقية عند تأسيسها. أو على مستوى كل كيان من كيانات وزارة النفط. (وبالطبع يمكن تطبيق هذا المقترح على صناعة الطاقة الكهربائية).
يقتضي هذا المقترح إعادة نظر جذرية، من قبل الوزارة أو شركة النفط الوطنية وغيرها من الشركات المنضوية تحت مظلة وزارة النفط، بالموقف من المخاطر التي تكتنف صناعة النفط في مختلف مراحلها، داخلياً، والمسؤوليات المدنية التي قد تنشأ عنها تجاه الأطراف الثالثة، وتلك المتأتية من الخارج كالأعمال الإرهابية ومنها تفجير الآبار النفطية. وأعنى بهذا تجاوز النظر التقليدية الضيقة التي تحصر التعامل مع الأخطار بتحويل عبئها على شركات التأمين – أي حصر إدارة الخطر بمجرد شراء وثيقة للتأمين، وهو السائد حالياً وبصيغة غير حرفية (كما ينقل لنا بعض المطلعين على هذا الجانب من عمل وزارة النفط).
تفيد الدراسات المعنية بإدارة الخطر أن إدارة الخطر في أية مؤسسة تتطلب معالجة ثلاث قضايا يمكن إجمالها بالآتي:
أولاً-وضع وتطبيق نظام للتعامل مع الأخطار/التهديدات، وتتضمن جملة من الإجراءات:
– تشخيص وتوقع مصادر الأخطار/التهديدات المرتقبة (الداخلية والخارجية)
– قياسها وتقدير آثارها وتقييمها (الخسائر والأضرار المادية والمسؤوليات تجاه الأغيار وخسارة الإيرادات)
– وضع وسائل السيطرة عليها (هندسياً أو تجارياً من خلال آلية التأمين)
– تسجيل المعلومات والبيانات والقرارات الخاصة بها
– رصد ومراقبة النتائج
ثانياً-تبني الإجراءات للسيطرة الاقتصادية على الأخطار/التهديدات:
– تحقيق تخفيض في التكلفة الإجمالية للأخطار من خلال شراء الحماية التأمينية المناسبة، والتأمين الذاتي، والسيطرة الإدارية والهندسية على مكامن الخطر.
– تبني نظام لتقليل إمكانية قيام الخسارة الكارثية والحد من آثارها عند تحققها.
– ضمان استمرار بقاء المؤسسة وفي ذات الوقت تقليص الإنفاق الإجمالي للسيطرة على الأخطار.
ثالثاً-تحديد مسؤوليات الإدارة تجاه الأخطار
أي عدم حصر التعامل مع الأخطار بالموظف الذي يقوم بشراء التأمين أو المهندس الذي يقوم بإجراءات تحسباً لقيام وضع ينشأ عنه خسارة. فشراء التأمين والسيطرة الهندسية على الأخطار كلاهما يقتضيان تخصيصات في الميزانية. وعدا ذلك فإن تحديد الأهداف والكفاءة التنظيمية تقع في صلب المسؤوليات الإدارية. ولذلك لا تجد مشاكل إدارة الخطر حلولاً مناسبة في الشركات سيئة الإدارة.
هذه الملاحظات الأولية لا تستنفذ سعة الموضوع وهي على أي حال بحاجة إلى تدقيق وبحث متخصص إذ أن مجرد الإشارة إلى العناصر الداخلة في مفهوم إدارة الخطر (التشخيص، القياس، السيطرة) ليس كافياً.
آمل أن يجد هذا المقترح من يهتم به، مثلما آمل الاهتمام بالمقترحات التي قدمها السيد كريم السبع.
مصباح كمال
1 نيسان 2017
اقول وهذا راي- بكل تواضع حبذا لو يستكمل الباحث بحثه القيم باجراء دراسة لدعم مقترحه بان يكون الانتاج بحدود ٥ او٦ مليون برميل يوميا واقترح ان تتناول الدراسة موشرات اساسية ومنها :
اولا- الموشرات الرءيسية لمستقبل سوق النفط والطاقة – العرض والطلب على النفط خلال السنوات العشر القادمة
ثانيا- معدلات نمو الطلب على مصادر الطاقة
ثالثا- النمو الاقتصادي العالمي
رابعا- معدلات النمو السكاني العالمي
خامسا – الاسعار التنافسية لمصادر الطاقة
سلدسا- سياسات الدول المستهلكة – زيادة كفاءة الاستهلاك واحلال المصادر الاخرى للطاقة محل النفط- استخدام السياسات الضريبية للحد نمو الاستهلاك
سابعا- الخزين التجاري والحكومي للنفط الخام والمنتجات النفطية
مع خالص تقديري للباحث الفاضل