«لا يمكن أن تكون هناك حرية فردية حقيقية مع غياب الأمن الأقتصادي»
«جستر باولز»
الحلقة الأولى
عندما تجتاح شعباً من الشعوب هزّة كبرى، بسبب حرب أو ثورة، ويزول مع تلك الهزّة نظام ويحلّ محله نظام جديد، ويهدأ الصراع وتستقر الأمور للنظام الجديد، طوعاً أو كرهاً، يرتسم بعد ذلك السؤال الاقتصادي الأزلي، على فم كل مواطن: وماذا بعد؟ نحن نريد أن نستقر، نريد أن نأكل، نريد أن نلبس، نريد أن نحيى حياةً جيدة، مادياً ومعنوياً! فإن نجح النظام في الاقتصاد نجح في السياسة، وإن فشل في الاقتصاد، يفقد كل شيء آخر معناه ويسقط النظام حتماً حتى لو نازع في سبيل البقاء لمدة قد تطول. ذلك ما يتعرض له النظام العراقي الآن!
لقد حلت بالعراق كارثة اقتصادية رهيبة، خلال الثلاثين سنة الماضية، نتيجة لسياسات التسلط والاستبداد والقمع والدكتاتورية وما نتج عنها من حروب وحصار اقتصادي طويل، ثم احتلال أجنبي ومحاصصة طائفية وإثنية وتخلف وفساد وعنف وإرهاب. ونريد هنا أن نجيب في هذه السلسلة من المقالات عن سؤال فحواه: ماذا يجب أن نعمل وما هي الخيارات المتاحة لانتشال العراق من الهوّة السحيقة التي وقع بها؟ ماذا يمكن أن تقوم به الحكومات العراقية بالتضامن مع الشعب العراقي، وبالتضامن مع المجتمع الدولي أيضاً، للخروج بالعراق من نفق التخلف الاقتصادي الطويل المظلم الذي دخل به؟ كيف سيتمكن العراق من استعادة عافيته الاقتصادية ثم المضي في طريق التطور الاقتصادي ليلحق بدول عديدة لم تكن أفضل منه في سبعينات القرن الماضي ولكنها حققت بالنهاية نجاحاً اقتصادياً باهراً، ومنها النمور الآسيوية كتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا؟
الحاجة الى المال
إن العراق بحالته الحاضرة، ولمدة عشرين سنة قادمة على الأقل، سيحتاج الى استثمارات هائلة لأعادة بناء بنيته التحتية الخربة والتوسع بها باستمرار لمواجهة حاجات تكاثر سكاني مستمر ودعم اقتصاد من المفترض أن يُخطط له لتحقيق نموٍّ سريع خلال العقدين القادمين ليس فقط لأزالة آثار الدمار والتخلف الذي أصابه خلال الثلاثين سنة الماضية، بل واللحاق بالتطور الذي أنجزته بلدان عديدة من الناحيتين المادية والبشرية.
من أجل توضيح مدى حاجة العراق الى الأمول الأستثمارية، نرجع أولا الى حرب الخليج الثانية التي نشبت أثر غزو الكويت، إذ لازال الأقتصاد العراقي يترنح تحت تداعياتها. لقد ورد في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 1992 أن مجموع الخسائر المادية المباشرة، أبان عامي 1990 و1991، التي لحقت بالاقتصاد العراقي قُدّرت بنحو 232 مليار دولار وهي كلفة الدمار الذي لحق بالمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والبنية الأساسية التحتية في العراق(2). أضف الى ذلك أن البنية التحتية تلك تعرضت الى التآكل والأندثار خلال سنوات الحصار الطويلة، وفوق ذالك تعرضت المكائن والمعدات الى التعطّل بسبب ما يمكن أن يسمى بسياسة النهش(3) (Cannibalisation) نتيجة لعدم توفر قطع الغيار. كما تعرضت البنية التحتية العراقية الى أضرار إضافية – وإن بدرجة أقل – خلال غزو العراق في سنة 2003، نتيجة لضربات الحرب المباشرة وكذلك نتيجة للنهب والتخريب المتعمد.
أن الخسائر المادية المذكورة ترتفع قيمتها بمر الزمن نتيجة للتضخم. فمثلاً إذا كان معدل التضخم خلال عشرين سنة ابتداءً من سنة 1991 يعادل 3% فقط، فإن كلفة 232 مليار دولار سترتفع الى نحو 420 مليار دولار في سنة 2011. ولأعطاء مثال واقعي عن هذا الموضوع ذكر مبعوث الأمم المتحدة صدر الدين أغا خان، عند زيارته للعراق في حزيران – تموز 1991، أن كلفة ترميم المنظومة الكهربائية المدمرة ستبلغ على الأقل 12 مليار دولار وأن كلفة تبديلها تبلغ نحو 20 مليار دولار(4). كان ذلك التقدير في منتصف 1991، وفي 2005 أعلنت وزارة الكهرباء أن أعادة بناء المنظومة الكهربائية بالكامل سيكلف نحو 35 مليار دولار. أما نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، الدكتور حسين الشهرستاني، فقد صرح في الثالث من هذا الشهر (شباط 2011) أن العراق سيحتاج الى أكثر من 80 مليار دولار للأستثمار في محطات جديدة للطاقة الكهربائية خلال العشرين سنة القادمة(5). أن هذه الأرقام المتصاعدة لا تدل فقط على زيادة الكلفة نتيجة للتضخم، وأنما تدل أيضاً على استمرار الزيادة السكانية وحاجتها الى توفير بُنى تحتية جديدة. زد على ذلك أن التحسن الأقتصادي مع الوقت يستتبع ارتفاع مستوى السكان المعاشي وهذا بدوره يتطلب بنية تحتية وخدمات بمستوى أفضل وذلك بالطبع يستدعي كلفة أعلى. كذلك الأمر أذا أردنا تعويض أندثارات البنية التحتية خلال سنوات الحصار وتعويض الخسائر المادية خلال غزو العراق في 2003.
ولا يتوقف الأمر عند تلك التعويضات، ذلك أن الأقتصاد العراقي ممثلاً بالناتج المحلي الأجمالي كان ينمو نمواً حقيقياً (أي بالأسعار الثابتة خالياً من تأثيرات التضخم) بمعدل تجاوز 8% خلال الفترة 1960 – 1980 وتجاوز 11% خلال الفترة 1970 – 1980. ولكن ذلك النمو الفائق قد توقف عند اندلاع الحرب مع أيران، بل أصبح سالباً في أغلب سنوات الفترة 1980 – 2003، فتراجع تبعاً لذلك بمعدل قارب 3% سنوياً خلال تلك الفترة. وعلى الرغم أن الناتج المحلي الأجمالي نمى نمواً حقيقياً قُدّر معدله بنحو 11% سنوياً خلال السنوات 2003 – 2010 ألا أنه بقى متأخراً جداً (بالأسعار الثابتة) عن مثيله في سنة 1980، وهي السنة التي بلغ فيها الناتج المحلي الأجمالي العراقي قمته خلال فترة الخمسين سنة الماضية من تأريخ العراق الحديث. فالناتج المحلي في سنة 2010 (بالأسعار الحقيقية لسنة 2010) لم يتجاوز 41% من قيمته في 1980. أما أذا تكلمنا عن معدل دخل الفرد العراقي من الناتج المحلي الأجمالي، وهو مؤشر مهم لمستوى السكان المعاشي، فالطامة تبدو أكبر. ذلك أن عدد سكان العراق الذي كان 14 مليون نسمة في سنة 1980 ازداد الى 32 مليون نسمة بحلول سنة 2010، وبذلك هبطت حصة الفرد من الناتج المحلي الأجمالي في 2010 الى 18% فقط مما كانت عليه في سنة 1980. وبهذا المستوى المتدني أصبحت حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي الأجمالي والبالغة نحو 2,625 دولاراً في 2010 تعادل أقل من 29% من المعدل العالمي بنفس السنة والبالغ 9,193 دولاراً، بينما بلغت حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي الأجمالي في سنة 1980 نحو 3570 دولاراً (بأسعار 1980) وكانت تعادل بتلك السنة نحو مرة ونصف المعدل العالمي الذي بلغ 2,472 دولاراًً فقط. ومعنى كل هذا أن على الأقتصاد العراقي أن يحقق نمواً بوتيرة أسرع إن أُريد له تعويض ما فاته خلال الثلاثين سنة الماضية واللحاق، أو على الأقل الأقتراب، من المستويات الأقتصادية للنمور الآسيوية.
عدالة توزيع الدخل
هذا وينبغي أن لا ننسى أن حصة الفرد من الناتج المحلي الأجمالي – وهي حاصل قسمة ذلك الناتج على مجموع السكان بنفس السنة – تستبطن توزيع الدخل توزيعاً عادلاً بين هؤلاء السكان. ولكن هذا لا يحدث بالعراق. ذلك أن حصة الفرد من الناتج المحلي في 2010 وهي وإن بلغت 2,625 دولاراً (أي نحو 220 دولاراً شهرياً، أو مايزيد قليلاً عن سبعة دولارات يومياً) إلا أن نتائج الدراسة التي أجراها البنك الدولي بالاشتراك مع وزارة التخطيط، والتي نُشرت في 25/1/2009، أشارت الى أن 44% من سكان العراق يقل دخلهم الشهري عن 85 دولار(6). كما أشارت لسوء الحالة المعاشية المتفشية في العراق دراسة أحدث أجراها الجهاز المركزي للإحصاء واستنتج منها أن 23% من الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر، أي أن الفرد الواحد من هذه الشريحة يعيش على أقل من دولار واحد باليوم(7). فأين هذا من معدل الدخل المحسوب على أساس كونه يزيد عن سبعة دولارات يومياً على قلته؟ إن الخلل الكبير في عدالة توزيع الدخل في العراق، الذي بدأ مع تسلم صدام حسين للسلطة المطلقة في العراق قد استفحل بمر الزمن ولم يتحسن بعد سقوط النظام. بل ازداد سوءاً بسبب سوء الأدارة وتبديد أموال الدولة نتيجة تفشي الفساد وتسلط طبقة حاكمة قامت بتقنين نهب المال العام بتخصيص رواتب ومخصصات فلكية ذات أنواع شتى ما أنزل الله بها من سلطان.
تخمين الحاجة الى المال
من أجل تخمين الاستثمارات الواجب القيام بها في بلدٍ ما، كالعراق مثلاً، خلال فترة زمنية معينة لابد من معرفة الأهداف المتوخاة من تلك الاستثمارات، والتي قد تحددها خطة البلد الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية خلال الفترة الزمنية المعنية، ومنها النمو السنوي الحقيقي المطلوب في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك معرفة طبيعة اقتصاد البلد وكفائته من حيث الإنتاجية ومدى قدرته الاستيعابية. ومن أجل القيام بهذا التخمين لنفترض أن النمو الاقتصادي المطلوب تحقيقه هو 12 بالمائة سنوياً (بالأسعار الثابتة) لمدة 20 سنة خلال الفترة الزمنية 2011-2030، وهذا النمو ليس من الصعب تحقيقه نظراً لكون الاقتصاد العراقي ينطلق الآن من قاعدة متدنية بعد تدهوره بمعدل 3% سنوياً منذ سنة 1980 كما رأينا أعلاه. ولنفترض أيضاً أن نسبة تراكم رأس المال إلى الناتج (Capital-Output Ratio) هي 4 إلى 1 خلال الفترة 2011-2020 وأن إنتاجية الاقتصاد العراقي ستتحسن بحيث أن هذه النسبة ستهبط الى 3 إلى 1 بعد سنة 2020.
فخلال الفترة 2011-2020 ومن أجل تحقيق نمو سنوي حقيقي (أي بالأسعار الثابتة) قدره 12%، يجب أن يبلغ تراكم رأس المال (Capital Formation) نحو 48% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً ثم ينخفض إلى 36% سنوياً خلال الفترة 2021-2030. وبموجب هذه الافتراضات سيكون مجموع تراكم رأس المال المطلوب نحو 2,620 مليار دولار خلال الفترة الزمنية 2011 – 2030، أي أن العراق سيحتاج الى استثمارات قدرها 131 مليار دولار سنويا خلال العشربن سنة 2011 – 2030، وذلك بالأسعار الثابتة لسنة 2010. أما أذا حسبنا الأستثمارات بالأسعار الجارية، وهو تعبير عن القيمة الواقعية لمبالغ الأستثمارات المطلوبة، فأن العراق سيكون بحاجة الى استثمارات قدرها نحو 273 مليار دولار سنوياً إذا افترضنا أن معدل التضخم السنوي سيكون 3% لمدة العشرين سنة القادمة.
من أجل المقارنة بين ما هو مطلوب وما يجري على أرض الواقع ينبغي النظر الى خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 – 2014 التي قامت بإعدادها وزارة التخطيط. فبموجب الخطة هذه يبلغ حجم الأستثمارات الكلية 186 مليار دولار تكون المساهمة بها كالآتي: 100 مليار دولار من خزينة الحكومة الفيدرالية والباقي (86 مليار دولار) يساهم به القطاع الخاص، محلي وأجنبي(8). وستصرف هذه الأموال على مدى خمس سنوات، أي بمعدل 37 مليار دولار تقريباً لكل سنة. فأين هذا المبلغ السنوي الضئيل من 273 مليار دولار من المفروض استثماره سنوياً بموجب حساباتنا أعلاه؟
إن المبالغ الأستثمارية المطلوبة لتطوير الأقتصاد العراقي كبيرة جداً بمقياس العراق ولا يمكن أبداً التعويل على ما تدره الصادرات النفطية من أموال لتوفير حتى جزئ معقول منها. وسبب ذلك أن الميزانية الحكومية الاعتيادية (أي التشغيلية) ستلتهم الجزء الأكبر من أموال الصادرات النفطية في كل سنة، ولن يبقى إلا ما يكاد يكفي لإعادة بناء البنية التحتية وتوسيعها لمواجهة حاجات السكان الذين تتزايد أعدادهم باستمرار، بضمنها حاجات التعليم والصحة والسكن. إن المبالغ الهائلة المطلوبة لتنمية الاقتصاد العراقي، والحالة هذه، يتعين أن يتولاها القطاع الخاص، وفي ذلك سيكون للاستثمار الأجنبي المباشر حصة الأسد. على أن الاستثمار الأجنبي المباشر سوف لن يدخل العراق ما لم تتوفر له البيئة التنافسية المؤاتية، خصوصاً وإن مختلف بلدان العالم تتبارى فيما بينها لاجتذاب هذا النوع من الاستثمار.
——————————————————————————–
(1) هذا المقال مقتبس – مع أجراء بعض الحسابات والتحوير – من كتاب الدكتور محمد علي زيني “الأقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل”، الطبعة الثالثة 2010. يمكن تنزيل الكتاب كاملاً من الموقع:
“http://www.muhammadalizainy.com” www.muhammadalizainy.com
(2) من أجل تفصيلات أكثر للخسائر التي أصابت الأقطار العربية نتيجة حرب الخليج الثانية، بضمنها العراق، أنظر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 1992: صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ص 18.
(3) سياسة النهش في صيانة المكائن تعني في حالة تعطل ماكنة مع عدم توفر قطع الغيار أن تأخذ (تنهش) قطعة سليمة من ماكنة مماثلة ولكنها معطلة هي الأخرى من أجل تشغيل الماكنة الأولى.
(4) أنظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، المؤرخ في 17/7/1991 والمرقم S/22799، ص (34 – 39).
(5) Interview with PLATTS, 3/2/2011.
(6) Middle East Economic Survey, 2/2/2009, P. 16.
(7) INFOWARS.COM, Nearly 25% of Iraqis live below poverty line, May 20,2009.
http://www.infowars.com/nearly-25-of-iraqis-live-below-poverty-line/
(8) أنظر “خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 – 2014″، وزارة التخطيط’ العراق، ص 27.
د. محمد علي زيني
«لا يمكن أن تكون هناك حرية فردية حقيقية مع غياب الأمن الأقتصادي»
«جستر باولز»
الحلقة الثانية
تحدثنا في الحلقة الأولى عن الأنتكاسة الرهيبة التي تعرض لها الأقتصاد العراقي خلال الثلاثين سنة الماضية، وقمنا بتخمين الأموال الأستثمارية التي سيحتاج أليها العراق لأعادة أعماره واسترجاع قدرته الأقتصادية. وكنا نتكلم في تلك الحلقة عن التنمية الأقتصادية والتطور الأقتصادي وكأنهما مصطلحان مترادفان. يستحسن في هذه الحلقة، وقبل المضي قدماً في خارطة الطريق، أيضاح هذين المصطلحين وما هو المراد بهما لكي نزيل أي التباس قد يعتور هذا الموضوع وليصبح القارئ الكريم على بينة من هذا الأمر، وذلك باستدعاء نبذة يسيرة من تأريخ التطور الأقتصادي الحديث.
تطور الغرب الاقتصادي
إن التطور الاقتصادي الذي حصل للدول المحيطة بالحوض الشمالي للمحيط الأطلسي ـ وهي أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ـ لم يحدث بمدة قصيرة وإنما بدأ منذ نحو خمسمائة سنة. ولم يحصل ذلك التطور نتيجة خطط تنموية واعية، كالخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية التي مشت عليها العديد من الدول النامية منذ منتصف القرن الماضي ولا يزال العديد منها مستمر حتى الآن، وإنما حصل نتيجة نشوء النظام الرأسمالي والذي بدأ في إنجلترا أولاً.
إنّ من أهم خصائص النظام الرأسمالي هو توفير الفائض من الأموال التي تزيد عن حاجات الاستهلاك وإعادة استثمار ذلك الفائض لتوسيع قاعدة الإنتاج. إن تلك الاستثمارات، وبمرور الزمن، أدّت إلى تراكمات كبيرة في رؤوس الأموال المنتجة وإلى خلق ثروات طائلة. لقد ساعدت التراكمات المستمرة لرأس المال والثروات الناتجة عنها إنجلترا على تحويل الأفكار العلمية النظرية إلى حيّز التطبيق وقيام الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر واتخاذ نظام المصنع كصيغة متطورة لنمط الإنتاج(2). ولقد ساعدت الثورة الصناعية، بدورها، على تسريع تراكمات رؤوس الأموال ونشوء قواعد صناعية عريضة ومتطورة في تلك البلدان تولدت عنها ثروات رأسمالية طائلة أعيد استثمارها لتوسيع القواعد الصناعية وتطويرها، وهكذا تكاملت حلقة التطور واستمرت.
إن التطور الصناعي للغرب خلال الخمسمائة سنة الماضية قد صاحبه تطور علمي مشى معه يداً بيد. فحينما كانت رؤوس الأموال المنتجة تتراكم وتنتقل من جيل إلى جيل كانت المعرفة أيضاً تتراكم وتنتقل من جيل إلى جيل. فالعلوم كانت تتطور وتترجم إلى تكنولوجيا تطبيقية تستند إليها وسائل الإنتاج. إن تطور التكنولوجيا يستند إلى تطور العلوم، وتطور وسائل الإنتاج يستند إلى تطور التكنولوجيا. إن تطور وسائل الإنتاج يحسّن الكفاءة الإنتاجية، فهو يزيد الإنتاج أو يقلل الكلفة أو كليهما معاً، وهو بالتالي يقود إلى زيادة بالأرباح ومزيد من فائض رأس المال. ولم يكن يستثمر جميع الفائض من رأس المال في وسائل الإنتاج فقط، إذ كان يستثمر جزء منه في البحث العلمي وتطوير العلوم والتكنولوجيا، وبالتالي تطوير وسائل الإنتاج التي بدورها، تقود إلى مزيد من الأرباح. وهكذا تكاملت حلقة تطور أخرى. ولم يشمل التطور وسائل الإنتاج والعلوم والتكنولوجيا فقط، وإنما نمت وتطورت معها أفكار المجتمع ونظرته إلى العمل وأساليب الإنتاج. وفوق هذا وذاك كانت تبرز إلى الوجود وتتطور على مرّ الزمن مؤسسات تطلبتها طبيعة الإنتاج وحاجات المجتمع كالبنوك وأسواق رأس المال وغرف التجارة والصناعة والنقابات والاتحادات المهنية وأنواع متعددة أخرى من المراكز والجمعيات.
لقد عملت تلك المؤسسات – وهي جزء من مؤسسات المجتمع المدني- على توفير الخدمات وتطوير أساليب الإنتاج والإدارة وحماية العمال وأرباب العمل والمستهلكين. كما أصبحت تلك المؤسسات وجهاً من أوجه تعددية المجتمع، لها وزنها المهم وصوتها المسموع، فساهمت في تطوير عملية المشاركة في الحكم، وحدّت من هيمنة الدولة. كما ساهمت في تطوير وحماية حقوق المواطنين بما فيهم المستهلكين والمنتجين.
توسع التجارة الخارجية
ومنذ نهاية القرن الخامس عشر اتجه الأوربيون أيضاً بجهودهم إلى الخارج فاكتشفوا الأمريكتين والطرق البحرية إلى الهند وشرقي آسيا. وأدّت تلك الاكتشافات إلى توسّع كبير في التجارة الخارجية ساهمت بدورها في التطور الاقتصادي لأوربا الغربية.
لقد استعمر الأوربيون، لفترات متفاوتة، أمريكا وأفريقيا والعديد من مناطق آسيا، حيث أضحت تلك المستعمرات مصدراً جيداً للعمالة البخسة والخامات الرخيصة من ناحية، وسوقاً لتصريف البضائع المصنعة من ناحية أخرى. إن تلك العلاقات التجارية وما ترتب على أثرها من سيطرة استعمارية قد ساهمت على مرّ القرون بنقل ثروات طائلة جداً من المناطق المستعمرة إلى أوربا الغربية فأدّت إلى إثراء الأخيرة على حساب الأولى.
وعندما أطلّ القرن العشرون وجد العالم نفسه مقسماً إلى مناطق قوية وغنية ومتطورة اقتصادياً وهي أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ومناطق فقيرة متخلفة اقتصادياً يقع أغلبها تحت النفوذ الاستعماري، وهي قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
الدول النامية والدول المتطورة
بعد الانحسار التدريجي للسيطرة الاستعمارية إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت تظهر إلى الوجود دول نالت اسـتقلالها السياسي حديثاً من الدول الاستعمارية، وقـد تركزت معظم تلك الدول في آسـيا وأفريقيا. وقد سُمّيت تلك الدول، مع دول أمريكا اللاتينية ومجموعة أخرى من الدول، نالت استقلالها السياسي سابقاً، تارة بالدول المتخلفة (Backward)، وتارة أخرى بالدول الأقل تطوراً (Less – Develped)، وقد استقرت التسمية أخيراً على مصطلح الدول النامية (Developing Countries).
وربما كان من الأحرى أن يطلق على هذه الدول مصطلح (الدول في حالة التطور) بدلاً من الدول النامية لأن التطور (Development) يختلف عن النمو (Growth)، ذلك أن التطور أشمل من النمو، والنمو هو جزئ من التطور، كما سنرى. غير أن هذا المصطلح قد شاع استعماله باللغة العربية ونحن بدورنا سنستعمل في هذا المقال مصطلح الدول النامية كما هو شائع. وسنستعمل كلمة “التنمية” وكأنها مرادفة لكلمة “التطوير” فنقول، مثلاً: خطط التنمية وهذه خطط لتطوير البلدان النامية وليس لتحقيق نموها فقط. وإذا قصدنا، في أمكنة مختلفة من هذا المقال، بكلمة النمو معناها الحقيقي وهو أضيق من معنى كلمة التطور فإن ذلك سيتجلى إلى القارئ الكريم من سياق الكلام.
لقد استعمل اقتصاد التنمية حصة الفرد من الناتج القومي الإجمالي(3) كمعيار رئيسي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي للتمييز بين الدول النامية والدول المتطورة. غير أن هذا المعيار لم يكن كافياً لوحده ليميز، في بعض الحالات، بين دولة نامية وأخرى متطورة. ولنأخذ مثلاً على ذلك إيطاليا في سنة 1964 وفنزويلا بنفس السنة. فحيث كانت حصة الفرد الإيطالي من الناتج القومي الإجمالي تعادل 714 دولار كانت حصة الفرد الفنزويلي تعادل 772 دولار. ولكن، مع ذلك، اعتُبرت إيطاليا دولة متطورة في حين اعتُبرت فنزويلا دولة نامية.
إنّ هذا التضارب بين المعيار المستعمل وحقيقة تطور البلد قد اشتد إثر انفجار أسعار النفط في سنة 1973 وحصول بعض الأقطار المصدّرة للنفط، كالكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، على مدخولات نفطية عالية جداً، الأمر الذي وضعها في مصاف أكثر الدول تقدّماً، إن أُخذ النمو لوحده كمعيار للتطور. فحصة الفرد من الناتج القومي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية كان 7200 دولار في سنة 1975 في حين بلغت حصة الفرد في الإمارات العربية المتحدة من الناتج القومي الإجمالي أكثر من 14,000 دولار في نفس تلك السنة(4). فهل كانت الإمارات ستعتبر دولة متطورة لمجرد ارتفاع الدخل الفردي فيها؟ الجواب سيكون بالنفي طبعاً والسبب واضح، ذلك أنّ مساهمة الصادرات الكلية في تكوين الناتج القومي الإجمالي الإماراتي لسنة1975 بلغت 79 بالمائة وأن 94 بالمائة من تلك الصادرات كانت نفطية وأن الاقتصاد الإماراتي في ذلك الوقت لربما كان سينكفئ إلى مستوى الكفاف بحالة غياب النفط! إن هذا الأمرانطبق في ذلك الوقت أيضاً على المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ولا يزال ينطبق على ليبيا. من أجل هذا يصبح لزاماً علينا أن نميز بين النمو والتطور لكي نزيل دواعي الالتباس.
معنى التطور الاقتصادي
إن عبارة «التطور الاقتصادي» بحد ذاتها لا تعبر عن مفهوم واضح جداً. ومن أجل تحديد صورة تقريبية لهذا المفهوم نحاول هنا توضيح الفرق بين «التطور الاقتصادي» و«النمو الاقتصادي» عبر تشبيه الاقتصاد القومي بجسم الإنسان. فالنمو في جسم الإنسان يعني زيادة في الطول أو الوزن (أو زيادة حصة الفرد من الناتج القومي في حالة النمو الأقتصادي) في حين أن التطور يعني التقدم الوظيفي في القدرات المختلفة لجسم الإنسان (أو تطور الاقتصاد القومي في حالة التطور الأقتصادي)(5). فبينما النمو الاقتصادي يعني زيادة في الإنتاج، كما يدلّ عليه هذا التشبيه، فإنّ التطور الاقتصادي يعني أكثر من ذلك بكثير. إنه يتضمن، إضافة إلى ذلك، تغيّرات بنيوية ومؤسساتية!.
ثم يأتي البنك الدولي في تقريره السنوي عن التطور العالمي(6) لسنة 1991 ليجعل الحياة الأفضل للإنسان هي الغاية الأساسية من التطور الاقتصادي وأن الحرية الفردية هي جزء من هذا التطور فيقول: إن التحدي الذي يفرضه التطور، في أوسع معانيه، هو تحسين نوعية الحياة. إن نوعية من الحياة أفضل، خصوصاً في بلدان العالم الفقيرة، تستدعي دخلاً أعلى، ولكنها تشتمل على أكثر من ذلك بكثير. فهي تشتمل، كغايات في حدّ ذاتها، على مستويات أعلى من الصحة والتغذية، فقر أقل، بيئة أنقى، تكافئ فرص أكبر، حريّات فردية أوسع، وحياة ثقافية أغنى.
فعملية التطور الاقتصادي، بناءاً على هذا التوسع في التعريف، يصاحبها تغييرات بنيوية في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي أساليب الإنتاج. وينتج عن تلك التغييرات توسع مستمر في الناتج القومي وحصة الفرد من الناتج القومي مع عدالة في التوزيع. إن كل ذلك يقود إلى تحسن راسخ، مستمر وغير مؤقت، في المستوى المعاشي للمواطنين. كما يصاحب عملية التطور الاقتصادي تغيّر جذري في نظرة المواطنين إلى العمل والإنتاج، وتحسن مستمر في مستويات التغذية والصحة والتعليم. إن كل ذلك يتطلب ضرورة مشاركة الناس، بتنظيماتهم ومؤسساتهم على تعددها وتنوعها، في عمليات التخطيط والاختيار والتنفيذ، فالإنسان هو المقصد النهائي من عملية التطور الاقتصادي. إن مشاركة التنظيمات والمؤسسات في التخطيط، وإعطائها دوراً في الاختيار والتنفيذ يتعارض مع مركزية الحكم واستبداد الدولة، لذلك فإن عملية التطور الاقتصادي تحتاج إلى قدر من التعددية والمشاركة واللامركزية وتوفر الحريات بما تمليها الحقوق الأساسية للإنسان.
لابد من التصنيع
لا توجد استراتيجية محددة يتبعها بلد ما لتحقيق عملية التطور الاقتصادي. فالبلدان النامية، بعد الحرب العالمية الثانية، وجدت أن القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها عملية التطور الاقتصادي هي تحقيق النمو الاقتصادي المستمر، أي تحقيق نسبة زيادة سنوية مستمرة في الناتج القومي الإجمالي، أو الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز نسبة الزيادة السنوية بالسكان، وبذلك يزداد الدخل الفردي ويرتفع المستوى المعاشي. ومن هذه القاعدة تنطلق عملية التطور الاقتصادي، بتخطيط من الدولة ومشاركة من الشعب، لتحقيق الغايات المختلفة التي تنشدها هذه العملية.
فالقاعدة الأساسية إذن التي ينطلق منها التطور الاقتصادي هي القضاء على الفقر وتحقيق نمو مستمر في الدخل الفردي. ولم تكن هناك وصفة جاهزة لتحقيق نمو اقتصادي منشود وإنما اتُّبعت سياسات فشل بعضها ونجح البعض الآخر. وقد تفاوت أثر تلك السياسات من بلد لآخر، فحيث نجحت سياسة معينة في بلد معين، لم تحقق تلك السياسة نفس المستوى من النجاح في بلد آخر، وربما فشلت فشلاً ذريعاً. وبصورة عامة توجهت أغلب الدول النامية في بادئ الأمر، وكان ذلك في بداية النصف الثاني من القرن الماضي، نحو التصنيع بواسطة إحلال الواردات (Import Substuting Industrialisation).
إن الفكرة العامة لهذه السياسة هي أن الصناعات الناشئة ستنتج سلعاً صناعية كان يتم استيرادها من الخارج. كذلك ستقوم بعض هذه الصناعات الناشئة بتصنيع المواد الأولية المتوفرة محلياً. والنتيجة ستؤدي إلى تنوّع في الإنتاج الاقتصادي، وقلّة في الاعتماد على واردات المواد المصنعة وصادرات المواد الأولية. وعندما يتحسن دخل المواطنين، خصوصاً أولئك العاملين في الصناعة والزراعة، تظهر أسواق جديـدة تتطور معها الصناعات الناشـئة من حيث الحجم والكفاءة وتـبدأ بتحقيق وفورات الحجم (Economies of Scale) التي ستساعد، بدورها، هذه الصناعات على تحقيق الأرباح والقدرة على المنافسة. وفي النهاية ستقوم هذه الصناعات بخلق تشابكات خلفية (Backward Linkages)من شأنها أن تحفز على قيام صناعات جديدة لتلبية حاجات الصناعات القائمة، وبالتالي ستقوم بإنتاج المعادن الأساسية والسلع الرأسمالية، كمكائن الخراطة وما شابه ذلك من العدد والمكائن الرأسمالية.
لقد كانت سياسة التصنيع بإحلال الواردات أوسع سياسات التنمية انتشاراً في البداية، وقد جربتها ـ بدرجات متفاوتة ـ كافة البلدان النامية تقريباً. وقد صُمِّمت هذه السياسة لتحويل البلدان المصدرة للمواد الأولية إلى بلدان صناعية. إلاّ أنّها أثبتت فشلها في العديد من البلدان، وخصوصاً البلدان الصغيرة المتميزة بصغر أسواقها، وكذلك البلدان التي هيمن فيها القطاع العام على تلك الصناعات حيث تعشش الأدارة والعمالة غير الكفوءة ما يؤدي الى قيام صناعات خاسرة ذات أنتاج عالي الكلفة ومتدني الجودة لا يمكنها الأستمرار بدون حماية ودعم مالي من خزينة الدولة، فهي لا تقوى على المنافسة. وهذا ما حدث للصناعات العراقية في ظل القطاع العام.
كان يُظن في البدايات الأولى للتنمية الأقتصادية إن الاندماج مع الاقتصاد العالمي من خلال التجارة الخارجية سيزعزع عملية التنمية. ولذلك أتجه قادة الدول النامية في بادئ الأمر نحو سياسة التصنيع من خلال إحلال الواردات. ونتيجة لذلك التوجه تكرّست السياسات الحمائية في الواردات وتقلصت التجارة الخارجية لتلك البلدان. بدلاً عن تلك السياسة اتجهت العديد من البلدان الى تبني سياسة النمو بقيادة الصادرات المصنعة (Manufactured-Export-Led-Growrh). إن الفكرة التي تقوم عليها هذه السياسة هي إنشاء صناعات من أجل التصدير، وقد ثبت نجاحها في العديد من البلدان وخصوصاً في شرقي آسيا. إن مزيتها على سياسة التصنيع بإحلال الواردات هي أولاً: إنها تولد العملات الصعبة للبلد (كما تولدها صادرات الموارد الأولية كالنفط) من غير التضحية بهدف التصنيع، فالاثنين يحدثان معاً، وثانياً: إن هذه الصناعات، لكي تنجح، لا بد لها من تخفيض كلفة الإنتاج حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق الخارجية. لذلك تغلبت هذه الصناعات على المشاكل التقليدية التي تواجهها صناعات إحلال الواردات كالعمالة الفائضة، السعات التشغيلية العاطلة، والخسائر الناجمة عن التشغيل. يضاف إلى ذلك فإنّ هذه الصناعات تتمتع بأسواق عالمية كبيرة بخلاف الأسواق المحلية الضيقة التي تواجهها صناعات إحلال الواردات، كما هي أسواق العراق مثلاً.
والزراعة أيضاً
عندما بدأت الدول النامية تحقق استقلالها السياسي كان الهم الأكبر الذي يسيطر على قادة تلك الدول هو تحقيق التطور الاقتصادي جنباً إلى جنب مع تطور البلاد السياسي. وقد كان الفكر السائد آنذاك هو أنّ الاعتماد على الاقتصاد الزراعي هو سبب من أسباب التخلف ولا بد من الاتجاه نحو التصنيع لتحقيق النمو الاقتصادي. وكان ذلك الفكر ينبع من عنصرين أحدهما سايكولوجي والآخر واقعي. فالعنصر السايكولوجي: هو ارتباط الزراعة بالعهود الاستعمارية وهيمنتها على اقتصاديات البلدان المستعمَرة. والعنصر الواقعي: هو تخلف الزراعة الفعلي في تلك البلدان والاعتقاد آنذاك بعدم جدوى الاعتماد على القطاع الزراعي كمحرك لقيادة عملية التنمية ولا بد من التوجه نحو التصنيع.
على أن النظرة الآن للزراعة قد تغيرت تماماً. ففيما كان التوجه نحو الصناعة في بادئ الأمر يعني إهمال الزراعة، أصبح التوجه نحو التطور الصناعي يصاحبه توجه نحو التطور الزراعي إن لم يكن يسبقه. فإضافة الى تعزيز أمن البلد الغذائي بواسطة بناء قطاع زراعي نَشِط ومزدهر، أدركت العديد من الدول النامية أن فشل القطاع الزراعي أو بقاءه متخلفاً يعني ضيق السوق المحلية وضعف الطلب على المنتجات المصنّعة. وحتى في تلك الدول التي اتجهت في التصنيع نحو الأسواق الخارجية فإنّ جزءاً مهماً من الطلب على منتجاتها يأتي من السوق المحلية(7). فبالإضافة إلى أنّ الصناعة تعتمد بشدة على سكان الريف في طلب منتجاتها، فإنها تعتمد أيضاً على المنتجات الزراعية من أجل تصنيعها، وعلى الصادرات الزراعية من أجل توليد العملات الصعبة والاستثمار لبناء مصانع جديدة، وعلى القطاع الزراعي من أجل تزويد المصانع بالأيدي العاملة.
الأعتماد الحذر على آلية السوق
كان يظن في المراحل الأولى من عملية التنمية إن الأسواق سوف لن تتمكن من تأدية عملها كما هو مطلوب، وكان لا بد من تدخل الدولة لتوجيه عملية التنمية. غير أن الأفكار حول تحقيق التطور شاهدت تغيّراً مستمراً بمرور الزمن. وكان التغيّر في السياسات ينشأ نتيجة لفشل أو نجاح التجارب التي كانت تمرّ بها البلدان النامية. وتبلورت بعد خمسين سنة من التجارب مبادئ أصبحت تلاقي قبولاً عاماً من جميع المهتمين بشؤون التطور الاقتصادي وإن لم ينشأ اتفاق عام – وربما لا يمكن أن ينشأ – عمّا يمكن الأخذ به لتحقيق التطور الاقتصادي لبلد ما من البلدان النامية. فلم يـعـد التركـيز على تكوين رأس الـمـال مقتصراً على العنصر الـمـادي منه، بل أصبح الاهتمام يـتـجـه بصورة متزايدة نـحـو تكوين رأس الـمـال البـشـري (Human Capital Formation) حتى أصبح معلوماً الآن أن رأس المال البشري هو من أهم العوامل التي تقود عملية التطور الاقتصادي إن لم يكن أهمها(8).
أما التجارة الخارجية فقد تبدلت النظرة لها هي الأخرى. فالتوجه في التصنيع نحو إحلال الواردات قلص التجارة الخارجية وساعد على نشوء صناعات داخل البلدان النامية عالية الكلفة لا تقوى على المنافسة الخارجية ولا يمكنها العيش بدون الحماية الحكومية. وقد أدركت العديد من الدول النامية، وخصوصاً دول شرقي آسيا، خطل هذه السياسة فانفتحت على الاقتصاد العالمي والتجارة الخارجية. وقد ساعدت التجارة الخارجية ـ إضافة إلى مساهمتها في نقل التكنولوجيا ـ في نشوء صناعات عالية الكفاءة في تلك البلدان، قليلة الكلفة وقادرة على المنافسة العالمية.
وأخيراً فإن الدول النامية أدركت أنّ تدخل الدولة في السوق، وخصوصاً في عملية الإنتاج، يعرقل عملية النمو الاقتصادي، وأن الأسواق التنافسية تحت إدارة القطاع الخاص هي أفضل وسيلة لتنظيم عملية الإنتاج وتوزيع السلع والخدمات. وعلى الدولة أن تبتعد عن دور «اللاعب» وتتخذ دور «الحكم» وأن تتدخل حيث تفشل السوق، كما هي الحالة في ضرورة تبنّي الدولة عمليات الاستثمار في البنية التحتية المادية والبشرية إضافة، الى تأمين الضمان الأجتماعي للعاطلين والعاجزين عن العمل. هذا من حيث الاستثمار، أما من حيث الرقابة فإن الدولة يجب أن لا تتراخى في أداء واجبها بهذا المضمار. ذلك أن السوق، ولأسباب عدة ومنها الجشع، قد تنحرف في الأداء في قطاع مُعيّن من الاقتصاد، بغياب الرقابة المحكمة من قبل الدولة، فيتعرض ذلك القطاع وبمعية القطاعات الأخرى المتشابكة معه إلى الأذى الكبير، وربما الانهيار، تماماً كما حدث في العام 2008 في أسواق المال في الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الأخرى المتشابكة معها في أنحاء العالم، ما عصف بالاقتصاد الأمريكي – وكذلك العالمي – لينتهي بكساد شديد، لم ير العالم مثل شدته منذ الكساد العظيم (Great Depression) الذي حدث في بداية ثلاثينات القرن الماضي.
(1) هذا المقال مقتبس – مع أجراء بعض الحسابات والتحوير – من كتاب الدكتور محمد علي زيني “الأقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل”، الطبعة الثالثة 2010. يمكن تنزيل الكتاب كاملاً من الموقع:
HYPERLINK “http://www.muhammadalizainy.com” www.muhammadalizainy.com
(2) Dillard, Dudley, 1967, Economic Development of the North Atlantic Community: Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, Inc., p.8
(3) الناتج القومي الإجمالي (Gross Ntional Product): هو قيمة السوق لجميع السلع والخدمات النهائية التي ينتجها اقتصاد البلد في الداخل والخارج خلال سنة واحدة. وحصة الفرد من الناتج القومي الإجمالي (Per Capita GNP) تنتج عن حاصل قسمة الناتج القومي الإجمالي على عدد السكان. على أن هناك العديد من الدول النامية، ومنها العراق، لا تنتج شيئاً مهماً من السلع والخدمات في الخارج فيصبح الناتج المحلي الأجمالي (GDP) مساوياً تقريباً للناتج القومي الأجمالي (GNP)، ولذلك نستعمل في حالة العراق الناتج المحلي الأجمالي بدلاً من الناتج القومي الإجمالي – الذي لاتتوفر إحصائياته في غالب الأحيان – كمؤشر عن حجم الأقتصاد وكذلك الدخل الفردي في حالة قسمته على عدد السكان، وهذا ما فعلناه في الحلقة الأولى.
(4) World bank Atlas, 1978 – 1981
(5) Kindleberger, Charles P., and Herrick, Bruce, 1977, Economic Development, Third Edition: U.S.A., Mc Graw-Hill Book Company, P.3
World Bank, 1991, World Development Report 1991, The Challenge of Development: USA, (6)
Oxford University Press, P.4.
Hamilton, Clive, 1987, Can the rest of Asia emulate the NICs? in Third World Quarterly, Vol.9, No.4, (7)
October 1987: London, Third World Foundation for Social and Economic Studies, p.1236.
(8) إن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة لا ينظر للإنسان كرأس مال، وإنما ينظر إليه كغاية بحد ذاتها، فهو يجعل التنمية البشرية هي المادة الأساسية للتطور، وبدأ يصدر لهذا البرنامج منذ سنة 1990 تقرير سنوي عن حالة التنمية البشرية في العالم
(Human Development Report)
د. محمد علي زيني
«لا يمكن أن تكون هناك حرية فردية حقيقية مع غياب الأمن الأقتصادي»
«جستر باولز»
الحلقة الثالثة
عولمة اقتصادية
لم تتغير النظرة كثيراً إلى ماهية التطور الاقتصادي والعوامل التي تؤثر به والوسائل التي تقود إليه ونحن الآن في مقتبل القرن الواحد والعشرين. فالسياسات والمفاهيم التي مر ذكرها في الحلقة الثانية من هذه السلسلة باقية كما هي. على أنه لابد من الإشارة هنا إلى أن الأبحاث الاقتصادية تكاد تتفق بالإجماع على أن اقتصاد السوق، أي الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص، والذي تتخذ فيه الدولة دور الحكم ـ أي دور أشرافي رقابي ـ هو الأجدى وسيلة لتحقيق التطور الاقتصادي.
كما دلت التجارب على أن الانفتاح على الاقتصاد العالمي والمستند إلى التوسع بالتجارة الخارجية هو من بين أهم العوامل المساعدة في الازدهار الاقتصادي الذي أصبحت تشاهده العديد من البلدان النامية. أن الانفتاح على الاقتصاد العالمي بما يعني خلق قاعدة إنتاجية هدفها الرئيسي التصدير إلى الخارج وفتح السوق المحلية للصادرات الأجنبية سيخلق البيئة المحفزة على الارتقاء في الإنتاج تكنولوجياً وإداريا ودفع الكفاءة الإنتاجية من أجل تحقيق القدرة اللازمة للمنافسة محلياً وعالمياً.
ويمكن تسمية الانفتاح على العالم الخارجي بهذه الصيغة بالعولمة الاقتصادية. ذلك أن العولمة – وهي التشابك والاندماج في أنشطة المجتمعات الإنسانية المختلفة والتي أصبحت تتسارع طردياً مع النمو المستمر في وسائل الاتصالات والمواصلات – لها جوانب أخرى إلى جانبها الاقتصادي منها سياسية واجتماعية وقانونية وبيئية، وإن ما يهمنا منها هنا هو الجانب الاقتصادي(2).
والعولمة موضوع مثير للجدل، وهي ليست كلها نافعة كما هي، أيضاً، ليست كلها ضارة. فهي لها مجالات ايجابية عديدة يمكن التركيز عليها واستغلالها والاستفادة منها، ولها بعض المجالات السلبية التي يمكن تقليص آثارها إلى الحدود الدنيا إن لم يكن ممكناً تفاديها أو التغلب عليها بالكامل. وسيسهل أيضاً مواجهة تحديات العولمة إذا تمت الاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى.
ولا تقتصر العولمة الاقتصادية على الانفتاح الاقتصادي بما هو التوسع في التجارة الخارجية فحسب، وإنما لها قنوات أخرى أهمها الانفتاح الداخلي أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بما فيها الاستثمارات المباشرة (Direct Investments) واستثـمـارات الحافظة (Portfolio Investments). وإذا كانـت الاستثمارات الأخيرة، أي استثمارات الحافظة، تتميز بحساسيتها تجاه الأوضاع الاقتصادية الداخلية وعدم استقرارها، ما يتولد منها أضرار جانبية كما حدث لبلدان شرقي آسيا في سنة 1997، فإن حلولاً يمكن تبنيها وتشريعات يمكن إصدارها لتقييد حركة تلك الاستثمارات والحد من آثارها السلبية بناءً على تجارب البلدان الأخرى سيما تلك التي نجحت في تجنب الأزمات المحتملة من تلك الاستثمارات.
أما الاستثمارات المباشرة، سواء كانت في مجالات الصناعات التحويلية أو الأستخراجية أو الزراعية أو الخدمات المالية والسياحية وغيرها من المجالات، فالبحوث تشير إلى فوائدها بصورة عامة ونتائجها الإيجابية، ليس فقط في زيادة الإنتاج وإنما في نقل التكنولوجيا أيضاً وفي نشر المهارات الفنية والإدارية وتوسيع المنافسة والارتقاء بالإنتاجية وتحسين فرص التصدير ودخول الأسواق الخارجية. أضف إلى ذلك أن العراق، بعد التراجع الرهيب الذي عانته مختلف قطاعاته الاقتصادية نتيجة الحروب والحصار الاقتصادي وفوضى الاحتلال والإرهاب والتخريب وانعدام الأمن واللا استقرار .. الخ، أصبح بأمس الحاجة إلى رؤوس الأموال الأجنبية في أعادة بناء اقتصاده، نظراً لشحة موارده المالية المحلية، وهي شحة قد تدوم لعقدين قادمين من الزمان على الأقل.
الطريق الى التطور الأقتصادي
إن سقوط نظام صدام حسين بالعراق وإحلاله بنظام ديمقراطي تعددي لم تكن غاية نهائية. وإن حل مشكلة الديون وإنجاز إعادة الاعمار هي أيضاً ليست غايات نهائية. إن الغاية النهائية هي تحقيق التطور الاقتصادي وصولاً إلى حياة أفضل للإنسان. إن الحياة الأفضل كما ذكرنا في الحلقة الثانية لا تقتصر فقط على زيادة دخل الفرد داخل البلد وإنما تشمل أموراً أخرى من بينها تعليم جيد، مستوى عالي من الصحة والتغذية، بيئة نظيفة، جريمة قليلة، استقرار أكبر، فقر أقل، فرص متكافئة، حرية فردية أوسع، عدالة اجتماعية أشمل، حياة ثقافية غنية.
صحيح أن التطور الاقتصادي يبدأ بتطوير قاعدة زراعية ـ صناعية واسعة وكفوءة داخل البلد. ولكن قد يُتصور أن تطوير قاعدة زراعية واسعة وكفوءة يعتمد بالدرجة الأولى على قيام الحكومة باتخاذ “الإجراءات اللازمة” لتحديث الأساليب الزراعية واستخدام مستلزمات الإنتاج الزراعي الحديثة من أجل تطوير الزراعة أفقياً وعمودياً. كما قد يُتصور أن تطوير قاعدة صناعية واسعة وكفوءة يعتمد أيضاً بالدرجة الأولى على قيام الحكومة باتخاذ “الإجراءات اللازمة” لإنشاء صناعات محلية، خفيفة وثقيلة، تستند إلى إنجازات العلم والتكنولوجيا الحديثة، من أجل سد الطلب الداخلي والتصدير إلى الخارج.
إن هذا الكلام» التقليدي«، وما يلحقه من تفصيلات، نقرأه عادة في ديباجات الخطط الخمسية والبرامج الاستثمارية وبرامج بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية. لقد اتخذت الحكومة العراقية منذ خمسينات القرن الماضي “الإجراءات اللازمة” ـ كما هي الإجراءات في تصورها ـ وأنفقت في سبيل ذلك آلاف الملايين من الدولارات لبناء القطاعين الزراعي والصناعي، واستغرقت بذلك خمسين سنة، فماذا كانت النتيجة؟ إن النتيجة ـ إذا وضعنا جانباً آثار الحروب ـ هي انتهاء العراق بقاعدة زراعية متخلفة عالية الكلفة، لا تقوى على المنافسة ولا تفي حتى بربع احتياجات البلد الغذائية. وكذلك انتهاء العراق بقاعدة صناعية صغيرة، أغلبها تحت سيطرة الحكومة، رديئة الإنتاج، عالية الكلفة، خاسرة في أغلب الحالات. ولقد تعرضت تلك القاعدة لاندثار مخيف نتيجةً للحصار الأقتصادي وغياب الخدمات ومنافسة غير عادلة من الغير بعد أن فُتحت أبواب العراق على مصراعيها، بعد الأحتلال، لشتى أنواع المنتجات الأجنبية دون دراسة أوتمييز.
لقد برهنت الحكومة العراقية خلال الخمسين سنة الماضية من عمليات التنمية على كونها مُخطِّط فاشل وزراعي فاشل وصناعي فاشل وتاجر فاشل(3). لقد آن الأوان أن تتعلم الحكومة العراقية من تجاربها السابقة، ومن تجارب 50 سنة من الجهود التنموية التي مرت بها دول العالم النامية. ويتعين عليها أن تضع رؤية مستقبلية واضحة للاقتصاد العراقي تتضمن أهدافاً محددة: منها تحقيق درجات معقولة في نمو الناتج المحلي الأجمالي وحصة الفرد منه، وتأمين العدالة المشروعة في توزيع الدخل، وتحقيق المستويات الكمية والنوعية المطلوبة في مجالات التربية والتعليم والصحة، ومعالجة مشاكل السكن والفقر والأمية والبطالة، وتوفير الخدمات بأنواعها ويأتي في مقدمتها الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي، وحماية البيئة بعناصرها الثلاثة: الماء والهواء والتربة. كما يتعين على الحكومة العراقية أن تحدد استراتيجية بعيدة المدى معتمدة نظـام السوق من أجل بناء وتنويع القطاعات الأقتصادية المختلفة وبالأخص الزراعية منها والصناعية لتكوين قاعدة ضريبية لتمويل الميزانية الحكومية ولتنآى بها تدريجياً عن الأعتماد على ما تدرّه الصادرات النفطية، ولخلق حالة من النمو المستدام تستند على دور فاعل للقطاع الخاص، مع قيام الحكومة بتأمين الضمان الاجتماعي للمواطنين ومراعاة ظروف توزيع الدخل واتخاذ دور رقابي فاعل على أنشطة القطاع الخاص منعاً للانحراف والاستغلال المضر بمصالح المواطنين والدولة.
على أننا، بهذا القول، وحتى بعد وضع استراتيجية بعيدة المدى، لا ندعي بأننا نملك هنا مفاتيح عملية التطور الاقتصادي الناجحة، كما لا يمكن لأية جهة كانت، فرداً أو حزباً أو مؤسسة أو حكومة، ادعاء مثل هذا الأمر. فقد اتُّبعت في بادئ الأمر، في جميع الدول النامية، استراتيجيات كان يظن بأنها هي الناجحة، ولكن الزمن برهن على فشلها. كما جُرّبت سياسات نجحت في بلد معين ثم فشلت السياسات نفسها في بلد آخر. وتبقى العوامل الدافعة لعملية النهوض والتطور الاقتصادي غير مفهومة فهماً تاماً.
إن العبرة في سلوك الطريق التنموي الصحيح هي أن لا تجمد الحكومة على »الإجراءات اللازمة« التي اتخذتها سابقاً ففشلت، ثم تكررها مرة أخرى وأخرى. إن العبرة في أن تتراجع الحكومة عن سياسة برهنت فشلها، وتمضي قدماً في سياسة ثبت نجاحها.
إننا، فيما يلي، سنضع تصوراتنا في أطر عامة لما يجب أن يكون عليه دور الحكومة العراقية في عمليات التخطيط والاستثمار والإنتاج والتجارة الخارجية والحكم، وذلك في ضوء التجارب والدروس التي مرت بها عملية التطور الاقتصادي بالعراق، وفي ضوء ما توصل إليه الخبراء العالميون المختصون بعد خمسين سنة من تطبيق سياسات تنموية مختلفة فشل بعضها ونجح البعض الآخر.
وإننا في تصوراتنا هذه سنأخذ الخصوصية العراقية بنظر الاعتبار، ونعتقد ـ مخلصين ـ بأنّ ما ندعو إليه يشكل الاتجاه الصحيح الذي ينبغي على الحكومة العراقية الأخذ به من أجل انتشال العراق من الهوة السحيقة المظلمة التي وقع بها، والنهوض بالشعب العراقي في طريق التطور الاقتصادي وصولاً إلى الحياة الأفضل.
إن العملية الأساسية التي يحتاجها الاقتصاد العراقي لكي يتطور ويبلغ حالة من النمو المستدام هي أولاً القيام بإصلاحات هيكلية (Economic Restructuring) تشتمل على الخطوتين التالين:
أ- تبني اقتصاد السوق :(Market Economy)
منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة، بدأ الاقتصاد العراقي نموه في بيئة يهيمن عليها بصورة رئيسية السوق أو القطاع الخاص. وحتى بعد اكتشاف النفط في 1927 وتزايد العوائد النفطية منذ 1950 التي شجعت على تبني خطط التنمية الأقتصادية، اقتصرت معظم أنشطة الحكومة الاقتصادية على عمليات استخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض (النفط بالدرجة الأولى) وإدارة الصناعات المتعلقة بها. فالقطاعان الرئيسيان، الزراعة والصناعات التحويلية، بقيتا بأيدي القطاع الخاص بصورة كاملة تقريباً، أما الاستثمارات الحكومية فكانت تخصص لتوفير البنية التحتية مثل الطرق والجسور والنقل العام ومشاريع السيطرة على الفيضان والارواء وتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصحة والتعليم.
ولقد استمرت هذه الحالة حتى الثورة في 1958، حيث بدأت بعدها الحكومات العراقية المتعاقبة تستثمر في القطاع الصناعي. وعندما زاد الميل تدريجياً نحو الاقتصاد الاشتراكي، نفّذت الحكومة عمليات التأميم في سنة 1964. ومنذ ذلك الحين هيمن القطاع العام على الاقتصاد العراقي. وغني عن القول أن الاقتصاد الاشتراكي، بخصوص عمليات الإنتاج، فشل في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن العراق، وأصبح الآن ضرورياً تفكيك معظم القطاع العام الفاشل، وفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بمهمة الإنتاج.
إن أهم درس خرجت به تجارب التطور الاقتصادي في مختلف دول العالم النامية هو تحديد العلاقة بين الدولة والسوق، أو بعبارة أخرى بين الحكومة والقطاع الخاص. وهذا الدرس يشير إلى أن عملية التطور الاقتصادي ستحقق النجاح عندما يكون دور الحكومة مكملاً لدور السوق وليس متضارباً معه(4).
ويكون دور الحكومة مكملاً لدور السوق (القطاع الخاص) عندما تتبنى الحكومة سياسة ودية نحو السوق (Market-friendly Approach) فتدع السوق تعمل بحرية حينما تنجح وتتدخل حينما تفشل. ولقد دلت التجارب على أن السوق إذ تنجح نجاحاً باهراً في الأنشطة الإنتاجية فإنها تفشل فشلاً ذريعاً في بناء البنية التحتية )المادية والبشرية( وحماية البيئة وتوفير الصحة العامة وفي كل مجال لا تحقق به أرباحاً مباشرة.
إن هذا الدرس المهم يدعو الحكومة إلى أن تتخذ دور السند والداعم للقطاع الخاص بأن تركز جهودها في توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات وبناء البنية التحتية والعناية بالصحة العامة وحماية البيئة ونشر التعليم وتشجيع البحوث وتمويلها، وكذلك التدخل في شتى المجالات الحيوية الأخرى التي ينحسر فيها نشاط القطاع الخاص، أو أن يكون فيها نشاطه معارضاً لما يتطلبه الصالح العام، إذ يتعين على الحكومة هنا أن تتبنى دوراً رقابياً فاعلاً على أنشطة القطاع الخاص منعاً للأحتكار والأنحراف والاستغلال المضر بمصالح المواطنين والدولة.
ويدعو هذا الدرس، من جهة أخرى، الحكومة أن تبتعد عن الأنشطة الإنتاجية التي هي من صميم اختصاص القطاع الخاص، كإنتاج السلع الالكترونية والأنسجة والاسمنت والأحذية والحديد والصلب وإدارة الفنادق والإنتاج الزراعي، وغير ذلك من الأنشطة التي يحسنها القطاع الخاص ويتفوق بها عندما يتوفر له المناخ الملائم.
ب- تنويع القاعدة الاقتصادية :(Economic Diversification)
إن الاقتصاد العراقي الآن، وكما بينا ذلك دوماً، يعتمد بصورة كبيرة على القطاع النفطي ويتأثر نموه صعوداً ونزولاً بأداء هذا القطاع. أن عملية تنويع القاعدة الاقتصادية تتضمن تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص القطاعات الإنتاجية وتشمل قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية، وكذلك تطوير القطاعات الخدمية والتوزيعية. إن الهدف من تنويع القاعدة الاقتصادية هو التخلص من حالة الاقتصاد الريعي الأحادي الجانب المعتمد على النفط فقط والتحول نحو اقتصاد متنوع تصبح فيه الضريبة هي الأساس في تمويل الميزانية الحكومية وليس الموارد النفطية بصورة رئيسية كما هي عليه الحال في الوقت الحاضر.
إن الأموال الاستثمارية التي سيحتاجها العراق سنوياً، ولمدة عشرين سنة قادمة على الأقل، لتحقيق نموه الاقتصادي المنشود ستكون هائلة بالطبع، كما أشارت لذلك حساباتنا في الحلقة الأولى من هذه السلسلة. وإن النفقات الاستثمارية التي تخصصها الحكومة في ميزانيتها السنوية هي صغيرة جداً قياساً بالاستثمارات الكلية المطلوبة. على أن تلك الأستثمارات الحكومية، وهي تأتي ضمن ميزانيتها السنوية، هي استثمارات على أية حال، سواء في البنية التحتية أو في الصحة والتعليم وحماية البيئة وغيرها من استثمارات يتوجب على الحكومة القيام بها. ويبقى الجزء الأعظم من الاستثمارات المطلوبة لابد له أن يتوفر، ولكن كيف؟ هنا يدخل القطاع الخاص ودوره المنشود في عملية الاستثمار. إن القطاع الخاص داخل العراق ضعيف ولا يمكنه المشاركة إلا في جزئ يسير من الاستثمارات الكلية الكبيرة التي سيحتاج لها العراق سنوياً. ولا بد، والحالة هذه، التوجه نحو الأموال الهائلة في الخارج والتي تبحث عن فرص استثمارية مناسبة في أقطار العالم المختلفة.
إن هذا النوع من الاستثمار هو ما ندعوه بالاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct) (Investment وهو معين لا ينضب إن توفرت له البيئة المؤاتية. إن الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى البلد لن تجلب الأموال فقط، وإنما تجلب معها التكنولوجيا المتقدمة وأساليب الإدارة الحديثة وتحسين فُرص التصدير الى الخارج. ومن أجل تشجيع مثل هذه الاستثمارات خلال العقود المهمة القادمة، لابد من توفير الشروط الضرورية لخلق بيئة مؤاتية لتحتضن تلك الاستثمارات، وسنتكلم عن هذه الشروط عند الكلام عن البيئة المؤاتية لعمل السوق في حلقة قادمة.
(1) هذا المقال مقتبس – مع أجراء بعض الحسابات والتحوير – من كتاب الدكتور محمد علي زيني “ا لأقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل”، الطبعة الثالثة 2010. يمكن تنزيل الكتاب كاملاً من الموقع:
HYPERLINK “http://www.muhammadalizainy.com” www.muhammadalizainy.com
(2) من أجل الإطلاع أكثر على موضوع العولمة وبعض الآراء حولها وتجارب بعض البلدان معها أنظر: العولمة وإدارة الاقتصاديات الوطنية، تشرين الثاني (نوفمبر) 2000، تحرير د.علي توفيق الصادق ود.علي أحمد البلبل: صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الأمارات العربية المتحدة.
(3) إنّ هذا الكلام وما سيليه ينطبق على العديد من تجارب الدول النامية ومن بينها معظم الدول العربية.
(4) من أجل الإطلاع على تفاصيل الأفكار والآراء المستخلصة من تجارب التطور الاقتصادي العالمي أنظر:
World Bank, 1991, World Development Report, 1991, “The Challenge of Development”:
USA, Oxford University Press.
«لا يمكن أن تكون هناك حرية فردية حقيقية مع غياب الأمن الأقتصادي»
«جستر باولز»
الحلقة الرابعة
لا أمن لا إعمار
إن العراق بحالته الحاضرة، ولمدة عشرين سنة قادمة على الأقل، سيحتاج إلى الاستثمار الخاص المكثف في مختلف قطاعاته الاقتصادية غير النفطية، وبالأخص في قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية، كما ذكرنا في الحلقات السابقة. والاستثمار الخاص هذا لا بد له، على الأعم الأغلب، أن يأتي من الخارج نظراً لحاجة العراق إلى استثمارات هائلة، كما رأينا، وعدم كفاية ما سيتوفر منه في الداخل. على أن رؤوس الأموال الخاصة جبانة بطبيعتها ولا تدخل ساحةً للعمل بها ما لم يستتب فيها الأمن والاستقرار. وعليه لا يمكن تحضير البيئة المؤاتية للاستثمار داخل العراق من أجل إعادة بناء البنية التحتية المهدمة وإنعاش الاقتصاد العراقي وتنميته ما لم يتوفر الجو الأمني الاعتيادي الخالي من العنف والإرهاب والجريمة والتخريب.
إن الأمن هو الأساس القوي والصالح الواجب توفره من أجل أي خطة لأعمار البلاد. ولا بد من توفر الأمان للأرواح والممتلكات حتى يتمكن المتعاقدون من شركات ومستثمرين ومقاولين وأفراد من أداء أعمالهم وتنفيذ مسؤولياتهم ومقاولاتهم على الوجه المطلوب. إن إعادة اعمار العراق يتطلب، أول ما يتطلب، استتباب الأمن في عامة البلاد. ذلك أن الأمن والاستقرار يمثلان الصخرة الأساسية أو الأرضية التحتية الصلبة التي يستند عليها كل بناء، وبانعدام الأمن والاستقرار تنعدم القدرة على تكوين الأرضية اللازمة لبناء البيئة المؤاتية للاستثمار. باختصار، إن أعمال العنف والجريمة والخطف والتخريب هي العدو اللدود والبيئة الطاردة لأنشطة الاستثمار ولكل عمليات التأهيل وإعادة البناء والإعمار.
غير أن الجو الأمني المطلوب لم يتوفر في العراق، خصوصاً خلال الخمس سنوات التي تلت سقوط النظام. فلقد أوقف التدهور الأمني الخطير عمليات البناء والتأهيل والإصلاح، وتوقف المقاولون عن العمل وأحجمت شركات الاستثمار من الدخول إلى العراق لغياب البيئة المؤاتية، كما أَجّلت أغلب الدول المانحة تقديم ما تعهدت به من هبات ومعونات وقروض لحين تحسن الحالة الأمنية، وامتنعت الشركات من القدوم إلى العراق حيث لا أمان للأرواح ولا للممتلكات. وحتى الشركات الأجنبية (وجلها أمريكية) التي تعاقدت مع جهات أمريكية في الفترة الأولى من الاحتلال مثل فيلق الهندسة الخاص بالجيش الأمريكي (USACE) وكذلك الشركات التي تعاقدت مع منظمة المساعدات الأمريكية ((USAID، لتنفيذ برامج المعونة أو المنحة الأمريكية لإعادة البناء، والتي تجاوزت قيمتها 19 مليار دولار، هربت من جو العراق المشحون آنذاك بالإرهاب والجريمة والعنف. ونتج عن ذلك ليس فقط تعثر عمليات إعادة البناء أو توقفها أو توقف أغلبها، وإنما ارتفاع الكلفة أيضاً بين عشرين إلى أربعين بالمائة من الكلفة الكلية للمشاريع، حيث ذهبت أغلب الكلفة الإضافية إلى شركات الحماية الأجنبية. كما نتج عن ذلك أيضاً عدم إكمال المشاريع أو إكمالها ولكن بمواصفات رديئة وبكلفة مضخمة تقل كثيراً عن الكلفة الاعتيادية التي تتطلبها مواصفات المشروع.
ولم يقتصر الأمر على انعدام الاستثمار الأجنبي المباشر وتعثر وتوقف مشاريع البناء وإعادة البناء والتأهيل المدفوعة الكلفة، سواء من قبل العراق أو من جهة المعونة الأمريكية، وإنما، ولأسباب أخرى، شجع ذلك الجو المشحون بالإرهاب والجريمة والعنف غياب المسائلة وقلة الانضباط في دوائر الدولة وفقدان الشعور بالمسؤولية من قبل الموظفين وانتشار الفساد بين الأجهزة الحكومية وكذلك شيوعه بين المقاولين، أجانب ومحليين، وعلى اختلاف طبقاتهم كما أوضحنا ذلك في مقالنا عن الفساد بالعراق(3)، وكل ذلك يعرقل عمليات البناء ومسيرة التنمية الاقتصادية.
هذا وفي حالات خاصة قد تقبل شركة مقاولة العمل داخل العراق في ظل الظروف الحالية، وهي والحالة هذه قد تلجأ على الأغلب لتأجير شركة متخصصة لتوفير الحماية لها. أن هذا الحل لا يعتبر حلاً ناجعاً وشاملاً للمشكلة الأمنية في العراق يقبل به جميع المستثمرين، وإنما هو حل جزئي يقبل به مستثمر معين لأسباب خاصة، كأن يكون ذلك المستثمر شركة نفط تروم استغلال حقل نفطي معين لم يعد يتوفر مثله خارج العراق، ولذلك فهي تقبل التعايش مع هذا الجو ولكن بتشغيل أقل عدد ممكن من موظفيها داخل العراق، مع إضافة كُلف الحماية التي تتحملها، مع أي كُلف أخرى ناتجة عن الحالة الأمنية غير الاعتيادية، إلى كلفة المشروع الكلية. على أن هذه حالة خاصة قد يقبل بها المستثمر مضطراً بعد رفع سعره، آخذاً بنظر الاعتبار المخاطر التي سيتعرض لها والكُلف الإضافية التي سيتحملها. ويبقى الوضع الأمني، كما هي الحالة عليه الآن، غير مناسب للسواد الأعظم من المستثمرين وعائقاً كبيراً أمام الاستثمار الأجنبي ما لم تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لمعالجته.
إن مهمة توفير الأمن داخل العراق تقع على عاتق الحكومة العراقية أولاً وأخيراً. ونظراً للظروف الخاصة التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر فإن هذه المشكلة لا تُحل باستعمال القوة فقط. ذلك أن مشكلة الأمن بالعراق لها أبعاد سياسية بالتأكيد، ولا بد لأساليب القوة وأساليب السياسة أن تتضافر فيما بينها لإيجاد الحل الصائب، ولربما يتطلب الأمر أخيراً إجراء مصالحة وطنية حقيقية وصادقة بين جميع الفئات السياسية المتناحرة، وهذا في رأينا هو الحل الأوفر حظاً لاستقرار العراق أمنياً وسياسياً. على أن المصالحة المنشودة هذه برهنت كونها بعيدة المنال رغم أن وزارةً قد أُنشأت خصّيصاً لهذا الغرض، وهي لم تُجدِ نفعاً ولم تُعطِ نتيجة رغم مرور السنين، كما أن مؤتمرات عدة عُقدت لأجراء المصالحة المزعومة ولم تنفع شيئاً.
حتى رئيس مجلس الوزراء – السيد نوري المالكي – أصدر عفواً عاماً شمل نحو ثلاثة آلاف موظف متهم بالفساد كما أعلن القاضي رحيم العكيلي، رئيس هيئة النزاهة، في 27 أيار (مايو) 2009. وقد صرح السيد المالكي كما شاهدناه في إحدى مقابلاته التلفزيونية بأنه أصدر ذلك العفو باعتباره أحد الإجراءات التي تطلبتها المصالحة الوطنية. ونحن بدورنا نستغرب ونتسائل لماذا تتطلب المصالحة الوطنية العفو عن الفاسدين وهم ليسوا خارج الحكومة وأنما بداخلها ومن صلبها؟ وأين هي المصالحة الوطنية، وبين من ومن جرت تلك المصالحة المزعومة، وما هي آثارها، وأين نتائجها، ولماذا تتطلب المصالحة العفو عن الفاسدين والمفسدين وهم ضمن جهاز الدولة ومن موظفيها الكبار على أية حال، وهل الذي جرى هو حقاً مصالحة وطنية أم حالة من حالات التستر على الفساد؟
إن حدسنا هو أن القوى السياسية القابضة بزمام السلطة بالوقت الحاضر كانت، ولا تزال، تستغل مشكلة المصالحة الوطنية – منذ سقوط دكتاتورية صدام ولغاية الوقت الحاظر – كقميص عثمان وفزّاعة للشعب من أجل أقصاء الآخرين والأستحواذ على السلطة لوحدها دون غيرها من فئات الشعب الأخرى. وإذا كان حدسنا هذا صحيحاً، فإن الأستقرار الأمني والسياسي سوف لن يأتي للعراق ولن تأتي معه الأستثمارات العربية والأجنبية، والعراق أصبح بأمس الحاجة لها من أي وقت مضى.
النمو الاقتصادي المستدام
إن الهدف النهائي من إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي هو خلق حالة مُرضية أو مناسبة من النمو الاقتصادي المستدام (Self-sustained Economic Growth) ينمو معها الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بنسبة حقيقية (أي بالأسعار الثابتة) تتفوق على نسبة النمو السكاني السنوي وذلك من أجل إحراز تحسن مستمر في الدخل الفردي وفي مستوى معيشة المواطنين. ومن أجل الوصول إلى الحالة المناسبة من النمو الاقتصادي المستدام، ينبغي استيفاء العديد من الشروط ومنها الأقدام على تنفيذ الخطوات التالية:
(1) التخطيط بالاشتراك مع الشعب
لقد احتكرت الحكومات العراقية عملية التخطيط بالبلد ولم تسمح للشعب بالمشاركة عن طريق مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. واستفحل هذا الأمر في السبعينات بعد تسلط الحزب الواحد على مقاليد الدولة واختلال دور المؤسسات. وأصبحت عملية التخطيط في النصف الثاني من السبعينات سراً من أسرار الدولة، ومُنعت المعلومات بمختلف أنواعها عن الشعب.
إن عمليات التخطيط الاقتصادي وتبني سياسات أقتصادية معينة وتوزيع موارد الدولة على الأنشطة المختلفة هي أخطر العمليات التي يمكن أن تقوم بها الدولة. ذلك أن هذه العمليات تقرر تطور البلد الاقتصادي من عدمه وهي تمس حياة المواطن ومستقبله مباشرة.
إن خطورة هذه العمليات تتطلب الانفتاح على الشعب استلهاماً للأفكار والآراء التي يمكن أن يساهم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات. إن أشراك جميع شرائح المجتمع في التخطيط واتخاذ القرار سيشجع الشعب على الالتزام بالسياسة الاقتصادية المتبناة وتيسير تنفيذها. إن الانغلاق واحتكار القرار من قبل الحكومة هو إهدار لطاقات الشعب الخلاقة وانحباس على قدرات بيروقراطية محدودة، قد تكون خاطئة ومضرة خصوصاً في ظل تسلط الأقلية (Oligarchy)، كما حدث خلال السبعينات، أو في ظل التسلط الفردي، عندما انفرد صدام حسين بالسلطة.
إن العراق، يعاني الآن من شحة في الموارد المالية. إن شحة الموارد المالية تتطلب الحرص عليها وعدم تشتيتها وتأمين استغلالها بكفاءة عالية. إن ذلك لن يتم إلاّ برسم وتنفيذ خطط وسياسات جديدة وملائمة لعملية التنمية في البلد. وإن رسم خطط وسياسات جديدة وملائمة سوف لن يتم، بدوره، إلاّ بانفتاح الحكومة على الشعب ومؤسساته وتأجيج روح النقاش والمناظرة واستلهام الأفكار الفتية الجيدة التي تنبع من هذه العملية.
(2) الشفافية (Transparency)
لقد بدأ النظام العراقي السابق، منذ السبعينات، بحبس المعلومات والبيانات ومنع أفراد الشعب ومؤسساته من الإطلاع عليها وذلك حفاظا على “أمن النظام”، ولا يطلق منها إلى النزر اليسير بعد تنقيحها. ومن المعلومات المهمة التي مُنعت عن الشعب الحسابات القومية، والبيانات المتعلقة بالتجارة، وميزان المدفوعات، والعمالة وبيانات الأسعار، وتخصيصات الميزانيات الاعتيادية والاستثمارية، وتفصيلاتها السنوية ومصروفاتها الفعلية، والإحصاءات المتعلقة بالسكان والحالات الصحية والمعيشية وغير ذلك من المعلومات الحيوية. ولقد بدأ النظام الجديد ممارسة نوع محدود من الانفتاح بعد أن أضرت سياسات العهد السابق بالاقتصاد العراقي ضرراً بليغاً.
إن الشفافية تبدأ بإطلاق المعلومات ونشرها وتوفيرها للمستثمرين والباحثين والمحللين والمؤسسات ذات العلاقة. والشفافية تعني عدم قيام الحكومة بالعمل في الظلام وبمعزل عن رقابة الشعب. إن كل مسؤول حكومي معرض للحساب وكل دائرة حكومية معرضة للحساب من قبل الشعب، وأن ممثلي الشعب المنتخبين لهم الحق في الإطلاع على عمل أية دائرة وأداء أي مسؤول، خصوصاً أولئك المسؤولين عن التصرف بأموال الشعب.
إن الشفافية لوحدها لا تكفي ما لم يصاحب ذلك بحث وتحليل. ويتعين على الحكومة في هذا المضمار تشجيع الباحثين، أفراداً ومؤسسات، لجعل المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الحكومة مادة للبحث والتحليل، حتى يصار لنشر النتائج والتوصيات لتستفيد منها الدوائر الحكومية المعنية والقطاع الخاص. كما يتعين على الحكومة تشجيع الحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات لمناقشة السياسات والخطط الحكومية. إن مشاركة الشعب في المناقشات العلنية للخطط والسياسات سوف لن تجدي نفعاً ما لم يستند الشعب إلى قاعدة معرفية واسعة توفرها المعلومات والبيانات والتحليلات والبحوث والندوات.
أخيراً، إن عملية التنمية، كما هي تعتمد على النشاط الحكومي في مجالات اختصاصها، تعتمد أيضاً على نشاط القطاع الخاص في مجالات اختصاصه. إننا نتوقع للقطاع الخاص اليد الطولى والدور الرئيسي في مجالات الاستثمار والإنتاج في عراق المستقبل. إن نشاط القطاع الخاص سوف لن يحقق النجاح المطلوب بغياب تعاون الحكومة، وإن أحد أوجه التعاون الحكومي هو الانفتاح بالمعلومات الحقيقية الخاصة بالاقتصاد الكلي وحالة السوق حتى يتمكن هذا القطاع من إجراء التحليلات اللازمة واتخاذ القرارات الصحيحة.
(1) هذا المقال مقتبس – مع أجراء بعض الحسابات والتحوير – من كتاب الدكتور محمد علي زيني “ا لأقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل”، الطبعة الثالثة 2010. يمكن تنزيل الكتاب كاملاً من الموقع:
HYPERLINK “http://www.muhammadalizainy.com” www.muhammadalizainy.com
(2) من أجل الإطلاع على العديد من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للوطن العربي، والتي تنطبق على العراق أيضاً أنظر: نشرة الشرق الأوسط الاقتصادية، تموز/آب 1999، العالم العربي، الاستعداد للانتقال إلى عصر جديد من النمو: مجموعة الشرق الأوسط للاستثمار، بيروت، لبنان، ص 8-6.
(3) أنظر “الفساد في العراق”، محمد علي زيني، في الحوار المتمدن:
http://www.ahewar.org/m.asp?i=3340
د. محمد علي زيني
«لا يمكن أن تكون هناك حرية فردية حقيقية مع غياب الأمن الأقتصادي»
«جستر باولز»
الحلقة الخامسة
إن العراق بحالته الحاضرة، ولمدة عشرين سنة قادمة على الأقل، سيحتاج إلى الاستثمار الخاص المكثف في مختلف قطاعاته الاقتصادية غير النفطية، وبالأخص في قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية، كما ذكرنا في الحلقات السابقة. والاستثمار الخاص هذا لا بد له أن يأتي من الخارج نظراً لحاجة العراق إلى استثمارات هائلة، كما أوضحنا سابقاً، وعدم كفاية ما سيتوفر له من الداخل. أن هذا النوع من الأستثمار – وهو ما يسمى بالأستثمار الأجنبي المباشر – سوف لن يدخل العراق ما لم تتوفر له البيئة المؤاتية. أن أول الشروط الواجب توفرها لخلق البيئة المؤاتية هو توفر الأمن والأستقرار داخل البلاد. ذلك أن الأمن والاستقرار يمثلان صخرة الأساس أو الأرضية التحتية الصلبة التي يستند عليها البناء، وبانعدام الأمن والاستقرار تنعدم القدرة على توفير البيئة المؤاتية للاستثمار. أن الهدف المنشود من الأستثمار هو ليس فقط أعادة أعمار البلاد، وإنما يشمل أيضاً – وهذا هو المهم – بناء أقتصاد مزدهر ذو نمو مستدام، وبقطاعات أنتاجية قوية ونشطة، وقاعدة واسعة ومتنوعة تدر على الحكومة ضرائب مختلفة تكون بذاتها هي المموّل الأساسي للميزانية الحكومية كل سنة – وليس النفط.
لقد ذكرنا في الحلقة الماضية – إضافة الى أولوية توفر الأمن والأستقرار داخل البلاد – شرطين آخرين من الشروط الواجب استيفائها من أجل تحقيق حالة مُرضية من النمو الأقتصادي المستدام الذي، هو الآخر، سيعتمد مدى نجاحه على حسن التخطيط وتوفير البيئة المناسبة لاستثمارات القطاع الخاص التي يأتي على رأسها الأستثمار الأجنبى المباشر. ونُضيف في هذه الحلقة لتلك الشروط شرطاً آخراً فائق الأهمية – إن لم يكن أهم الشروط – ألا وهو:
تطوير الموارد البشرية
إن الاستثمار الحكومي الدافع لعملية التطور الاقتصادي هو الاستثمار في البنية التحتية، وهو على نوعين مادي وبشري. فالاستثمار المادي يتمثل في توفير الكهرباء والماء والمواصلات وبناء شبكات الصرف الصحي والطرق والجسور والسدود والخزانات وشبكات الإرواء…الخ. إن الاستثمار في البنية التحتية المادية يشجع الاستثمار الخاص ويقلل من كلفته ويزيد من كفاءته الإنتاجية. فهو، إضافة لمساهمته في تعزيز رفاهية المواطنين وتوفير الحياة الأفضل لهم، يكمل النشاط الاقتصادي الخاص ويدعمه ويساهم بذلك في تنشيط الإنتاج وزيادة الناتج المحلي.
أما الاستثمار البشري، أي تطوير الموارد البشرية، فهو ـ بحق ـ غاية من غايات التطور الاقتصادي باعتبار أن خير الإنسان هو المنشود من هذه العملية، كما أنه عامل أساسي في زيادة الإنتاجية (Productivity) وفي ارتفاع نمو الناتج المحلي. لقد دلت تجارب الخمسة عقود الماضية على أن الاستثمار البشري هو القاعدة الأساسية التي يستند إليها التطور الاقتصادي. ويكفي أن ننظر إلى تجربتي اليابان وكوريا الجنوبية في توسعهما الكبير في برامج التعليم والتدريب ومدى التطور الاقتصادي الذي حققتاه، لكي ندرك أهمية الاستثمار البشري في عملية التطور الاقتصادي.
ويشمل الاستثمار البشري الإنفاق الحكومي على نشر التعليم وتوسيع التدريب الفني وتوفير المياه الصالحة للشرب والعناية بالصحة العامة والاهتمام ببرامج التغذية والتلقيح وتعليم المرأة والتخطيط العائلي. وقد دلّت التجارب على أن مردود الاهتمام بالتعليم الابتدائي والثانوي هو أعلى من مردود الاهتمام بالتعليم العالي، وأن مردود العناية بالصحة العامة هو أعلى من مردود العناية بالصحة العلاجية العالية الكلفة. كما دلت التجارب على أن تعليم المرأة ومساواة فرصها في التعليم مع الرجل يضاعف من أثر التعليم في عملية التطور الاقتصادي.
على أن النظام التعليمي الحالي بالعراق، والذي أُعد أساساً لتخريج موظفين حكوميين، قد عفى عليه الزمن وأصبح لا يتماشى مع متطلبات قطاع خاص ناهض يقود عملية التنمية كما نريد لها في العراق. ذلك أن القطاع الخاص، لكي يتميز بإنتاجية عالية وقدرة على المنافسة الخارجية، في عصر المعلوماتية هذا، سيحتاج إلى عمالة ماهرة ذات معارف واسعة وقدرة على استعمال الكومبيوتر والإلمام باللغة الإنجليزية لاستغلال ما تقدمه الشبكة العالمية (الانترنت) من علوم وتكنولوجيا ومعارف إنتاجية وإمكانيات تسويقية. إن ذلك يتطلب مراجعة عامة للمناهج التعليمية الحالية التي تركز على الحفظ والاستذكار وتطويرها لتنشئة أجيال ذات إمكانيات تحليلية قادرة على البحث عن المعلومات والوصول إليها واستغلالها بما يفيد أصحاب المصالح وأرباب العمل(2).
محنة ذوي الكفاءات
من جانب آخر، يتعين على الدولة خلق مستلزمات الحفاظ داخل البلد على العراقيين من أصحاب الكفاءات والطاقات والمهارات والإمكانيات الخاصة من خلال توفير المناخ المناسب للعمل والإبداع والأبتكار وصيانة الكرامة والشعور «بالوطنية الاقتصادية» إضافة إلى الوطنية السياسية. أن مناخ الرعب والقمع والخوف والإذلال الذي كان يسود العراق في ظل نـظام صدام هو مناخ طارد لذوي الكفاءات والمهارات والقدرات. كما أن مناخ الأغتيالات والإرهاب والعنف وانعدام الطمأنينة كما أصبحت الحال عليه الآن منذ سقوط النظام هو أيضاً مناخ طارد لتلك الشريحة المهمة من الشعب.
إن مغادرة العراق من قبل ذوي الكفاءات والقدرات الخاصة لازالت تجري على قدم وساق حتى الآن، وإن مثل هذا النزيف المخيف والمدمر إقتصادياً سيستمر طالما انعدم الأمن وانتشرت الجريمة واستمر العنف والإرهاب وبقي علماء العراق دون حماية من حكومة أو مظلة من سلطة، تهوى نجوم منهم بين الحين والآخرنتيجة طلقة جبانة من كاتم صوت. وعادة ما يتبع هذه الجريمة النكراء والحدث الجلل أستنكار في جريدة هنا أوحشد تأبيني هناك ثم تُنسى الجريمة النكراء ويبقى القتلة المجرمون، حاملوا كاتم الصوت، يصولون ويجولون في مدن العراق المنكوبة دون رادع يردعهم، وكأن العراق قد خلا من ملايين الشرطة والعساكر وضباطهم بآلافهم المؤلفة وهم جميعاً يثقلون خزينة الدولة بمرتباتهم ومخصصاتهم.
ومحنة المغتربين
وحتى أولئك العلماء المغتربين الذين بدأوا يعودون الى العراق بين الفينة والأخرى بعد سقوط الدكتاتورية، مدفوعين بحبهم الشديد للوطن والتفاني في خدمته، لم يشاهدوا من المسؤولين صدوراً رحبة أو آذاناً صاغية، بل واجهوا شتى العراقيل توضع أمامهم لمنعهم من الألتحاق بخدمة الوطن، وكأن المسؤولين الحاليين الذين تسنموا مقاليد السلطة الحكومية على اختلاف طبقاتها ومستوياتها لا يحسنون للتفاهم مع العلماء العائدين لخدمة الوطن إلا لغة الأنانية والأقصاء.
وشاهدٌ على مايحدث لهؤلاء كاتب هذه السطور حينما حظر بغداد في أواخر سنة 2008 ضمن مجموعة كبيرة من ذوي الكفاءات والأختصاصات النادرة توجهت الى العراق من مختلف أقطار العالم تلبية لدعوة خاصة من مجلس النواب. وفي صبيحة افتتاح ذلك الحشد الكبير في فندق الرشيد حظر عليةُ القوم يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وممثلٌ عن رئيس الجمهورية، وتوالت الخطابات والقصائد الطنانة الرنانة، كلٌ يضع ذوي الكفاءات على الرأس وداخل القلب وفي حدقة العين، وكلٌ يطلب – بل يتوسل – من ذوي الكفاءات الرجوع الى الوطن الحبيب من أجل البناء وأعادة الأعمار والمشاركة بشرف نهضة العراق بشتى الجوانب بما فيها العمرانية والعلمية والفكرية والأقتصادية …ألخ. ولكن ما أن انقضى وقت الأفتتاح وأُطفئت الأنوار المسلطة على المسرح وتوارت كاميرات التلفزيونات الفضائية توارى معها المسؤولون على اختلاف مراكزهم وألوانهم، وكأن واجبات هؤلاء قد انتهت بمجرد ألقاء الكلام الفارغ على المسرح والتطبيل أمام كاميرات التلفزيون بوعود دونكيشوتية سرعان ما تلاشت على موجات الأثير. ولم يتحقق بعد ذلك أي شيئ يستحق الذكر بخصوص تشجيع ذوي الكفاءات وتسهيل عودتهم للمشاركة حقاً في بناء الوطن. لقد كان الأمر كله جعجعة بلا طحين! أو ليست الحال كانت كذلك وما زالت منذ سقوط النظام السابق في نيسان 2003 ولغاية الوقت الحاضر – جعجعة بلا طحين؟
التخطيط العائلي
يشمل الاستثمار البشري أيضاً التخطيط العائلي للسيطرة على النمو السكاني. إن نسبة النمو السكاني إذا كانت عالية ستقود إلى حلقة فقر مغلقة، خصوصاً إذا تجاوزت بحجمها نسبة النمو في الناتج المحلي. ذلك أن الفقر يشجع على التكاثر السكاني العالي وهذا بدوره يؤدي إلى تكريس الفقر وهكذا تكتمل الحلقة، ولا يمكن كسرها إلاّ بتخفيض نسبة النمو السكاني لتصبح أقل من نسبة نمو الناتج المحلي، أو زيادة نسبة نمو الناتج المحلي لتصبح أعلى من نسبة النمو السكاني، أو بكليهما معاً. إن الدول التي خطت خطوات ثابتة في طريق التطور الاقتصادي وحققت مستويات جيدة من التطور هي تلك الدول التي زادت فيها نسبة نمو الناتج المحلي على نسبة النمو السكاني بنحو 2 بالمائة سنوياً كحد أدنى(3).
إن تطوير الموارد البشرية هو ـ كما قلنا ـ غاية بحدّ ذاتها، وهو أيضاً وسيلة لتحقيق التنمية. فالاستثمار في نشر التعليم وتطوير المهارات وتحسين المستوى الصحي هو ـ باختصار ـ من أجل تحضير إنسان صالح جسمياً وعقلياً، قادر على الإنتاج والابتكار. كما أن التخطيط العائلي، والذي يتضمن تثقيف العائلة وتوعيتها للسيطرة على حجم العائلة وبالتالي الحد من التكاثر السكاني، هدفه فسح المجال أمام نمو الناتج المحلي لكي يفوق النمو السكاني، وذلك من أجل تحقيق نمو معقول في الدخل الفردي وبالتالي تحسين المستوى المعاشي للفرد.
على أن سياسة النظام العراقي السابق كانت منافية لسياسة الاستثمار البشري فيما يخص التخطيط العائلي. فذلك النظام ـ على عكس سياسة التخطيط العائلي السليمة ـ كان يشجع التكاثر السكاني ويوفر الحوافز المادية للعائلة الكبيرة. وقد تجاوزت نسبة النمو السكاني في العراق خلال الثمانينات 3.5 بالمائة سنوياً، ولا تزال من أعلى النسب بالعالم. والنظام بهذه السياسة ـ وهي سياسة صدام الشخصية ـ كان يفكر بعقلية بدوية قبلية تعتقد بأنّ القوة تأتي من العدد، وأن البلد ـ طبعاً ـ بحاجة إلى هذه القوة خصوصاً في أوقات الحروب والغزوات. وقد رأينا بعد ذلك ماذا حلّ بالدخل الفردي نتيجة تدهور الناتج المحلي المستمر من جهة، والنمو السكاني بوتيرة عالية جداً من جهة أخرى. فقد باتت شريحة كبيرة من الشعب العراقي تعيش على أقل من دولار واحد باليوم وهو مستوى للمعيشة بلغته أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية قبل مائتي عام.
تشوه الشخصية العراقية
لقد أصاب الاستثمار البشري في ظل النظام السابق نكبتان، نكبة الحرب ونكبة الحكم. فبينما تعرقل الاستثمار البشري خلال حرب الخليج الأولى (الحرب مع أيران) فإنه أصيب بنكبة كبرى خلال حرب الخليج الثانية وما بعدها (الحرب إثر غزو الكويت زائداً الحصار الأقتصادي). ولعل جميعنا يعرف الآن تفاصيل ما حلّ بالإنسان العراقي خلال تلك الحرب وما جرى داخل العراق في ظل الحصار الاقتصادي الذي ضُرب على العراق، ولا نريد أن نكرر هنا تفاصيل المأساة التي حلت بالتغذية وبالصحة العامة(4). أما التعليم الابتدائي والفني فإنّه لا شك قد تعرض لانتكاسة كبرى رغم إلزامية التعليم الابتدائي. ذلك أن التوسع في التعليم يتناسب مع توفر الأموال الاستثمارية لهذا الغرض، وأن مثل هذه الأموال لن تتوفر طالما بقيت الحكومة مفلسة، كما أصبحت عليه الحال في ظل الحصار.
أما النكبة التي أصابت الاستثمار البشري بسبب الحكم الصدامي الرهيب فهي أشمل وأنكى من نكبة الحرب، ذلك أن الأخيرة ستزول آثارها تدريجياً ـ كما نأمل ـ بعد أن زال الحصار، أما الأولى فإنها ستبقى لسنين طويلة بالعراق قد تستغرق جيلاً كاملاً رغم زوال الحصار وسقوط النظام.
وماهيّة نكبة الحكم هو التشوه الخطير الذي أصاب الشخصية العراقية إضافة إلى سياسات النظام الخاطئة. فبينما الغرض الأساسي من الاستثمار البشري هو تنشئة الإنسان السليم جسمياً وعقلياً، القادر على الإنتاج والابتكار، نرى ـ بعكس ذلك ـ إصرار النظام السابق على تنشئة «العراقي الجديد» كما كان يسميه صدام حسين. وهذا «العراقي الجديد» معطوب في بنيته الجسمية والفكرية، مكبل بالأغلال، مهدور الكرامة، مسلوب الإرادة. إن إنساناً في ظل عبودية كهذه وفي ذعر دائم يترسخ عنده شعور قوي بكراهية السلطة، كما تترسخ عنده كراهية الدولة أيضا نتيجة للخلط المضطرب بين السلطة والدولة. وينتج عن هذه الحالة أن ينخفض عنده الشعور بالمواطنة والمسؤولية والانتماء ويفقد الأمل ويعتل جسمه وتنعدم كفاءته وينغلق تفكيره وتتبدد قدراته. إن إنساناً كهذا يكون على طرفي نقيض مع الإنتاج والابتكار والإبداع!
ثم يأتي ـ فوق تشوه الشخصية ـ دور سياسات النظام الاقتصادية الخاطئة لتزيد عملية الإنتاج في العراق دماراً. إن عائد الاستثمار البشري عالي جداً ولكنه ينخفض إذا صاحبته سياسات غير سليمة. ومن بين السياسات الاقتصادية المشوهة، أو غير السليمة، سياسات نقدية ومالية مضطربة، عجز مستديم في الميزانية الحكومية، تضخم عالي، سعر صرف رسمي مرتفع للعملة المحلية من شأنه إعطائها قيمة عالية تجاه العملات الأجنبية (Overvalued Currency). إن السياسة الاقتصادية في العراق أضحت تتسم بكافة الاختلالات المذكورة خلال النظام المقبور.
إرتداد الى النظام القبلي
كذلك من بين السياسات التي كان النظام يتبعها، وذلك من أجل أحكام السيطرة على شرائح الشعب المختلفة، هي الارتداد إلى النظام القبلي المتخلف. فبالإضافة إلى الانعكاسات السلبية الاجتماعية والقانونية لمثل هذا النظام، فإن له انعكاسات سلبية على الاقتصاد أيضاً. ذلك أن النظام القبلي يرسخ مبادئ الأوتوقراطية والتفرد باتخاذ القرار بعيداً عن سلطة القانون والدولة(5) وإن الولاء في ظل هذا النظام يتراجع عن الوطن ليتوجه بصورة رئيسية نحو العشيرة أو القبيلة. وينتج عن ذلك أن تتقدم الصلات القبلية ـ ولربما الصلات الطائفية والعرقية أيضاً التي كان يؤججها النظام العراقي ـ على المؤهلات والجدارة الشخصية المتعلقة بالمهارات والتحصيل العلمي والخبرات المهنية في مليء الوظائف الحكومية وغير الحكومية، كما قد تؤثر تلك الصلات على اتخاذ القرارات والمسائلة في العمل، فيتراجع الإنتاج كماً ونوعاً تبعاً لذلك.
هل تعلم حكام العراق الجدد؟
أن كل ما جاء تحت شرط تطوير الموارد البشرية ما هو إلاّ إخطار جلي وفائق الأهمية إلى حكومات العهد الجديد التي جاءت على أنقاض النظام السابق، مفاده أن السياسات التي تبناها ذلك النظام في تعامله مع موارد العراق البشرية هي سياسات خاطئة وخطرة، فهي مسخت شخصية الفرد العراقي من جهة وتراجعت باقتصاد البلاد إلى الوراء من جهة أخرى. لذلك ينبغي على حكومات العهد الجديد تلافي تلك السياسات والاعتبار بما حدث، وليس تكرارها أو ربما تبني سياسات أسوأ وأخطر منها.
على أن ما جرى منذ سقوط النظام، ويستمر جارياً الآن، وللأسف الشديد، يمثل خيبة أمل كبرى لا يستحقها الشعب العراق المظلوم الذي عانى أشد الويلات لعقود طويلة تحت نظام صدام المقبور. فالأصطفافات الطائفية والأثنية والحزبية والحكم على أساس المحاصصة فيما بينها، كما يجري الآن، هي أكثر سوءاً من الارتداد إلى النظام القبلي المتخلف. فهذه السياسات الخطرة جداً تولد، دون أدنى ريب، انحرافاً في الولاء الواجب توجهه إلى الوطن، ليتحول هذه المرة إلى الطائفة والعرق والحزب والكتلة. والمحاصصة على هذه الشاكلة يستشري في ظلها فساد رهيب يقود الدولة بالنهاية إلى الفشل. وينشأ في ظل دولة فاشلة كهذه(6) شعب مسخ، فاسد، لا يعرف معنىً للمواطنة ولا ولاءاً للوطن.
حتى النظام القبلي الذي تراجع بشدة بعد ثورة تموز 1958، والذي أعاد صدام حسين الحياة له من أجل أحكام السيطرة على فئات الشعب، لازال يترعرع في العراق بصحة وعافية، وقد أعطاه رئيس مجلس الوزراء، السيد المالكي، جرعة منشطة من خلال تكوين مجالس إسناد العشائر وتمويلها، بنفس الوقت، من خزينة الدولة.
(1) هذا المقال مقتبس – مع أجراء بعض الأضافات والتحويرات المناسبة – من كتاب الدكتور محمد علي زيني “ا لأقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل”، الطبعة الثالثة 2010. يمكن تنزيل الكتاب كاملاً من الموقع:
HYPERLINK “http://www.muhammadalizainy.com” www.muhammadalizainy.com
كذلك يمكن الأطلاع على الحلقات السابقة من هذا المقال بالرجوع الى موقع الكاتب في الحوار المتمدن، وهو على الأنترنت بعنوان:
http://www.ahewar.org/m.asp?i=3340
(2) من أجل الأطلاع على العديد من الأصلاحات الأقتصادية المطلوبة للوطن العربي، والتي تنطبق على حالة العراق أيضاً، أنظر: نشرة الشرق الأوسط الأقتصادية، تموز/آب 1999، العالم العربي، الأستعداد للأنتقال الى عصر جديد من النمو: مجموعة الشرق الأوسط للأستثمار، بيروت، لبنان، ص 6 – 8.
(3) أنظر:
Muhammad-Ali Zainy, 2004, “The Iraqi Economy: Present State and Future Challenges”. The Emirates Centre for Strategic Studies and Research, ِAbu Dhabi, UAE.
(4) راجع الفصول الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب المذكور في الهامش رقم (1).
(5) نشرة الشرق الأوسط الاقتصادية، تموز/آب 1999، مصدر سابق.
(6) للدلالة على فشل دولة العراق في الوقت الحاضر أنظر مكانة العراق بين دول العالم في المراجع العالمية التي تُنشر بهذا الشأن ومن بينها دليل التنمية البشرية الذي تُصدّره الأمم المتحدة، علامات مؤشر الفساد لدول العالم الذي يصدر سنوياً عن منظمة الشفافية العالمية، المؤشرات السنوية للأستقرار والنظام والأداء الحكومي التي تصدر عن مؤسسة “بصيرة الأنسانية”، ومن الجدير بالذكر أن آخر مسح للمؤشرات الأخيرة الذي أطّلع عليه الكاتب كان لسنة 2009، وقد حصّلت الحكومة العراقية على درجة صفر من عشرة بخصوص الأداء.
د. محمد علي زيني
«لا يمكن أن تكون هناك حرية فردية حقيقية مع غياب الأمن الأقتصادي»
«جستر باولز»
الحلقة السادسة
إن العراق بحالته الحاضرة، ولمدة عشرين سنة قادمة على الأقل، سيحتاج إلى الاستثمار الخاص المكثف في مختلف قطاعاته الاقتصادية غير النفطية، وبالأخص في قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية، كما ذكرنا ذلك في الحلقات السابقة. والاستثمار الخاص هذا لا بد له أن يأتي من الخارج نظراً لحاجة العراق إلى استثمارات هائلة، كما أوضحنا سابقاً، وعدم كفاية ما سيتوفر له من الداخل. أن هذا النوع من الأستثمار – وهو ما يسمى بالأستثمار الأجنبي المباشر – سوف لن يدخل العراق ما لم تتوفر له البيئة المؤاتية. أن أول الشروط الواجب توفرها لخلق البيئة المؤاتية هو توفر الأمن والأستقرار داخل البلاد. ذلك أن الأمن والاستقرار يمثلان صخرة الأساس أو الأرضية التحتية الصلبة التي يستند عليها البناء، وبانعدام الأمن والاستقرار تنعدم القدرة على توفير البيئة المؤاتية للاستثمار. أن الهدف المنشود من الأستثمار هو ليس فقط أعادة أعمار البلاد، وإنما يشمل أيضاً – وهذا هو المهم – بناء أقتصاد مزدهر ذو نمو مستدام، وبقطاعات أنتاجية قوية ونشطة، وقاعدة واسعة ومتنوعة تدر على الحكومة ضرائب مختلفة تكون بذاتها هي المموّل الأساسي للميزانية الحكومية كل سنة – وليس النفط.
لقد ذكرنا في الحلقتين الماضيتين – إضافة الى ضرورة وأولوية توفر الأمن والأستقرار داخل البلاد – ثلاثة من الشروط الواجب استيفائها من أجل تحقيق حالة مُرضية من النمو الأقتصادي المستدام، وتلك الشروط هي التخطيط بالأشتراك مع الشعب والشفافية وتطوير الموارد البشرية. ونُضيف في هذه الحلقة لتلك الشروط أربعة شروط أُخر، وهي كالآتي:
(1) البيئة المؤاتية لعمل السوق
إن البلدان النامية التي حققت نمواً اقتصادياً جيداً، ومن هذه البلدان كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وهونغ كونغ، هي تلك البلدان التي ارتدّت حكوماتها إلى الوراء وتخلت عن عمليات الإنتاج والتوزيع، لكي يتولاها القطاع الخاص، ثم وفرت البيئة المؤاتية للأسواق لكي تقوم بتنظيم تلك العمليات بكفاءة.
إن أهم عناصر البيئة المؤاتية التي يتحتم على الحكومة توفيرها هو الإطار القانوني لتنظيم عمليات الإنتاج والتوزيع، وتأمين حرية المنافسة في السوق، وتوفير قضاء مستقل للحسم في قضايا المنازعات التجارية وتحديد حقوق الملكية الخاصة وضمان الحماية التامة لها.
لقد أدرك نظام صدام المقبور خطر الاعتماد على القطاع العام في عمليات الإنتاج والتوزيع، وقام في أواخر الثمانينات بعمليات خصخصة جزئية في قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية(2) تم بموجبها نقل ملكيات حكومية زراعية وصناعية إلى القطاع الخاص، كما قام بعمليات خصخصة جزئية أخرى في سنة 1993. غير أن تلك العمليات قد جرت دون أن يرافقها الإطار القانوني المطلوب. وأصبحت عمليات الخصخصة المذكورة مجرد عمليات نقل احتكار الدولة إلى احتكار القطاع الخاص.
ولقد أراد ذلك النظام بعمليات الخصخصة وما رافقها من تسهيلات، دعوة القطاع الخاص – العراقي والعربي – إلى الاستثمار داخل العراق وتولي عملية الإنتاج والتوزيع. غير أن القطاع الخاص، عراقياً وعربياً، لم يأبه لهذه الدعوة وأحجم ـ كما هو متوقع ـ عن القيام بدوره في الاستثمار وتحمل المخاطر في ظل حكم همجي لا يعترف بسلطة القانون.
إذ كيف للقطاع الخاص أن يخاطر بأمواله في بلد يسوده الذعر والخوف وتنعدم فيه الطمأنينة وتُنتزع فيه الملكية بدون حساب؟ ولماذا يأتمن القطاع الخاص حكماً يُلغى في ظله قانون ويُشرّع قانون آخر بمزاج الحاكم؟ وكيف للاستثمارات الخاصة أن تطمئن في بلد تُصادر فيه الحقوق، وحتى الحياة(3) بنزوة من جلف أو وشاية من جلواز؟
إن المهمة الأساسية التي تتحملها الحكومة الحالية والحكومات التي ستأتي في المستقبل، إضافة إلى توفير الأمن الداخلي، هي خلق الاستقرار والثقة اللازمة لتشجيع الاستثمار الخاص. إن ذلك لن يتم إلاّ بإرساء قواعد القانون الذي يحمي، أهم ما يحمي، حقوق الملكية ويؤكد عدم جواز مصادرتها – ناهيك عن صيانة الحياة واحترام قدسيتها – ويخلق بيئة مستقرة ومؤاتية لعمل القطاع الخاص.
إن عملية خلق البيئة المؤاتية للقطاع الخاص تصبح ضرورية ضرورة ماسة في حالة العراق ليس فقط لكون القطاع الخاص هو المحرّك الكفوء لعملية الإنتاج والقادر على المنافسة والابتكار، وإنما لكون القطاع الخاص، إضافة لذلك، مصدراً للثروات الاستثمارية، المحلية والأجنبية، لا يمكن للعراق الاستغناء عنها والتوسع الاقتصادي بدونها في ظروف المرحلة الحالية المتسمة بشحة النفقات الاستثمارية الخاصة بالميزانية الحكومية. وحتى لو تيسر للحكومة العراقية أموال طائلة نتيجة للزيادات المستقبلية في إنتاج النفط، فإن ذلك لن يُغني عن الحاجة للثروات الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. ذلك أن الاستثمار الحكومي، وكما أوضحنا سابقاً، يجب أن يتوجه لإعادة بناء البنية التحتية التي تهدم قسم منها واندثر القسم الآخر، وتوسيعها باستمرار لمواجهة الزيادات الحاصلة في الطلب والناتجة عن النمو السكاني المستمر. إضافة لذلك يجب أن يتوجه الاستثمار الحكومي للصرف على الخدمات العامة بما فيها الصحة والتعليم. وتبقى الحاجة ماسة وبلا انقطاع إلى استثمارات القطاع الخاص العراقي والأجنبي لبناء وتنمية الاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته، وبالأخص قطاع الزراعة وقطاع الصناعات التحويلية المعدة للتصدير. هنا أيضاً ينبغي أن لا ينقطع عون الحكومة المادي للقطاع الخاص بتوفير القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إن وضع العراق المالي في الفترة المقبلة يحتم استقطاب رأس المال الخاص، ليس من داخل العراق فحسب وإنما من خارج العراق أيضاً. إن رأس المال العربي الموجود خارج العراق – بضمنه رأس المال العراقي الخاص والصناديق السيادية العائدة لحكومات مجلس التعاون الخليجي – كبير جداً وتقدر قيمته بنحو ألفي مليار دولار(4).
إن التقدير المذكور يشير إلى وفرة عظيمة في رأس المال العراقي والعربي، المستثمر خارج المنطقة العربية. وبجانب هذه الأموال هنالك وفرة عظيمة في رؤوس الأموال الأجنبية مع ما قد يصاحبها من تكنولوجيا متقدمة وإدارة حديثة. إن هذه الأموال تبحث عن الربح وتنتقل إلى الأماكن التي تتوفر فيها البيئة المؤاتية لعملها. ومن شروط هذه البيئة هي الاستقرار والأمان وحرية الحركة والحماية التي توفرها سلطة القانون. ولا بد أن نذكر هنا أن هذه الأموال تتنافس عليها دول العالم بمختلف أنواعها، وهي بالتالي تختار البلدان التي توفر لها أفضل الشروط المناسبة لها.
كما أن من أهم الشروط التي تشجع رأس المال الأجنبي في الانتقال إلى بلد معين هو توفر الشفافية، وكانت في ظل نظام صدام معدومة في العراق. والشفافية كما يفهمها المستثمرون الأجانب، لا تقتصر فقط على نشر البيانات والإحصائيات الصحيحة والحقيقية كما أوضحنا في الحلقة الرابعة، وإنما تشمل أيضاً أتباع الممارسات والأصول المحاسبية العالمية في الإفصاح عن الأداء المالي للشركات وتطبيق القواعد والأنظمة المتعارف عليها عالمياً. ومن الشروط المهمة الأخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية القضاء على الفساد داخل البلد قدر الإمكان ومنع الممارسات غير السليمة، وتقليص البيروقراطية وقيام الحكومة بدور أشرافي ورقابي نزيه في تنفيذ العقود وحماية الحقوق.
(2) اقتصاد كلي مستقر
إن من أولويات الأهداف الاقتصادية للحكومة الجديدة سيكون تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي (Macroeconomic Stabilization) بما يتضمن السيطرة على التضخم. ذلك أن التضخم، إذا أصبح مفرطاً، كما حدث في العراق بعد فرض الحصار الاقتصادي، يعطل آلية الأسعار ويفقدها مزيتها في التعبير عن الندرة النسبية للسلع والخدمات ويضعف دورها في عملية تخصيص الموارد وتوزيعها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما يلغي وظيفة العملة المحلية كأداة للتداول والادخار. وتنحسر في أجواء التضخم المفرط قدرة الشركات وأصحاب الأعمال على التخطيط للعمل والإنتاج نظراً للأختلالات الخطيرة والمستمرة في الأسعار، إذ يستتبع تلك الأختلالات السعرية صعوبات كبيرة في تنبؤ التكاليف والأرباح. وفي ظل الاضطرابات السعرية والتضخم المفرط تنحسر الرغبة في الاستثمار، خصوصاً في المشاريع طويلة الأجل، وتحجم رؤوس الأموال الأجنبية من الدخول إلى البلد، ويشتد الميل نحو المضاربات واقتناء الأصول الثابتة والذهب والعملات الأجنبية، وبالتالي يصيب عمليات التنمية الاقتصادية الشلل التام(5).
إن الذي يقود إلى التضخم المفرط هو اختلال الميزان الجاري الناتج عن الاعتماد الشديد على الاستيراد مع قلة التصدير وشحة الاستثمارات الأجنبية مما يستتبع ذلك عجز في هذا الميزان مع ندرة في العملات الصعبة. وكذلك يحدث التضخم المفرط عندما تنهار قيمة العملة المحلية، وهذا ما حدث للدينار العراقي في ظل الحصار الاقتصادي.
كذلك ينتج التضخم المفرط عن العجز المستمر في الميزانية الحكومية (Government Budget) ثم سد ذلك العجز بواسطة التوسع في الإصدار النقدي أو طبع النقود، كما جرى في ظل النظام المقبور. لذلك يتوجب على وزارة المالية في ظل حكومات مسؤولة قادمة، إعداد الميزانية السنوية بما لا يسمح بالأنفاق غير المجدي، وتلافي العجز قدر الإمكان. كما يتوجب على البنك المركزي، وهو مفترض به أن يتمتع باستقلالية القرار والتصرف في ظل النظام الجديد، إصدار النقود بالقدر الذي تتطلبه زيادة أنتاج البلد من السلع والخدمات. إن ذلك يعني أن الإصدار النقدي من قبل البنك المركزي سيكون في خدمة ومساندة حالة النمو الفعلي في الاقتصاد، وليس من أجل الخدمة الآنية لما تقتضيه مصالح الحاكم كما كانت عليه الأمور تحت ظل النظام السابق.
وإذا كان ولابد من حدوث عجز في الميزانية الحكومية لا مفر منه في بعض الحالات، يتوجب حينئذ سد ذلك العجز بوسائل حكيمة لا تثير ضغوطاً تضخمية، وأفضل تلك الوسائل الحصول على الأعانات بالطبع. إن أشهر عملية إعانة بالتاريخ حدثت بعد سنتين من انتهاء الحرب العالمية الثانية حين قامت الولايات المتحدة بموجب خطة مارشال (Marshall Plan) بتقديم المعونات المالية إلى بلدان أوربا الغربية لمساعدتها على استعادة قاعدتها الإنتاجية التي دمرتها الحرب(6). وبموجب تلك الخطة استلمت البلدان المستفيدة أقل من 2.5 بالمائة من دخلها كل سنة، وخصص أقل من ثلث الموارد المستلمة فقط للاستثمار المباشر. غير أن الشيء المهم الذي عملته خطة مارشال هو المساعدة على توفير الاستقرار الاقتصادي الكلي لتلك البلدان والسماح لحكوماتها في توفير البيئة الأقتصادية المستقرة لكي يزدهر في ظلها القطاع الخاص(7).
(3) أسواق مالية واسعة
إن التنمية الاقتصادية بما فيها عمليات تأسيس الشركات وتمويل المشاريع الجديدة والتوسع في التصدير والاستيراد تتطلب أسواقاً مالية عميقة ووافية تأتي من خلال تطوير البنوك المحلية والانفتاح على البنوك والبيوتات المالية الأجنبية. إن توسيع الأسواق المالية وتنظيمها داخل البلد يشجع عمليات الادخار المحلي واستغلال المدخرات بكفاءة، كما أن الانفتاح على البنوك الأجنبية يزيد المنافسة ويستقدم رؤوس الأموال الأجنبية من أجل استغلالها محلياً، كل ذلك مواكبةً لحاجات الأستثمار المتزايدة.
ولقد فعلت السلطات المسؤولة حسناً بعد سقوط النظام حينما أصدرت في أيلول (سبتمبر) 2003 قانوناً جديداً للبنوك(8) تم بموجبه إعطاء الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي العراقي، وكذلك السماح لستة بنوك أجنبية خلال السنوات الخمس الأولى، للعمل في العراق بملكية أجنبية تصل إلى %100 مع وضع حد أدنى لرؤوس أموالها، إضافة إلى وضع حد أدنى لرؤوس أموال البنوك العراقية العاملة في البلد. إن الغرض الأساسي من الخطوات الإصلاحية التي اتُخذت لحد الآن بخصوص النظام المالي والمصرفي العراقي هو لاستقطاب الموارد المالية المحلية والأجنبية وحشدها لخدمة النشاط الاقتصادي بما في ذلك تمويل الاستثمارات داخل العراق من أجل التنمية الاقتصادية. على أن هذه الإجراءات لن تكفي طبعاً ولا يزال النشاط المصرفي داخل العراق ضعيف جداً ويئن تحت وطأة أنظمة مالية ومصرفية قديمة وبالية. أن العراق بحاجة ماسة إلى إصلاح مصرفي قوامه إعادة هيكلة البنوك العراقية، الحكومية والخاصة، من أجل تحديثها وتحسين إدارتها والنهوض بكفاءتها لتعمل وتتنافس بنجاح ضمن بيئة مالية حديثة وكفوءة. إضافة لذلك، يتحتم توسيع أسواق البلد المالية من أجل أن تفي تلك الأسواق بمتطلبات النهوض الاقتصادي المنشود حسبما تتطلبه خطة إستراتيجية اقتصادية متكاملة.
(4) إنفتاح على التجارة الخارجية
سيكون التركيز تحت هذا العنوان على التجارة السلعية. أما تجارة الخدمات، كالتأمين والخدمات المصرفية والمقاولات والنقل والبناء والتشييد، فهي تحتاج إلى قدرات تنافسية متقدمة ومهارات خاصة لا تتوفر بكفاية في الوقت الحاضر لدى العراق، كما هي لا تتوفر بكفاية لدى أغلب الدول النامية، عدا بعض الخدمات السياحية، وأن الهيمنة الكبرى في مجال تجارة الخدمات هي في الوقت الحاضر للدول المتطورة اقتصادياً. على أن هذا الأمر يجب أن لا يعيق العراق في أن يبدأ في المجالات التي يتمكن منها، كمجال السياحة بالتأكيد، فهو أهل لها ويحتوي على مقوماتها، على أن يبدأ التدرج باكتساب المهارات اللازمة والتوسع تدريجياً في المجالات الخدمية الأخرى.
عندما بدأت جهود التصنيع في دول الشرق الأوسط، ومنها العراق، كانت استراتيجية التنمية السائدة آنذاك هي استراتيجية إحلال الواردات(Import Substitution) بقيادة القطاع العام، ونشأت نتيجة ذلك صناعات عديدة تتسم بكثافة رأس المال، ولم توفر تلك الصناعات فرص عمل كبيرة للمواطنين. ونظراً لضيق السوق المحلية وضعف الطلب أصبحت الصناعات المذكورة تشتغل بطاقات إنتاجية أقل من سعاتها التصميمية وبكلفة إنتاجية عالية. ومما زاد في كلفة الإنتاج سوء الإدارة الحكومية (البيروقراطية). ونظراً لأنّ منتوجات تلك الصناعات تمتعت بحماية الدولة ضد المنافسة الأجنبية من جهة واحتكارها للسوق من جهة أخرى، فإن الدافع لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتقليل كلفة الإنتاج لم يتوفر. وبتجمع تلك العوامل (أي كثافة رأس مال عالية، إنتاج بطاقة واطئة، جهاز إداري بيروقراطي كبير وغير كفوء، عدد عالي من العمال يصعب تسريحهم لأسباب قانونية وسياسية، دعم حكومي كبير لأسعار البضائع المنتجة، تعريفة جمركيّة عالية على البضائع الأجنبية المنافسة) ترعرعت صناعات خاسرة تحت الهيمنة الحكومية(9). وبعد أن أدركت الحكومات المعنية خطأ السياسات التي اتبعتها اتجهت ـ بسرعات متفاوتة ـ نحو الخصخصة، وهكذا بيعت العديد من الصناعات الحكومية في العراق إلى القطاع الخاص.
إنّ مجرد بيع الصناعات الحكومية إلى القطاع الخاص لا يكفي، إذ يتعين بناء قاعدة إنتاجية واسعة كفوءة وقادرة على المنافسة في الداخل والخارج. إن ذلك يستوجب تحرر الاقتصاد العراقي وانفتاحه على الاقتصاد العالمي. إن التحرر الاقتصادي يستند إلى الفكرة القائلة بأنّ الأسواق الحرة، أو الأسواق التي تتوفر لها حرية العمل، هي أكفأ وأمضى وسيلة لتنظيم الاقتصاد، وأن التدخل الحكومي من خلال السياسات الحمائية، والسيطرة على الأسعار، وسياسات الدعم وغيرها من سياسات التدخل يجب أن تتقلص إلى الحد الأدنى(10). أما الانفتاح على الاقتصاد العالمي فنعني به تخفيض القيود على التجارة الخارجية والدخول في عالم المنافسة والتوجه نحو التصدير.
على أن التحرر الاقتصادي بالصيغة التي طرحناها لكي ينجح لابد له من الارتباط بخطط لتحفيز الإنتاج وتوسيع القاعدة الإنتاجية. فبدون هذا الأمر سيصبح العراق مع الانفتاح الاقتصادي مجرد مستوردا للسلع والخدمات الأجنبية.
إن الأقطار التي تميزت باقتصاديات متحررة، وفي مقدمتها أقطار شرقي آسيا، هي تلك الأقطار التي نجحت في إنشاء قاعدة إنتاجية كفوءة من خلال التعرض لصرامة المنافسة المحلية والعالمية. فالمنافسة تجبر المنتج على إتباع التكنولوجيا الجيدة والابتكار والتجديد وتحسين النوعية وتقليل كلفة الإنتاج. وبعكس ذلك فإنّ التدخل الحكومي في العديد من الأقطار النامية، ومنها العراق، أضعف المنافسة وعرقل التقدم التكنولوجي ونمو الإنتاجية وساعد على قيام قاعدة إنتاجية ضيقة ومتخلفة(11).
شروط أخرى
هناك أيضاً شروط أخرى يمكن توفيرها لتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية للقدوم الى العراق. وتشتمل هذه الشروط على قيام الحكومة بإتباع السياسات العقلانية التي تتناغم مع السوق، توفير الخدمات الجيدة والبنية التحتية الوافية، ترسيخ سيادة القانون، تقليص الروتين الحكومي، النزاهة في العمل ومحاربة الفساد. إن هذه كلها أمور واضحة ولا تستدعي هنا إلى شرح أو تفصيل. على أن الأقتصاد العراقي، من أجل أن يركب عجلة التطور التي ركبتها قبله الأقتصادات الناجحة، يتعين عليه أن يواكب ما يسمى بالاقتصاد الجديد، وهذا الأخير يحتاج إلى بعض التوضيح. أن الأقتصاد الجديد يعني، باختصار، نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمال الانترنت وإنشاء بنياتها التحتية وتوفيرها بسهولة لكل من يحتاج لخدماتها. ففي ظل النظام السابق كان الاقتصاد الجديد، بما هو تعريفه هنا، غير موجود بالعراق رغم أنه أضحى من أهم عوامل نمو الاقتصادات الناجحة ومن أيسر الطرق لنشر المعرفة ونقل التكنولوجيا وإنجاز الأعمال. لقد أصبح محتماً الآن على المسؤولين العراقيين فتح الأبواب أمام تكنولوجيا المعلومات والانترنت وتشجيع الاستثمار في بنياتها التحتية وتيسير أستغلالها لكل من يحتاج لها.
_______________________________________________________________________
(1) هذا المقال مقتبس – مع أجراء بعض الأضافات والتحويرات المناسبة – من كتاب الدكتور محمد علي زيني “ا لأقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل”، الطبعة الثالثة 2010. يمكن تنزيل الكتاب كاملاً من الموقع:
HYPERLINK “http://www.muhammadalizainy.com” www.muhammadalizainy.com
كذلك يمكن الأطلاع على الحلقات السابقة من هذا المقال بالرجوع الى موقع الكاتب في الحوار المتمدن، وهو على الأنترنت بعنوان:
http://www.ahewar.org/m.asp?i=3340
(2) أنظر الفصل التاسع من الكتاب المذكور في الهامش (1) أعلاه.
(3) أعدم النظام العراقي 42 تاجراً في آب (أغسطس) 1992 بتهمة الربح الفاحش!
(4) هذا الرقم هو من تقديرات الكاتب.
(5) للأطلاع على المزيد من آثار التضخم المفرط أنظر الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من الكتاب المذكور في الهامش (1) أعلاه.
(6) بلغت المعونة الكلية لخطة مارشال لمساعدة أوربا الغربية للوقوف على قدميها بعد الحرب العالمية الثانية 13.15 مليار دولار بين الفترة 1948 – 1952، وكانت سبعة أعشارها هبات. وتفاوتت المعونة (إذ كان المستفيدون 16 بلداً أوربياً) بين 3.1 مليار دولار قُدمت الى بريطانيا (وهو أكبر مبلغ) نزولاً الى 32 مليون دولار قُدمت الى آيسلندا.
Summers, Lawrence, 1991, Research Challenges for Development Economists, (7)
in Finance & Development, September 1991: Washington D.C., IMF & IBRD, P.3.
Economist Intelligence Unit, Iraq Country Report, December 2003, P. 29.(8)
Richards, Alan, and Waterbury, John, 1990, A Political Economy of the Middle East: (9)
Boulder, Colorado, Westview Press, Inc., PP.25-28. Hamilton, Nora, and Kim, Eun Mee, 1993, Economic and Political Liberalisation in South(10)
Korea and Mexico, in Third World Quarterly, Vol. 14, No.1, 1993, P.110. Thomas, Vinod, 1991, Lessons from Economic Development,(11)
in Finance and Development, September 1991, P.7.
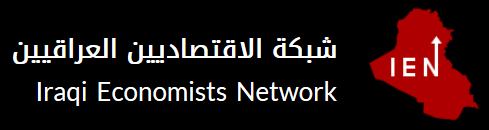



سبكة الاقتصاديين تحوي على مواضيع رائعة وحلول مؤضوعية لحل الازمة الاقتصادية في العراق ، كما اتمنى برفدي كل ما يتعلق في الاقتصاد السياسي كوني طالب دكتوراه في العلوم السياسية واكتب في الاصلاح الاقتصادي في العراق بعد 2003 دراسة تحليلية تقويمية واحتاج الى تكوين رؤية مستقبلية من خلال رفدي بمؤلفات الاساتذة الاقتصاديين مثل محمد علي زيني وغيرهم مؤلفات حديثة مع جل احترامي لجهودكم الخيرة وحرصكم على بلدكم ووطنيتكم وفكقم الله