الجانب الاقتصادي من العدل الاجتماعي في العراق يتمثل في ضمان حق المواطن بالعمل من أجل كسب وسائل المعيشة له وعائلته، وكذلك حقه بالضمان من البطالة والمرض في حالة تعرضه لهما.
ولكي يكتسب المرء، سواء أكان عاملاً أو فنياً أو متعلماً تعليماً عالياً وتخصصياً كالأطباء والمهندسين والمدرسين، التعليم أو التدريب الضروريْين لأداء عمله، لابد من برامج تعليم وتدريب، بدءاً من الدراسة الابتدائية ولغاية مرحلة التعليم الاساسي (المرحلة المتوسطة أو الصف التاسع)، على الأقل، بغية إعداده ليكتسب المهارة الفنية بمختلف مستوياتها.
ويشكل إعداد المواطن للعمل وتأمينه له جزءاً من الوظيفة الكبرى والحاسمة التي ينبغي أن تضطلع بها الدولة في العراق، والتي (الوظيفة)، رغم الاختلاف الممكن في فهم حدودها ومحتوياتها، يتوقف عليها مصير ومستقبل العراق نفسه كبلد.
ثمة نظرات مختلفة لما ينبغي أن تقوم به الدولة في العراق (وسائر البلدان النامية).
فهناك علماء اقتصاد واجتماع يقصرون دور الدولة على الوظائف التقليدية المتعلقة بحفظ الأمن والنظام وفرض القانون وحفظ الملكية- ما يسمى بوظائف “الدولة الحارسة”، مع ترك كل ما يتعلق بالإنتاج للقطاع الخاص على أساس أنه أعرفْ وأقدرْ من غيره في هذا المجال.
ولكن هناك فريق آخر يوسّع من دور الدولة ليتضمن بناء قطاع حكومي مهمته إنجاز كل البنى التحتية التي يتعذر الانتاج الزراعي والصناعي بدونها مثل مرافق النقل والمواصلات، والطرق والجسور والمطارات والموانئ والسدود، نظم الكهرباء والماء والصرف الصحي.
وهناك من المتخصصين من يرى ضرورة أن يتدخل القطاع الحكومي حتى في مجال الانتاج المباشر الزراعي والصناعي.
والآن، ومنذ نهاية الثمانينات حين انهارت دول المنظومة الاشتراكية السابقة، صار الفريق الأول (القائل بالدور التقليدي والمحدود للدولة) يؤكد على أن الزمن قد أثبت وزكّى صحة رأيهم، وأن من الضروري ترك معظم جوانب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الخاص على أساس أنه أعرفْ وأقدرْ على القيام بها وفقاً لقواعد السوق- أي المنافسة بين وحدات ومؤسسات القطاع الخاص وآلية الأسعار وظروف العرض والطلب. وهو الرأي الذي تجسدَ، في منتصف الثمانينات، في ما يسمى بـ “توافق واشنطن“.
ولكن هذا الرأي لا يستند إلى أي أساس من التاريخ أو من النظرية الاقتصادية، فضلاً عن أن البلدان التي كانت تشكل مناطق وبلدان متخلفة عادية قبل حوالي 50-60 سنة قد أخذت بسياسات للتطور بعيدة عن هذا التصور لدور للدولة، مع أنها كانت تتطور وفق النمط الرأسمالي.
فمن الناحية التاريخية، باشرت الدول الرأسمالية الأولى، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، بالتحول من نُظمها السابقة، الاقطاعية، إلى النظام الجديد، الرأسمالي، وذلك بالاعتماد على دور واسع وقوي للدول القومية الناشئة حينذاك، وبخاصة في مجال التجارة الخارجية. [لنتذكرْ مغزى نشوء مدارس معينة مثل “الميركنتيلية”، ورجال حُكم وفكر مثل كولبير في فرنسا، وليست في ألمانيا (بروسيا)، وما عملوه أو طرحوه لكي تلحق بلدانهم ببريطانيا، المتصِّدرة حينذاك في تطورها الرأسمالي، ولكي يكون لهم مكان في المستعمرات في آسيا وأفريقيا والقارة الجديدة المكتشفة، أمريكا].
ومن ناحية النظرية الاقتصادية، فإن حجم دور الدولة في التطور الاقتصادي والاجتماعي في بلد معين يعتمد حصراً على مستوى التطور الابتدائي للبلد المعني، وليس بالضرورة على التوجهات والميول الفكرية، الرأسمالية أو الاشتراكية لحكامه والمتنفذين فيه، أي أن هذا الدور يكون واسعاً وشاملاً وكثيفاً في بداية عملية التطور لأن البلد المعني يكون شديد التخلف في البداية. وهكذا، فلضآلة متوسط دخل الفرد في هذه الدول، وما يعنيه ذلك من طلب محدود على السلع والخدمات (أي ما نسميه “السوق الضيقة” اللازمة للزراعة والصناعة)، من ناحية، ومحدودية الطاقات الانتاجية القائمة، أي محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والمعامل والمصانع التي من شأنها توفير العمل لمن هم قادرون على العمل في ظل معدل عالٍ لنمو السكان)، من ناحية أخرى، وكذلك محدودية عناصر البنُى التحتية (أي مرافق النقل والاتصال، والطرق والجسور والمطارات والموانئ والسدود، ونُظم الكهرباء والماء والصرف الصحي، فضلاً عن نُظم التعليم والصحة والقانون)، من ناحية ثالثة، كانت عملية مواجهة التخلف الاقتصادي والاجتماعي نفسها تتطلب وتفرض التدخل الواسع من قبل الدولة في الحياة في بداية مراحل النمو الاقتصادي والاجتماعي. وهكذا، مثلاً، لأن رؤوس الأموال الخاصة قليلة أو حتى معدومة في بداية عملية التطور والانتقال، أو أن رؤوس الأموال هذه لا تجد جدوى اقتصادية كافية للاستثمار في بلدانها نفسها، فإن الدولة، تبادر، مضطرةً أحياناً، للتدخل على نطاق واسع لأن القطاع الخاص غير قادر، أو غير راغب، أو أن نجاح دوره يتطلب مساعدة حاسمة من جانب الدولة.
ومن الناحية العملية، فإن البلدان التي كانت متخلفة وعادية تماماً قبل حوالي 50-60 سنة قد أخذت بسياسات للتنمية كان عمادها الدور الواسع جداً للدولة مع أنها كانت تتطور وفق النمط الرأسمالي. فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت كوريا الجنوبية، وتركيا، واندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورا، وتايوان وهونك كونج والهند، من المناطق والدول النامية والعادية، ولكنها باتت، ومنذ منتصف ونهاية الثمانينات، من دول العالم عالية أو متوسطة التطور، وتمتلك قطاعات زراعية وصناعية وبُنى تحتية متطورة، وبالتالي دخلاً للفرد الواحد يقترب من مثيله في الدول المتطورة اقتصادياً في الغرب. فما هي أبرز معالم سياسات هذه الدول، بقدر تعلق الأمر بحجم دور الدولة في حياتها، التي قادتها إلى مثل هذا النجاح؟ الجواب يتمثل في أن أبرز عوامل النجاح الذي تحققَ في هذه البلدان هو اعتمادها على التعليم والتدريب وتحسين القدرة على المنافسة وتحسين الإنتاجية، كما لعبت تلك الدول دورًا تنمويًا بالتخطيط الاقتصادي وتحقيق التعاون البناّء بين القطاعين الحكومي والخاص. ففي ظل غياب الموارد الطبيعية وقلة رأس المال، توجهتْ تلك البلدان إلى الاهتمام بالعنصر البشري كمورد للتنمية، فاستثمرت بكثافة منذ البداية في التعليم ومدارس التدريب المهني لتطوير إنتاجية السكان وتحسين مهارتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية في عمليات التصنيع. فعلى سبيل المثال، ارتفع الإنفاق الحكومي على التعليم في كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا إلى 4.62 في المائة، و2.94 في المائة، و5.93 في المائة على التوالي، من ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2015، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي. كما أنها عملت على إرسال عدد كبير من الطلبة والموظفين للدراسة والتدريب. ويعود عامل النجاح هذا إلى الدولة حصراً. وينسحب الأمر نفسه على عوامل النجاح الاقتصادي الأخرى مثل تخصيص نسبة معقولة من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمار، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنظيم التجارة الخارجية، وقطاع المصارف.
أما في العراق، فأنا لا أتحدث فقط عن الدور الاقتصادي الذي ينبغي أن تضطلع به الدولة، بل أتحدث، أصلاً، عن الدور المتعلق بحفظ الأمن والنظام وحياة الناس وملكياتهم. لنتذكرْ أن أبسط تعريف للدولة ينطلق، أولاً، من زاوية السلطة. فالدولة هي التجسيد الأعلى للسلطة، وينحصر دورها الأولي والبديهي في سيطرتها على العنف واحتكار وسائله. وهذا فهمْ ينسجم مع النظر إلى الدولة باعتبارها إدارة للعنف، أو هي الحارس، أو الدولة الحارسة، بحسب مصطلحات الأدب الاقتصادي الغربي. ولكنها هنا، وهذه مفارقة في ظروف العراق الغريبة والتراجيدية، هي الأنسب لظروف العراق، والتي يتوقف عليها مستقبله كدولة، وليس فقط مسار تطوره.
فكل مظاهر وأدوات العنف، من جيش وشرطة وأجهزة أمن واستخبارات، تكون بيد الدولة حصراً ونهائياً. فهذه هي الوظيفة الأولى والحاسمة لأن باقي الوظائف تعتمد عليها، مع أنها مهمة هي الأخرى. وثمة نقطة بهذا الخصوص تستحق الذكر والانتباه. أن سعي الدولة لفرض نفسها أو شرعيتها في المجتمع، الذي هو مجتمع منقسم طائفياً، سيكون (هذا السعي) بمثابة نزاع حول الهويات، ومحاولة طوائف معينة للهيمنة، فضلاً عن الهوس العراقي المعروف بالزعامة والاستحواذ والمكانة.
وتعني الدولة، في بُعدها الثاني، القدرة على الأداء الخدمي. قد يُختلف في تعريف نطاق الخدمات، ولكن أهمها هو تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتعظيم المنفعة الجماعية، وتوفير بيئة صالحة للأعمال، وفرض القانون، وحماية الملكية، وإقامة العدل، والتعليم الأساسي، والصحة، والبنى التحتية بمعناها الواسع. إن هذا البُعد، أو هكذا دور حكومي، يعادل ما يُصطلح عليه في بعض البلدان الغربية (كالدانمارك وفرنسا، وربما ألمانيا) “القطاع العام“، أي القطاع الذي يهيأ كلَ ما ضروري من خدمات وبنية تحتية للمجتمع عموماً، وللقطاع الخاص تحديداً، لكي ينهض بعملية الانتاج المباشرة في الزراعة والصناعة والتجارة والاتصالات. ولكن القطاع الخاص هنا قطاع متطور بالفعل عبر عقود وعقود من التطور المتواصل، والجاهز للعمل، والعارف بما له وما عليه، والمندمج في المجتمع ككل، وليس كحال قطاعنا الخاص الذي ينقصه الدور الحكومي الذي ينظّمه ويمركز عمله ويساعده على الوقوف على قدميه (بالتوجيه والتمويل والبنى التحتية) لكي يقّدم ما يستطيع، من جهة، ويردعه عن الانغماس والمشاركة مع الآخرين في الفساد واللصوصية ونهب المال العام، من جهة ثانية.
إن التوصل في بلدنا إلى هكذا قطاع حكومي هو، في الحقيقة، جزء من عملية التطور (أو التنمية)، ويتكون ويتوسع ويتحسن سويةً معها، وهو ليس منتوجاً جاهزاً بل أنه يتطلب ويفترض، بين أمور أخرى، تحقق ما أسميته، أعلاه، البُعد الأول في وظائف الدولة، بُعد السلطة، بحيث تتحقق لها درجة معقولة من الحزم والقدرة على فرض قراراتها وبالتالي يكون لها ما هو مفروض من هيبة[1]. وكل هذا أمر ممكن، علماً بأننا لا نبدأ من الصفر، وتشهد على ذلك تجربةُ التخطيط للإعمار والتنمية في بلدنا خلال السنوات 1950-1985.
والنقطة الأخيرة، التي أود لفت الأنظار لها والتي تقع في صلب مهام القطاع الحكومي وتعاونه المنشود مع القطاع الخاص، تخص مشروعات الصناعة التحويلية. إن قسماً من هذه المشروعات لا يفكر بها القطاع الخاص نفسه أصلاً لما تتطلبه من تمويل كبير، من جهة، ولطابعها غير المدّر للأرباح العاجلة، من جهة أخرى. ولذلك، فهي مشروعات لا يستطيع القطاع الحكومي إلاّ أن يضعها ضمن مسؤولياته إذا كان مؤمناً بأن مستقبل التنمية في العراق يعتمد على التصنيع حصراً. أما المشروعات الصناعية الأخرى ذات الطابع الاستهلاكي والخفيف (التي تتولى تلبية الحاجة للملبوسات والغذاء ومتطلبات البناء …) التي “يُفترض” اهتمام القطاع الخاص بها وتركيزه عليها، فهذه، هي الأخرى، لا توجد أي ضمانة تلقائية لاهتمام القطاع الخاص بها إلاّ إذا كانت تتضمن فرصاً معقولة للربح بالمقارنة مع الفرص البديلة لتحقيق الربح من استثمار أمواله في حقول أخرى كشراء الأراضي والعقارات، أو الإيداع في المصارف، وحتى الاستثمار في خارج العراق. وهنا، مرة أخرى، يبرز الدور الذي يمكن أن يقدمه القطاع الحكومي للقطاع الخاص: التوفير في الكثير من التكاليف التي يتحملها الأخير وذلك من خلال المشروعات الحكومية في البني التحتية، وبخاصة الكهرباء والنقل والموانئ، من جهة، والحماية من منافسة المنتوجات الأجنبية التي يمكن تحقيقها من خلال التشريعات الحكومية في مجال التجارة الخارجية. فكل ذلك يقود إلى إمكانات أكبر لتحقيق الربح وبالتالي انجذاب رؤوس الأموال الخاصة لها. وبعبارة أخرى، إن وجود المال لدى القطاع الخاص (وقدرته على الحصول على قروض من الحكومة وغيرها) لا يضمن وحده توجه هذا المال نحو الصناعة، بل لابد أن تكون هناك جدوى اقتصادية من استثماره هناك.
إن دولة حازمة وفارضّة لشرعيتها، وقطاعا حكومياً بالمواصفات المبيَّنة أعلاه، هما ضمانة لحل مشاكل العراق الاقتصادية وتمكينه من تحقيق العدل الاجتماعي بصورة تدريجية.
فثمة فرصة لبناء وتعزيز قطاعات وطاقات محلية للنتاج الزراعي والصناعي والخدمي. وهذا يمكّن البلد من الاعتماد على نفسه في تلبية احتياجاته وعلى نحو تدريجي، من جهة، ويتيح الفرص لتشغيل قواه العاملة، من جهة أخرى. وحين نتذكر الاعتماد الهائل، حالياً، على الاستيراد في إشباع احتياجاتنا، والبطالة الواسعة والصريحة والرسمية وصعوبات الحصول على عمل (الذي هو من صميم حقوق أي مواطن ومن متطلبات العدل الاجتماعي)، ووجود حوالي خمس ملايين فرد “يعملون” في أجهزة الدولة دون انتاجية تُذكر تقريباً، نفهم معنى بناء وتطوير قدرات عراقية للإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.
كما تتيح هذه القدرات، تدريجياً، تخفيض اعتمادنا على قطاع النفط، المرتبط بالخارج في انتاجه وأسعاره، في كل شيء تقريباً، أي نحّد مما نسميه “الطابع الريعي” للاقتصاد العراقي. وهكذا، فحين يكون لنا ناتجنا القومي العراقي (أي ناتجنا من السلع الزراعية والصناعية والخدمية، وليس فقط من النفط أساساً)، فستكون لدينا مصادر للضريبة تمّول الانفاق الحكومي، وبالتالي ينبني أساسُ للديمقراطية السياسية قائم على مساهمة طبقات وفئات المجتمع في تمويل جهاز الدولة من إنتاجها هي (وليس من النفط فقط) وبالتالي فرض حقها في مراقبته وتسخيره لخدمة مصالح المجتمع نفسه.
ومما تقدم، أخلصُ إلى أن تحقيق العدل الاجتماعي في العراق، وبخاصة جانبه الاقتصادي، يعتمد، بين أمور أخرى، على حزم الدولة وقطاعها الحكومي:
1) حكومة حازمة تحتكر أجهزتها المختلفة (من جيش وشرطة وأمن ومخابرات) بحيث تفرض نفسها وشرعيتها على كل المجتمع وتحقق لها ما هو مفروض من هيبة.
2) أن يكون هناك قطاع حكومي يضمن، ولا بأس من التكرار، تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتعظيم المنفعة الجماعية، وتوفير بيئة صالحة للأعمال، وفرض القانون، وحماية الملكية، وإقامة العدل، والتعليم الأساسي، والصحة، والبنى التحتية بمعناها الواسع، وكذلك التأكيد على إقامة وتطوير قطاع صناعي بالتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص.
(*) باحث أكاديمي
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. 21 آيار 2020
[1] لا ينسى كاتب هذه السطور أن تلك الأجهزة تخص السلطة التنفيذية أو الحكومة فقط من بين سلطات الدولة الثلاثة. وأن الحديث الوارد في المتن لم يتناول السلطتين التشريعية والقضائية وذلك ليس لعدم ضرورة دراستها، بل فقط للأهمية الاستثنائية للسلطات التنفيذية في الوقت الحاضر في تثبيت الحكم، وكذلك للافتراض أن اتجاهات مسار السلطتين المذكورتيْن ستراعي وتتماشى مع ما تفعله السلطة التنفيذية اضطراراً ولفترة زمنية مؤقتة.
التحميل المقال كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي
حسن عبد الله بدر- الدولة وقطاعها الحكومي- محررة

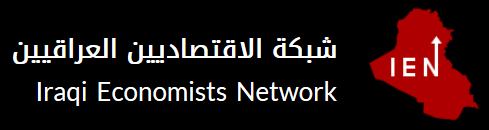

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية