كاظم حبيب
قراءة ومناقشة “خارطة طريق اقتصادية” للسيد الدكتور محمد علي زيني
الحلقة الأولى
المدخل
نشر السيد الدكتور محمد علي زيني دراسة قيمة بعنوان “خارطة طريق اقتصادية” للعراق توزعت على سبع حلقات على موقع الحوار المتمدن, نشرت الحلقة الأولى منها في 9/2/2011 والحلقة السابعة والأخيرة في 15/5/2011. وبسبب أهمية الكاتب وكتاباته ودوره البارز في البحث والنشر حول الاقتصاد العراقي, وبسبب أهمية الموضوع والأفكار والمقترحات التي تضمنتها هذه الحلقات السبع بشأن إعادة بناء وتطوير الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية وجدت مفيداً المشاركة في نقاش موضوعي هادف مع أفكار واستنتاجات الصديق الفاضل من جهة, وتحريك جو الحوار والنقاش الفكري والاقتصادي في أوساط العاملات والعاملين في المجال الاقتصادي العراقي في الداخل والخارج بما يسهم في بلورة ما أطلق عليه الزميل الفاضل “خارطة طريق اقتصادية” للعراق من جهة ثانية. ولا بد من الإشارة إلى أن الأستاذ الكاتب قد نشر أول كتاب اقتصادي مهم له, حسب علمي, في سنة 1995 تحت عنوان “الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين – تطور أم تقهقر” صدر عن دار الرافد بلندن, ثم صدرت الطبعة الجديدة المنقحة والمزيدة لهذا الكتاب في العام 2003 ومن الدار نفسها تحت عنوان “الاقتصاد العراقي بين الماضي والحاضر وخيارات المستقبل”. كما نشر دراسة أخرى عن الفساد في العراق.
ومن المفيد الإشارة أيضاً إلى إن الاقتصادي العراقي المعروف السيد الدكتور صبري زاير السعدي نشر هو الآخر مجموعة من الدراسات المهمة والأبحاث القيمة في هذا الصدد, منها على سبيل المثال لا الحصر, دراسة قيمة بعنوان “السياسة والاقتصاد في نظام الحكم الديمقراطي (الجديد) في العراق: التي نشرت في العدد 126 من “الملف العراقي” الصادر في حزيران/يونيو 2002, كما صدر عن دار المدى ببغداد في عام 2009 كتابه المهم “التجربة الاقتصادية في العراق الحديث – النفط والديمقراطية والسوق في المشروع الاقتصادي الوطني (1951-2006)” وهو كتاب قيم. إضافة إلى ما نشر للدكتور السعدي من دراسات في مجلات مثل المستقبل العربي ودراسات عربية والثقافة الجديدة وفي مجلات أخرى باللغة الإنجليزية. وقبل ذاك صدر للطيب الذكر الأستاذ الدكتور عباس النصراوي (ت 2008) كتاب تحت عنوان “الاقتصاد العراقي” في عام 1995 عن دار الكنوز الأدبية ببيروت. وهي, إلى جانب غيرها من الكتب الاقتصادية, تعتبر من الكتب والدراسات المهمة التي تستحق وتستوجب القراءة من جانب العاملين في الشأن الاقتصادي العراقي.
يطرح الدكتور زيني في دراسته “خارطة طريق اقتصادية” للعراق مجموعة من الأفكار والاستنتاجات السديدة التي تستحق كل التأييد, سواء أكانت في الجانب النظري أم في الجانب التطبيقي وما يخص العراق بشكل مباشر. وحين اكتمل نشر الحلقات وجدت لزاماً عليَّ أن أحاور الدكتور زيني مباشرة وأن أناقش الأفكار التي طرحها على الجميع للمناقشة. وقد أخذ السيد الدكتور كامل العضاض المبادرة فناقش الحلقة الأولى مشخصاً بعض النقاط المهمة ومنتظراً الانتهاء من الحلقات لكي يناقشها. وأملي أن يواصل طرح ملاحظاته لصواب ما ورد في ما طرحه حتى الآن في رسالته الوجهة إلى الدكتور زيني. وأتمنى عليه أن يستكمل المناقشة بعد أن انتهى نشر الحلقات السبع.
وفي مناقشتي المكثفة هذه سأتطرق إلى تلك الأفكار والاستنتاجات التي توصل إليها الدكتور زيني في الجانبين النظري والتطبيقي أو ما يمس مسيرة العراق الاقتصادية المنصرمة والواقع الراهن وتصوراته لآفاق المستقبل. ومنذ البدء أشير إلى وجود اتفاق مع الزميل الدكتور زيني حول عدد مهم من القضايا النظرية والتطبيقية, ولكن توجد لدي ملاحظات ووجهات نظر أخرى تختلف عما ورد في دراسة الدكتور زيني والتي سأضعها أمام الزميل وأمام بقية القارئات والقراء ممن لهم اهتمام بالشأن الاقتصادي العام وبالشأن الاقتصادي العراقي لغرض المناقشة والتدقيق.
ابتداءً أود الإشارة الواضحة إلى ثلاث مسائل جوهرية حول ما أسعى إليه من هذه المناقشة:
لا أدعي الصواب في ما أطرحه من ملاحظات نقدية, إذ إن مهمتها تنشيط النقاش وتدقيق الاستنتاجات النظرية والعملية, وهي تعبر عن اجتهاد شخصي وعن رؤيتي الناتجة عن قراءاتي وتجربتي الذاتية. وأنا مقتنع بما أنشره حتى الآن.
أن نتواصل في الحوارات والنقاشات الفكرية بهدف تعميق الرؤية الاقتصادية لنا وللمجتمع من جهة, والسعي لبلورة رؤية مشتركة للعاملات والعاملين في الشأن العراقي من جهة ثانية, بحيث تسهم في الدفع باتجاه:
عقد ندوة فكرية وتطبيقية حول الاقتصاد العراقي وسبل تطويره, أي العمل المشترك وعبر مؤتمر أو ندوة لعدة أيام للوصول إلى وضع “خارطة طريق اقتصادية- بشرية أو اجتماعية” أمام المسؤولين عن رسم إستراتيجية التنمية الاقتصادية والبشرية في العراق.
مناقشة مضامين دراسة “خارطة طريق اقتصادية” للعراق
وعلى هذا الأساس سأقسم مناقشتي إلى قسمين: القسم الأول سيتضمن عدة حلقات أناقش فيها الجوانب النظرية من أطروحات الزميل الدكتور محمد علي زيني, في حين سيتضمن القسم الثاني عدة حلقات أيضاً أناقش فيها جوانب السياسات الاقتصادية و البشرية التي يقترحها الزميل محمد علي زيني على العراق للأخذ بها.
أولاً: الجوانب النظرية
سأناقش في هذه الحلقة عدداً من الموضوعات التي وردت في “خارطة طريق اقتصادية” للعراق بشكل مكثف, وهي موزعة على مساحة الدراسة بحلقاتها السبع.
1 . العلاقة بين السياسة والاقتصاد
استعرض الدكتور محمد علي زيني بصواب وموضوعية العلاقة الجدلية القائمة بين السياسة والاقتصاد والفعل والتأثير المتبادل بينهما, إذ أنهما, كما هو معروف, وجهان لعملة واحدة. ويؤكد ذلك حين يورد وقائع فعلية ملموسة عن الفترات السابقة وما يجري اليوم في البلاد. إلا إن العلاقة الجدلية بين السياسة والاقتصاد من الناحيتين النظرية ليست هي المشكلة, فالكل تقريباً يعترف بذلك, بل المشكلة تكمن في رفض حكام غالبية الدول النامية الاعتراف بالعلاقة الجدلية بين الفئات الحاكمة والقوى الطبقية أو الفئات الاجتماعية المالكة لوسائل الإنتاج من جهة وسعي الحكام إلى تبني إيديولوجيا تلك الفئات الاجتماع والدفاع عن مصالحها وإرادتها بالضد, في الغالب الأعم, من إرادة ومصالح الغالبية العظمى من فئات المجتمع. وهذه الحقيقة التي تُنكر كثيراً تؤكد حقيقة ان النخب الحاكمة ليست مستقلة عن الفئات المالكية لوسائل الإنتاج, بل معبرة عنها وعن مصالحها.
وتتجلى هذه العلاقة القائمة فعلاً في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يمارسها النظام السياسي القائم وينعكس في الموقف من عملية التنمية الاقتصادية والبشرية أو في إعادة البناء في العراق, وبشكل أكثر ملموسية في الموقف من بنية ووجهة التصنيع وتحديث الزراعة ومن بنية قطاع التجارة الخارجية والسياسات المالية بكافة جوانبها, التي تعتبر الأداة التنفيذية للسياسات الاقتصادية. كما تتجلى في مجمل العملية الاقتصادية بمراحلها الأربعة: الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك. ويمكن للمتتبع أن نتيقن من ذلك حين يجري تدقيق بنية الدخل القومي من حيث سبل تكوينه وتوزيعه وإعادة توزيعه, ومن ثم في العلاقة بين الأجور وفائض القيمة (الأرباح والفوائد وأشكال الريع) أو توزيعه بين التراكم والاستهلاك وسبل استخدامه.
من يسعى إلى معرفة مدققة لطبيعة تكوين وتوزيع الدخل القومي في العراق في الفترات المختلفة السابقة من تاريخ العراق الحديث, يمكنه أن يعود بشكل ملموس إلى فترات العهد الملكي قبل وبعد الحرب العالمية الثانية ومن ثم في عهد عبد الكريم قاسم وفي عهد التحالف البعثي القومي بعد انقلاب شباط 1963 ومن ثم في فترات الأخوين عبد السلام وعبد الرحمن محمد عارف وفي فترة حكم البعث الثانية وصدام حسين الاستبدادية, وكذلك في أعقاب سقوط النظام الدكتاتوري وسيادة حكم المحاصصة الطائفية حتى الوقت الحاضر. ويمكن أن يرجع في ذلك على الميزانيات الاعتيادية وميزانيات التنمية الوطنية ليتحقق من ذلك من خلال أسس توزيع الدخل القومي وسبل استخدامه والقوى المستفيدة منه والمجالات التي صرفت فيه, إذ إنه سيدرك حقاً طبيعة تلك النظم الاجتماعية والسياسية ومدى ابتعادها عن مصالح الشعب الأساسية, في ما عدا فترة قصيرة من حكم قاسم.
فالسياسة الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد كان, وكذا العراق, تجسد لنا بلا مواربة وبشفافية عالية طبيعة الفئة التي تحكم المجتمع العراقي حالياً. فنظرة متفحصة للواقع العراقي الراهن تساعدنا على تشخيص حقيقة أن النخبة الحاكمة في أغلبيتها تنحدر من فئات برجوازية صغيرة ومن فئات اجتماعية رثة اقتصادياً واجتماعياً وكانت مهمشة وتعيش على هامش الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, جماعات منحدرة من فئات اجتماعية إقطاعية وعشائرية ما تزال تحن للماضي وترتبط به بوشائج كثيرة وتتمنى عود قانون العشائر الذي ساد قبل ثورة تموز 1958, وهو في الواقع العملي ممارس فعلاً. وهي ليست من تلك الفئات البرجوازية المتوسطة التي تعمل من أجل تصنيع البلاد وتحديث الزراعة وتأمين زيادة التراكم الرأسمالي لصالح تنمية الثروة الوطنية والدخل القومي, بل إنها من الفئات التي تركض وراء الربح السريع في القطاع التجاري وفي المضاربات المالية التي شكلت اليوم فئة برجوازية تجارية كومبرادورية ترتبط مصالحها بمصالح الشركات الأجنبية المنتجة والمصدرة للسلع المصنعة وتشارك معها في تحقيق أقصى الأرباح بغض النظر عن الأساليب المعوجة التي تمارس في هذه العمليات. وهي ليست ضد التعامل مع الرأسمال الأجنبي, ولكنها ضد مشاركته في تصنيع البلاد الذي يسهم في تغيير البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية وتحقيق التقدم وتطوير الوعي لدى الإنسان, بل تحصره في مجالات التجارة والبنوك والتامين وإعادة التأمين لتحقق لنفسها أقصى الأرباح على حساب التطور التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وتتجلى طبيعة النخب الحاكمة وتلك التي يُعبر عن مصالحها عبر الفئات الحاكمة ما يمر به المجتمع العراقي من فساد مريع تمارسه تلك الفئات بشكل واسع النطاق يقود إلى إفقار الثروة الاجتماعية والمجتمع ويشوه وجهة تطور البلاد ويعرقل تغيير بنية اقتصادها ويساهم في التفريط في قدرات البلاد على تحقيق التنمية والخروج من نفق التخلف المتعدد الجوانب الذي يعاني منه المجتمع. إن العواقب المباشرة من الحكم الذي يقاد من فئات اجتماعية ذات خلفية فلاحية وبرجوازية صغيرة لا تعمل في مجالات الإنتاج ورثة تستخدم العمامة والدين لأغراضها الذاتية وطفيلية النشاط, تظهر فيه جملة من الظاهر السلبية الحادة على سطح الأحداث اليومية ولكنها تجسد الخراب الجاري في عمق المجتمع, ومنها ممارسات المحسوبية والمنسوبية والعشائرية والطائفية السياسية باسم الدين والقومية الضيقة والشوفينية والفساد المالي والإداري, الذي احتل العراق مع الصومال المراكز الأولى في العالم, والخراب الاقتصادي وضد المرأة وحقوقها وممارسة التمييز بكل أشكاله وغياب مفهوم المواطنة الحرة والمتساوية من قاموس النخب الحاكمة. إن كل ذلك يصعب إصلاحه ما لم يجر تغيير لتلك القوى التي تمسك بزمام الأمور من خلال الانتخابات وتغيير طبيعة السياسات التي تمارس في البلاد من خلال رفض المحاصصة الطائفية..الخ. وهي مهمة كبيرة تستوجب نضالاً سلمياً وديمقراطياً شاقاً ومعقداً وطويل الأمد.
إن عرض هذه اللوحة الاجتماعية للنخب الحاكمة في البلاد يشير لنا بأن السياسات الاقتصادية التي تمارس في العراق تعتبر من هذا الخليط الاجتماعي المركب وتتجلى فيها العلاقة الجدلية لا بين السياسة والاقتصادية بشكلها العام والظاهر حسب, بل بمضامينها الاجتماعية أو الطبقية التي تحرص على مكافحة الطبقة الوسطى أو البرجوازية الصناعية المتوسطة والطبقة العاملة وفئة المثقفين وتحديث وتنويع القطاع الصناعي وحل المسألة الزراعية وتحديث الزراعية وتنويع بنية الإنتاج الزراعي وتنظيم التجارة الخارجية وتغيير بنيتها لصالح عملية التنمية الوطنية والتصنيع …الخ.
حين يستطيع المجتمع أن يخلق ميزان قوى جديد لصالح الفئات المنتجة للثروة الاجتماعية, للسلع المادية والروحية, يمكنه أن يشكل عند ذاك ضغطاً على الفئة الحاكمة لتمارس سياسة اقتصادية فيها شيء من الاستقلالية عن مصالح الفئات المالكة لوسائل الإنتاج, أو ما يحقق شكلاً من أشكال التوازن في المصالح بما يسهم في دفع عجلة التطور والتقدم إلى الأمام. ومثل هذه الحالة تستوجب نضالاً شاقاً من جانب القوى المعبرة عن مصالح تلك الفئات لتنعكس في مجلس النواب وفي تشكيلات مجلس الوزراء وفي القوانين والقرارات التي تصدر عن الحكومة ومجلس النواب. وإلى ذلك الحين سيبقى العرق يئن من وطأة المشكلات الراهنة.
2 . العلاقة بين إستراتيجية التنمية والخطط الاقتصادية والاجتماعية
حين يكون الحكم على مستوى البلاد والمحافظات بيد هذه الفئات الاجتماعية التي تحدثنا عنها, فلا شك في أن المتتبع سيجد تعبير ذلك في غياب الرؤية العقلانية أو الرشيدة لعملية التنمية الآفاقية وعلى المدى البعيد أو ما نطلق عليه بإستراتيجية التنمية الوطنية التي تمتد لعقدين أو أكثر. وهذا ما نراه اليوم في العراق, إذ في ضوء غياب سياسة اقتصادية ومالية واجتماعية فعالة واقعية يختفي أيضاً التوزيع الرشيد للمهمات والأهداف والتقديرات للاستثمارات على خطط خمسية وسنوية وعلى مستوى الحكومة الاتحادية والمحافظات مثلاً. وفي غياب إستراتيجية التنمية الوطنية الشاملة وتقدير حاجات البلاد ذات المدى البعيد للموارد المالية بصورة علمية تقريبية, تغيب أيضاً إستراتيجية السياسية النفطية في البلاد وتتحول إلى تصريحات فارغة وتقديرات متباينة ومزاجية يدلي بها هذا الوزير أو ذاك حول كمية النفط التي يراد استخراجها وتلك التي يمكن تصديرها أو التي يمكن استخدامها في عمليات التكرير أو التصنيع الأخرى. وينطبق هذا على القطاعات الأخرى كالكهرباء مثلاً.
إن هذه الفئات الاجتماعية غالباً ما تكون انتقائية وعفوية وذات رؤية ضبابية لما يفترض أن ينمو ويتطور في العراق حالياً وفي المستقبل. هذا ما عاشت فيه البلاد في فترة حكم القوى القومية والبعثية منذ 1963 حتى سقوط نظام البعث وصدام حسين. لقد امتلكت سلطة حزب البعث جهازاً للتخطيط وكفاءات كبيرة وقيمة وإمكانيات مالية كبيرة ووضعت للعراق خطة بعيدة المدى عمل عليها الكثير من الباحثين الممتازين من أمثال الدكتور عبد الرحمن قاسملو والدكتور صبري زاير السعدي والدكتور جعفر عبد الغني والدكتور كامل العضاض والدكتور فرهناك جلال وعشرات من الخبراء والمختصين غيرهم, إضافة إلى بعض الأجانب, كما وضعت خطط خمسية مهمة, ولكن العفوية والانتقائية والرغباتية كانت سيدة الموقف وهي التي تحدد ما يفترض أن يقام في العراق من مشاريع, وهي التي أبعدت كل الخطط عملياً وتركت صدام حسين وطه ياسين رمضان وعزت الدوري هم الذين يحددون وجهة تطور الاقتصاد باتجاه التصنيع العسكري على وفق الذهنية العسكرية الراغبة في القمع والحرب والتوسع.
ومن يطلع على الخطة الخمسية التي طرحها السيد الدكتور علي بابان سيجد إنها لا تمتلك رؤية مستقبلية ولا تقوم على رؤية إستراتيجية بعيدة المدى ووضعت على عجل. ولهذا فقد افتقدت للكثير من المسائل المهمة التي أشرت إليها في مقال لي حول الخطة الخمسية نشر في موقع الحوار المتمدن وموقعي الخاص. ومع ذلك فقد كانت مبادرة مهمة. ولكن لم يأخذ الحكم الحالي بها لأنه لا يؤمن بالتخطيط ولا يرى ضرورة له ولا منفعة له فيه.
حين تضع إستراتيجية للتنمية الوطنية ستكون بحاجة ماسة إلى معلومات تفصيلية عن واقع العراق الاقتصادي والاجتماعي وإلى رؤية واقعية وصحيحة إلى رؤية ديناميكية للإمكانيات المتوفرة في البلاد من النواحي المالية والفنية والكوادر العلمية والفنية والإدارية والعلاقات العربية والإقليمية والدولية..الخ في حالة حركتها والتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها وان تضع أكثر من احتمال ثم تحاول استخدام عملية التقريب المتتابع للوصول إلى النموذج الأكثر قرباً للواقع القائم والمتغير. ويدخل في التأثير على هذا الأمر الموقف من قضايا مهمة منها مثلاً النموذج الاقتصادي الذي تسعى إليه النخب الحاكمة والموقف من التصنيع والزراعة وبقية القطاعات, وكذلك الموقف من التنمية البشرية ومن البحث العلمي ومن القطاعين الخاص والعام والقطاع الأجنبي …الخ. وأسمح لنفسي أن أجزم بأن الحكومات الثلاث المنصرمة (علاوي والجعفري والمالكي) لم تكن لديها, كما إن حكومة المالكي الحالية ليست لديها رؤية علمية وواقعية لما يفترض أن تكون عليه إستراتيجية التنمية الاقتصادية والبشرية, ولكن لدى الكثير من الحكام والعاملين في الحكومة وأجهزة الدولة قدرة فعلية خارقة على أساليب وأدوات الاغتناء على حساب المال العام. وهي مشكلة أخرى ترتبط بدورها بالفقرة السابقة, بالطبيعة الاجتماعية للفئات الحاكمة والذهنية التي يتعاملون بها مع الشعب العراقي ومع ثروة البلاد.
وحين توضع إستراتيجية للتنمية الوطنية يفترض أن يؤخذ بنظر الاعتبار الثروة الخامية المتوفرة في البلاد, أي النفط الخام والغاز المصاحب بشكل خاص, إضافة إلى موارد أولية أخرى والموارد البشرية والقدرات العلمية والفنية المتوفرة. وعليه يفترض أن يعتمد المخطط للاقتصاد العراقي على النفط الخام, كمادة أولية, وعلى موارده المالية في التنمية الاقتصادية وتغيير بنية الاقتصاد خلال 25 سنة القادمة. ويمكن العودة في هذا الصدد إلى مجموعة من مقالات الدكتور صبري زاير السعدي ودراسات مهمة لأخوة آخرين.
ولا بد لنا وبالرغم من الأوضاع المرتبكة الراهنة في العلاقات بين العراق والدول المجاورة والعراق والدول العربية, فأن أي إستراتيجية تنموية في العراق يفترض فيها أن تأخذ بالاعتبار التعاون والتنسيق العربي والإقليمي, لأسباب ترتبط بمجموعة من العوامل, سواء أكانت من حيث مستوى التقنيات وحجم رؤوس الأموال وحجم الإنتاج ومستوى الإنتاجية والتكاليف والقدرة على التسويق, خاصة وان العراق يعيش في عصر يزداد عولمة من سنة إلى أخرى ويفترض أن لا ينسى ذلك بغض النظر عن الملاحظات التي يفترض أن توضع على واقع سياسات العولمة الجارية من جانب الدول الرأسمالية المتقدمة التي لا تصب في صالح الدول النامية ومنها العراق, وبشكل خاص من خلال سياسات المؤسسات المالية الدولية ونموذجها للتنمية, تلك المؤسسات التي يتصدرها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية الحرة.
هناك الكثير من المسائل التي يفترض أن نتطرق إليها في مجال إستراتيجية التنمية, ولكني أكتفي بالإشارة السريعة إلى مسألة تعتبر أساسية بالنسبة للعراق في ضوء عواقب الحروب التي خاضها العراق والتي استخدم فيها السلاح الكيماوي من جانب النظام العراقي وعتاد مشع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت إلى تلوث شديد للمياه والأرض والإنسان. وقد ظهرت أمراض خبيثة عديدة في العراق, وخاصة في جنوبه. ولهذا لا بد للعراق وهو يضع إستراتيجية تنموية أن يفكر بالتنمية الاقتصادية, وباقتصاد النفط الإستخراجي والتصنيعي, التي تقترن بحماية فعلية للبيئة من التلوث بمختلف احتمالاته, وأخص بالذكر هنا موضوع التنمية الصناعية والزراعية بما يحقق التوافق المناسب والمطلوب بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والطبيعة. إذ بدون ذلك سيتعرض العراق لمشكلات بيئية كثيرة تعرض حياة البشر إلى أخطار كبيرة, كما سيصرف أضعاف ما يصرفه من أموال على التنمية من أجل إعادة تنظيف البيئة التي يصعب عندها تنظيفها من التلوث. إنها عملية ضرورية ما دام الإنسان يريد أن يعيش على الأرض العراقية وينعم بثرواتها الخامية ويبعد عن أجياله الحالية والقادمة أعباء الأمراض الخطيرة والموت المبكر والخسائر المالية الكبيرة بسبب تلوث البيئة.
انتهت الحلقة الأولى وستليها الحلقة الثانية.
19/5/2011 كاظم حبيب
قراءة ومناقشة “خارطة طريق اقتصادية” للسيد الدكتور محمد علي زيني
الحلقة الثانية
3 . اقتصاد السوق
يقدم الأخ الدكتور محمد على زيني اقتصاد السوق الحر باعتباره النموذج الملائم لبناء الاقتصاد العراقي وتطوير المجتمع. ويؤكد هذا الاختيار في كل صفحة من هذه الدراسة تقريباً. ويمكن متابعة ذلك في الحلقتين الثانية والثالثة على نحو خاص, ولكن القارئ يجدها في كل الحلقات الأخرى وبصيغ مختلفة.
حين انتهيت من قراءة هذه الدراسة المهمة اقتنعت بأن الزميل قد اختار هذا النموذج عن قناعة, وإلا لما احتاج إلى تأكيد هذا الخيار بهذه الغزارة في التكرار. ولا أشك, بل وأتفق معه, بأن الفترة الراهنة تتطلب اختيار اقتصاد السوق باعتباره يمثل مرحلة مهمة من مراحل التطور الاقتصادي في مجتمع ما زال يعاني من بقايا العلاقات الإنتاجية ما قبل الرأسمالية بحدود كبيرة بعد أن أعادته سياسات البعث البائسة وحروبه العدوانية واستبداده المشين إلى الوراء, إلى ما قبل مرحلة إقامة مجموعة من الصناعات في العراق. وهو بالتحديد ما هدد ووعد به جيمس بيكر, وزير الخارجية الأمريكي, النظام العراقي حين رفض الدكتاتور صدام حسين على لسان طارق عزيز وبعنجهية فارغة طلب مجلس الأمن الدولي بالانسحاب من الكويت في العام 1991 وأصر على مواصلة الاحتلال وتعرض لذلك الانكسار العسكري والسياسي وتدمير البنية التحتية والصناعات الوطنية وما ارتكبه النظام من جرائم بشعة في أعقاب انتفاضة الشعب في ربيع نفس العام. ولكن الذي استوقفني في الدراسة تلك المواصفات التي قدمها الزميل زيني لاقتصاد السوق وشدد عليها وكأنها الصيغة الوحيدة المقبولة في اقتصاد السوق, بحيث اقترب بالفكرة كثيراً من مفهوم اللبرالية الجديدة وإلى حد التطابق تقريباً, وأن لم يذكر هذا المفهوم بالاسم, إذ أن المواصفات التي اختارها هي التي تسمح بتحديد هذه الوجهة. أرجو أن أكون مخطئاً في هذا الاستنتاج.
لقد برهنت العقود الثلاثة الأخيرة على فشل ذريع لسياسات اللبرالية الجديدة على الصعيد العالمي وكلفت العالم خسائر مادية وبشرية فادحة مما دفع بالكثير من الدول إلى التخلي عنها سياسياً واقتصادياً. ولهذا أرى بأن هذا التوجه نحو اقتصاد السوق بمفهوم اللبرالية الجديدة غير مناسب للعراق. وقد تسبب بالنسبة للبلدان التي انتهجته بالكثير من المنغصات والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية. وكانت عواقبه سلبية على الغالبية العظمى من شعوب البلدان التي أخذت به وسارت عليه. وعلينا أن نتذكر سياسة الضربات الاستباقية التي مارستها إدارة بوش الأب وبوش الابن والتي اقترنت بإنزال الضربات الاستباقية العسكرية بـ “العدو المحتمل” وفرض سياسة الحصار الاقتصادي والمقاطعة الاقتصادية كأسلوب لممارسة التهديد بهدف تحقيق مصالح الولايات المتحدة. وقد دشَّنت الإدارة الأمريكية هذه السياسة في زمن بوش الأب ومن ثم واصلها بوش الابن, إضافة إلى المضاربات في الأسواق المالية التي تسببت في وقوع خسائر فادحة لعدد كبير من الدول في أمريكا الجنوبية وفي جنوب شرق آسيا, إضافة إلى النموذج السيئ الذي ما زال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يروجان له ويقدمانه إلى البلدان النامية منذ أكثر من ثلاثة عقود باعتباره النموذج الأفضل للأخذ به في بناء اقتصادياتها الوطنية, وهي السياسة التي مارستها الإدارة الأمريكية وبريطانيا منذ عهد إليزابيث تاتشر ورونالد ريگن في العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية والتي اقترنت أيضاً بأزمات مالية ومن ثم اقتصادية كبيرة في أمريكا اللاتينية وفي جنوب شرق آسيا. وأخيراً وليس آخرا بروز مظاهر الأزمة المالية والاقتصادية منذ العام 2007 والتي بدأت تزحف تدريجاً وتتفاقم حتى انفجرت في العامين 2009 و2010 التي ما يزال الاقتصاد الدولي يعاني من عواقبها, وخاصة اقتصاديات شعوب الدول النامية وتلك الاقتصاديات الضعيفة في الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن نتلمسها في تفاقم الأزمة المالية والنقدية لليونان والبرتغال واسبانيا, وربما ستلحق بها بعض الدول الأخرى, على الرغم من الحجم الكبير جداً من الأموال التي ضخت وما تزال تضخ إلى هذه الدول لتدارك انهيارها الاقتصادي الكامل. وكل هذه الدعم المالي لم يحقق حتى الآن نتائج كبيرة ومهمة وسوف يكلفها غالياً الآن وفي المستقبل وسيتسبب في بروز تناقضات ونشوء صراعات سياسية واجتماعية غاية في التعقيد والحدة والتوتر في البلدان المذكورة وفي غيرها نتيجة ممارسة سياسات تقشفية بدأت بها وهي موجهة في الغالب الأعم ضد الفئات المنتجة للخيرات المادية والكادحة والفقيرة. ويمكن متابعة المظاهرات الشعبية في اليونان وإسبانيا والبرتغال التي تحتج على التقشف الموجه أساساً ضد الفئات الكادحة والفقيرة.
إنها الأزمة الخانقة التي فجرتها سياسات اللبرالية الجديدة, أي سياسات الاحتكارات الأمريكية في سوق العقارات والمضاربات العقارية وفي سياسات المصارف الأمريكية عموماً والعقارية منها بشكل خاص, ولكنها في المحصلة النهائية عمت الأزمة المالية والاقتصادية العالم كله ولم تنته بعد.
ومع ذلك فأن اختيار الأخ الدكتور محمد علي زيني لاقتصاد السوق الحر ليُمارس في العراق على وفق المواصفات التي حددها يبقى موضع احترامي, رغم اختلافي معه بشأن تلك الماصفات, وسأبدي رأيي في أسباب رفض بعض المواصفات المقترحة.
من حيث المبدأ أود أن أشير إلى ثلاث ملاحظات مبدئية في ضوء إشارة الدكتور زيني حول اقتصاد السوق الحر ودفاعه الشديد عنه واعتبار الاقتصاد الاشتراكي في الإنتاج قد فشل, إذ كتب ما يلي:
“وغني عن القول أن الاقتصاد الاشتراكي، بخصوص عمليات الإنتاج، فشل في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن العراق، وأصبح الآن ضرورياً تفكيك معظم القطاع العام الفاشل، وفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بمهمة الإنتاج.” (راجع الحلقة الثالثة من دراسة خارطة الطريق). وتتلخص ملاحظاتي بما يلي:
1. إن الرأسمالية ليست نهاية التاريخ ولا يمكن أن تكون كذلك. وحين أصدر فرنسيس فوكوياما كتابه الشهير “نهاية التاريخ وخاتم البشر” (مركز الأهرام, القاهرة 1993) في إشارة منه لفشل التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي وبقية دول أوروبا الشرقية واعتبار ذلك انتصاراً حاسماً للرأسمالية وللفكر الرأسمالي على الفكر الاشتراكي, وأن ليس هناك من نظام آخر غير النظام الرأسمالي الديمقراطي فهو نهاية التاريخ ولا تاريخ بعده. ولكن سرعان ما اضطر فوكوياما تحت ضغط الواقع والرؤية الموضوعية لجدلية الحياة والتحولات الاجتماعية وحركة التاريخ إلى التراجع عن تلك النظرية المتعجلة واعترف بخطأ مقولته غير العلمية. وعليه فأن الرأسمالية ليست نهاية التاريخ, بل سيبقى المجتمع البشري يناضل من أجل تحقيق حلم الإنسان وهدفه الرفيع في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية, بغض النظر عن التسمية.
2 . إن سقوط النظم الاشتراكية التي كانت قائمة في الواقع لا يعني في الجوهر: ** إن الفكر الاشتراكي أو فكرة العدالة الاجتماعية سقطت بسقوط تلك التجارب التي شهدها القرن العشرين من جهة, وإن سقوط تلك النظم السياسية وتجاربها لا يعني بأي حال انتصار الفكر الرأسمالي على الفكر الاشتراكي, أو الرأسمالية على الاشتراكية, بل هو سقوط لتلك النظم السياسية التي لم تستطع بناء الاشتراكية لأسباب موضوعية وذاتية. ويمكن الإشارة هنا وبسرعة إلى اقتصاديات ومجتمعات روسيا القيصرية وفي ما بعد دول أوروبا الشرقية والصين الشعبية وكوبا وكذلك الوعي الاجتماعي العام لم تكن ناضجة ولا تمتلك القاعدة المادية لبناء الاشتراكية. يضاف إلى ذلك الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها تلك النظم في الموقف من الحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان, وفرض سياسات وإجراءات لا تتناغم مع القوانين الاقتصادية الموضوعيةو إضافة إلى تفاقم البيروقراطية والهيمنة الحزبية وغياب التعددية الفكرية والسياسية وانتشار الفساد الذي ساد هذه البلدان .. الخ. وقد نتج عن كل ذلك تلك الثمار المرة, إذ نشأت عنها تلك النظم السياسية ذات النهج الشمولي التي فقدت تدريجاً القيم الإنسانية التي بدأت بها ثورة أكتوبر في العام 1917 وسعت لتطبيقها. وهو ما حصل أيضاً بالنسبة للنظم الديمقراطية الشعبية التي أقيمت في أعقاب الحرب العالمية الثانية في أوروبا الشرقية والصين وكوريا وكوبا, وهي التي أودت بتلك النظم, أي الخراب الداخلي بشكل خاص.
3 . إن اقتصاد السوق الحر في مرحلة العولمة الرأسمالية الجارية وممارسة سياسة اللبرالية الجديدة وفي ظل سياسات المحافظين الجدد قد قاد إلى عواقب وخيمة في الدول الرأسمالية المتطورة, دعْ عنك العواقب السلبية لذلك على الدول النامية. وابرز تلك العواقب ليست الأزمات الاقتصادية الدورية ولا الأزمات العامة والبنيوية التي أصابت حتى الآن النظام الرأسمالي العالمي فحسب, بل في استمرار حركة وفعل القوانين الاقتصادية الموضوعية التي عمقت دون انقطاع التناقضات الاجتماعية والمقترنة بمجموعة من الظواهر الملازمة لفعل تلك القوانين والتي هي نتاج التفاوت في مستويات التطور العلمي والتقني والإنتاج والإنتاجية في البلدان المختلفة وبسبب التباين بين مستويات تطور القطاعات الاقتصادية في ضوء حركة وفعل “قانون التطور المتفاوت” للرأسمالية, وكذلك بسبب تفاقم الفجوة في مستويات الدخل والمعيشة وظروف العمل والحياة بين طبقات وفئات المجتمع نتيجة حركة وفعل قانون القيمة وبقية القوانين الاقتصادية للرأسمالية. ونظرة واحدة على تقارير البنك الدولي وتقارير التنمية الدولية تمنح المتتبع معرفة دقيقة عن سعة الفجوة بين معدل حصة الفرد الواحد من الدخل القومي سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية أو في غيرها من الدول المتقدمة ومعدله في القسم الأكبر من الدول النامية. يضاف إلى ذلك تفاقم البطالة المكشوفة وجيش العاطلين وتفاقم المضاربات المالية على حساب المجتمع والاقتصاديات الوطنية للشعوب الأخرى.
لقد أشرت إلى هذه الملاحظات لا لإقناع الدكتور محمد علي زيني بسوءات النظام الرأسمالي, فهو كاقتصادي وباحث علمي يعرف ذلك جيداً, بل لمن يعتقد بأن الرأسمالية هي الخيار الأول والأخير لشعوب الدول النامية, ومنها العراق, وبأمل أن لا نرتكب خطأ الاعتقاد بأن الرأسمالية هي نهاية التاريخ لشعوب العالم, فهي ليست كذلك. ولكنها هي الخيار الراهن ولفترة غير قصيرة. وإذا ما ابتعدنا عن هذه الموضوعة, عندها يمكن البحث في موضوع اقتصاد السوق بالنسبة للدول النامية, وبالنسبة للعراق أيضاً باعتباره مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي.
كلنا يعرف بأن اقتصاد السوق له قوانينه الاقتصادية الموضوعية التي تنطلق من طبيعة علاقات الإنتاج الرأسمالية التي تتميز بها وتسود في مجتمعاتها وتتحكم بتطورها, وهي من حيث المبدأ واحدة على الصعيد العالمي وفعلها ونتائج فعلها من حيث المبدأ ومن حيث الوجهة العامة واحدة, ولكن حركة وفعل ونتائج فعل هذه القوانين ترتبط بشكل ملموس مع مستوى تطور علاقات الإنتاج الرأسمالية في هذا البلد أو ذاك وطبيعة السياسات التي تمارسها كل دولة, إضافة إلى مستوى تطور حركة النضال الشعبي في الدفاع عن مصالح الشعب في مواجهة رغبة تشديد الاستغلال لدى الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج, المالكة لرأس المال. فقانون فائض القيمة هو القانون الأساسي والرئيسي المتحكم في النظام الرأسمالي, ولكنه يعمل مع مجموعة كبيرة من القوانين الاقتصادية الموضوعية الأخرى, وهي علاقة جدلية ناشئة عن العلاقة القائمة بين العمل ورأس المال, أي بين العامل, الذي يبيع قوة عمله لصاحب رأس المال ليستخدمها في إنتاج السلع المادية والروحية, وبين البرجوازي المالك لرأس المال الذي يشتري قوة العمل في سوق العمل لتنتج له السلع المادية والروحية التي تنتج عبر عملية الإنتاج السلع المادية التي تتضمن مكونات الإنتاج, الأجر وتكاليف وسائل الإنتاج وفائض القيمة. القيمة الزائدة التي أنتجها العمل الأجير والتي لا تعود لمنتجها بل تصبح من نصيب صاحب رأس المال هي الجزء المغني للثروة الوطنية. ففعل هذا القانون واحد في جميع الدول التي يسودها النظام الرأسمالي ويتسبب في حصول الاستغلال عند تقسيم الدخل القومي بين الأجر وفائض القيمة (الربح والفائدة والريع). وكذا الحال مع بقية القوانين الاقتصادية الموضوعية للرأسمالية. إنها تشكل الثروة الجديدة المضافة لثروة المجتمع التي تنشأ بفعل عمل المنتجين. أين يبرز الاختلاف ما دمنا نتحدث عن الفعل الواحد للقوانين الاقتصادية في الرأسمالية؟
الاختلاف في فعل القوانين الاقتصادية الموضوعية للرأسمالية يبرز لأسباب أربعة:
1) بسبب التباين الكبير بين مستوى تطور علاقات الإنتاج الرأسمالية السائدة في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الاتحادية مثلاً من جهة, ومستوى تطور هذه العلاقات الإنتاجية في دول مثل العراق وسوريا والمغرب على سبيل المثال لا الحصر, من جهة ثانية.
2) وبسبب طبيعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعات التي تضعها النظم السياسية الحاكمة المعبرة عن مصالح مالكي وسائل الإنتاج أو رأس المال.
3) وبسبب قوة أو ضعف الحركة النقابية والعمالية والحركة المطلبية لمنتجي الخيرات المادية والروحية وقدرتها على خلق توازن معين أو ميل لصالحها أو تعجز عن ذلك فيكون الميل لصالح أصحاب رؤوس الأموال. إنها التناقض والصراع بين العمل ورأس المال.
4) بسبب التباين في النظم السياسية التي تقود هذه البلدان, هل هي ديمقراطية ودستورية أم اتسبدادية تغيب عنها الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
أشرت إلى إن الرأسمالية واحدة من حيث الجوهر ولكن عند تطبيقها في الدول المختلفة تظهر للمتتبع إن المسألة ليست ذات لون رمادي واحدٍ بل هي ذات ألوان عدة, يمكن للشعب والمشرع أو الحكم اختيار اللون الذي يناسب مستوى تطور هذا البلد أو ذاك, أي على وفق المرحلة التي تمر بها البلاد. وللتدليل على صواب ما أقول حول التفاوت في النظم السياسية للرأسمالية, وإنها في الواقع العملي ليست بلون واحد أورد المثال التالي: دول المحور الثلاث (ألمانيا وإيطاليا واليابان) التي شاركت في الحرب العالمية الثانية سادت فيها العلاقات الإنتاجية الرأسمالية, وكانت النظم السياسية السائدة فيها نازية وفاشية وعسكرية على التوالي. وفي المقابل سادت في معسكر الحلفاء العلاقات الإنتاجية الرأسمالية أيضاً مثل بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وكانت كلها نظماً سياسية ديمقراطية, إضافة إلى التحاق الاتحاد السوفييتي بها بعد بدء ألمانيا الهتلرية بغزو الأراضي السوفييتية.
ومن هنا فالتعامل مع اقتصاد السوق يفترض أن يختلف من بلد إلى آخر على وفق السياسة الاقتصادية للبلد المعني. فالعراق الذي يعاني من التخلف والتبعية الاقتصادية في مجمل العملية الاقتصادية, عملية إعادة الإنتاج, ويعتمد على الصادرات النفطية في تكوين القسم الأعظم من دخله القومي وعلى صرف القسم الأكبر من هذا الدخل على أغراض الاستيراد السلعي والخدمي لإشباع حاجات المجتمع, يفترض أن يختلف في تعامله مع اقتصاد السوق وآلياته وقوانينه عن بلد آخر مثل بريطانيا أو ألمانيا الاتحادية أو الولايات المتحدة أو غيرها. ولهذا, وبما أن العراق لا بد له أن يختار اقتصاد السوق في هذه المرحلة من تطوره الاقتصادي والاجتماعي ومستلزمات نهوضه موضوعياً, كما أرى, فإن عليه أن يحدد بشكل دقيق ماذا يريد من اقتصاد السوق وما هو اللون الذي يفترض فيه أن يستقر عليه ويستفيد منه لصالح تعجيل تطوره ولفترة غير قصيرة. وهذا الأمر لا يمس العراق فحسب, بل يمس جميع الدول النامية التي تجد نفسها في وضع مقارب للعراق أو إنها تحتلُ مواقع متخلفة على التخوم (المحيط) إذ إنها ستبقى طويلاً في إطار تقسيم العمل الاجتماعي الرأسمالي الدولي وتدور حول أو في فلك الدول الرأسمالية المتقدمة, المراكز الرأسمالية الثلاثة, الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان, التي يمكن أن تتسع في الفترة القادمة لتضم إليها الصين وروسيا مثلاً. وسيحتاج العراق سنوات طويلة للخروج من هذا الموقع المختل وسياسات أخرى غير التي تمارس اليوم وقوى أخرى غير التي تحكم اليوم.
وإذ نتفق جميعاً بأن العراق, كما هو حال أغلب البلدان النامية, بلد متخلف اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً وبيئياً, إضافة إلى كونه يعاني من علل نفسية عديدة نشأت عن معاناة طويلة الأمد تحت وطأة الاستبداد الشمولي والقمع والقسوة والحروب والحصار الدولي ومن ثم الخوف الدائم من الموت المتربص بالإنسان العراقي حتى الآن بسبب المحاصصة الطائفية والإرهاب والصراعات على المناصب والفساد السائد, كما لم يصل إليه التنوير الديني والاجتماعي والثقافي وتعشش فيه الأمية بنسبة عالية وخاصة بين النساء, رغم أن فيه الكثير من المثقفين والكوادر الفنية والعلمية المتخصصة والمتقدمة. ولا شك في أن القارئة والقارئ يميزان بين هاتين المسألتين.
وعليه فأن المهمة التي تواجه المجتمع هي حشد كل الطاقات والإمكانيات المتوفرة والكامنة الداخلية منها والخارجية لتنظيم وبرمجة عملية الخلاص من هذا التخلف الفكري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتنويري ..الخ الذي تعرض له الدكتور زيني بشكل واضح وسليم.
إلا إن الخلاص من هذا الواقع يتطلب منا جميعاً رؤية واقعية تكشف عن المشكلات التي يواجهها العراق في المرحلة الراهنة بصورة ملموسة والتي هي نتيجة تراكمات السياسات الاقتصادية والاجتماعية السابقة والحالية. وبسبب تلك التراكمات والواقع الراهن ارتد العراق على مدى العقود الخمسة المنصرمة صوب العلاقات العشائرية وعاداتها وتقاليدها لا في الريف فحسب, بل وفي المدينة وفي علاقات النظام السياسي أو نظام الحكم البعثي الصدَّامي بشكل خاص مع المجتمع, كما تم التراجع عن الإصلاح الزراعي الديمقراطي الذي سن في العام 1958 واستكمل في العام 1970, فعادت علاقات الملكية الكبيرة إلى الريف وعاد كبار الملاكين إلى ممارسة دورهم القديم مقترناً بكونهم شيوخ عشائر أيضاً. ماذا يعني ذلك؟ إن هذا يعني بوضوح إن أمام المجتمع مهمة التخلص من بقايا العلاقات ما قبل الرأسمالية في الريف وتداعياتها وتجلياتها في علاقات المدينة وخاصة في المناطق التي بنيت عشوائياً والتي امتلأت بالفلاحين الفقراء الذين نزحوا من الريف والزراعة إلى المدنية وعاشوا على هامش الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية, والكثير من شبيبتهم قد جند في الجيش أو أجهزة الأمن والمخابرات والشرطة والحرس الجمهوري في فترة حكم البعث وما بعدها أيضاً. كما تعني هذه المهمة إقامة العلاقات الإنتاجية الرأسمالية, أي الأخذ باقتصاد السوق. وهذا يعني بالضرورة, ولكي لا نفهم خطأ, إن العراق لا يقف اليوم أمام مهمة بناء اشتراكي بأي حال, بل هو أمام تنمية اقتصادية مستدامة ما تزال وستبقى لفترة طويلة أمام مهمة بناء العلاقات الإنتاجية الرأسمالية. وإذا كان هذا الرأي صحيحاً, وهو ما أشار إليه الزميل الدكتور زيني, فأين هو الاختلاف؟ أي ماذا يعني اقتصاد السوق في ظروف وأوضاع بلدان مثل العراق, أو أي اقتصاد سوق يفترض أن يسعى إليه العراق في المرحلة الراهنة.
أود هنا أن أؤكد رأيي الذي أشرت إليه في مقالات سابقة بأن جمهرة كبيرة من اقتصاديي العراق, وأنا أحدهم, قد انقسمنا في الماضي إلى مجموعتين, إحداهما كانت, وربما ما تزال, تدعو إلى اقتصاد يقترب في ملامحه من الاقتصاد الذي ساد في الدول الاشتراكية, والأخرى كانت, وربما ما تزال حتى الآن, تدعو إلى اقتصاد يقترب من ملامح الاقتصاد الرأسمالي في بريطانيا والولايات المتحدة. وكلانا كان على خطأ كبير, إذ أن النموذجين كانا لا يعبران عن واقع الحال في العراق ولا عن إمكانيات تنفيذ أحد النموذجين ولا يتناغمان مع واقع وإمكانيات وحاجات البلاد. ولكن كانت هناك مجموعة من الاقتصاديين التي كانت لها رؤية واقعية حول سبل تنمية وتطوير الاقتصاد والمجتمع في العراق.
نحن بحاجة إلى تجاوز الواقع المتخلف وبناء اقتصاد عراقي يمتلك ديناميكية ذاتية أو داخلية للتطور. وهذا ممكن من خلال إحلال العلاقات الإنتاجية الرأسمالية محل العلاقات الإنتاجية ما قبل الرأسمالية التي ما تزال قائمة في العراق ولكن مع اختلاف في البعض من تلك المواصفات التي يطرحها السيد الدكتور زيني. فلو نظرنا إلى ما يسعى إليه الدكتور زيني سنجد إنه يدعو إلى اقتصاد سوق يعتمد كلية على القطاع الخاص ويلغي كلية دور قطاع الدولة في عملية التصنيع التحويلية وأن يكتفي بدور “المراقب” مرة و “الحكم” مرة أخرى, كما يريد انفتاحاً تجارياً كاملاً على الأسواق العالمية ومنافسة تامة مع تلك الأسواق التي تعني في ظروف العراق الملموسة تهيئة التابوت للصناعة الوطنية التحويلية, كما يدعو إلى فتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الأجنبية بشكل تام على وفق ما جاء في الدراسة, دون توجيهها صوب قطاعات بعينها يحتاجها العراق أكثر من غيرها ووفق قواعد وشروط معينة. إنه يدعو إلى الانفتاح الاقتصادي الكامل الذي, كما أرى, سيغلق الأبواب بوجه التطور الاقتصادي, وخاصة الصناعة الوطنية, وسيرفع من حجم البطالة ويزيد من جيش العاطلين عن العمل, خاصة وأن معدلات النمو السكانية هي أعلى من معدلات نمو الإنتاج. إن دعوته للتصنيع المحلي لإغراض التصدير سوف تصطدم مباشرة مع سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري الكاملين على العالم, أي الانفتاح على الاستيراد والبقاء في إطار تصدير النفط عملياً رغم إنه لم يقل ذلك صراحة بل هي حصيلة الوجهة التي يقترحها, إذ إنها ستقود أكثر فأكثر إلى ذلك, شاء الإنسان أم أبى, رغم دعوة الزميل زيني المهمة والواضحة والمتكررة لتطوير الاقتصاد الوطني وتصنيع العراق وتنويع مصادر الدخل القومي.
التكملة في الحلقة الثالثة.
22/5/2011 كاظم حبيب
قراءة ومناقشة “خارطة طريق اقتصادية” للسيد الدكتور محمد علي زيني
الحلقة الثالثة
اقتصاد السوق الاجتماعي
العراق في مرحلة تطوره الراهنة ولمدى طويل لاحق سوف يستند ملزماً إلى اقتصاد السوق. ولكن أي اقتصاد سوق نحتاجه وما هي مواصفاته؟
أشرت إلى أني أقف في هذه المرحلة مع اقتصاد السوق الذي يجمع بين الحرية النسبية والمشاركة الحكومية في التنمية, إضافة إلى الرقابة الحكومية, وكذلك مع مجموعة من المسائل الاجتماعية التي تحد من الاستغلال وتخفف من التناقضات وتسيطر على الصراعات ولكي لا تتحمل إلى نزاعات سياسية. وقد أطلق الألمان منذ ستينيات القرن العشرين اسم ” اقتصاد السوق الاجتماعي ” في فترة حين كان لودفيگ ايرهارد مستشار ألمانيا وصاحب “المعجزة الاقتصادية” حينذاك, وهي بخلاف نظرية اللبرالية الجديدة في إطار اقتصاد السوق التي تتسبب في تشديد استغلال الطبقة العاملة بمفهومها الواسع والحديث. لهذا اقترح في ظروف العراق الملموسة أن يؤخذ بمفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يستند إلى عدة أركان هي:
أ ) إعطاء دور متميز وفعال ورئيسي للقطاع الخاص والعمل على تشجيعه ودعمه وتوفير مستلزمات تطور دوره في الاقتصاد العراقي من جانب الدولة.
ب ) إعطاء دور مهم ومخطط لقطاع الدولة في مجمل الاقتصاد العراقي يستكمل دور القطاع الخاص, ويلعب دور المحتكر لقطاع النفط الاستخراجي والتكرير ومشروعات البنية التحتية, بما فيها قطاع الكهرباء والماء, كما يشارك بفعالية وروح تنافسية لإقامة مجموعة من الصناعات التحويلية ذات الأهمية الفائقة للاقتصاد الوطني والمجتمع والتي يصعب على القطاع الخاص النهوض بها وتحمل مسؤولية الاستثمار الكبير فيها مثلاً. ويتطلب هذا الولوج الاقتصادي لقطاع الدولة أن يعمل وفق المعايير الاقتصادية والمحاسبية وآليات السوق الاقتصادي في مجال المنافسة وضبط تكاليف الإنتاج والأسعار والحوافز الاقتصادي للمنتجين والعاملين.
ج ) تنشيط دور القطاعين المختلط والتعاوني للمشاركة في عملية تنمية معجلة وناجحة وداعمة لنشاط القطاع الخاص والدولة والمجتمع وخاصة في مجال الريف والصناعات الصغيرة وذات التقنيات العالية التي يصعب على القطاع الخاص وحده النهوض بها أو يستوجب تجميع المنتجين الصغار في جمعيات تعاونية إنتاجية واستهلاكية.
د ) إن الأخذ باقتصاد السوق الاجتماعي يتطلب بشكل خاص:
** إصدار تشريعات لمنع الاحتكار وتشديد الاستغلال تتجلى في تنظيم المنافسة والضرائب التي تستند على قاعدة الضرائب التصاعدية على الدخل السنوي المباشر للسكان بدلاً من فرض ضرائب غير مباشرة على السلع والخدمات لا تميز بين الناس على أساس دخولهم السنوية ومستوى معيشتهم.
** وضع حد أدنى للأجور ومساواة بين المرأة والرجل في الأجور للأعمال المماثلة.
** وضع تشريعات تؤمن الضمان الصحي والاجتماعي وأثناء الشيخوخة أو العجز والرواتب التقاعدية والعطل السنوية وفي حالات المرض أو الحمل…الخ.
اعتماد قاعدة الضرائب التصاعدية المباشرة على الدخل السنوي للفرد وتقليص كبير للضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع والخدمات.
** العناية بقدر أكبر بقضايا العدالة الاجتماعية وحياة وظروف العمال وتحديد ساعات العمل وضمان التأثير الإيجابي على علاقة تناسب سليمة بين الأجور وفائض القيمة …الخ من خلال نظام الضرائب التصاعدي على الدخل المباشر للفرد.
** تقديم الدعم الحكومي الضروري ولفترة غير قصيرة إلى بعض السلع والخدمات لضمان حصول الفئات الكادحة والفقيرة على احتياجاتها الأساسية مثل الخبز, على سبيل المثال لا الحصر, أو دعم بعض المنتجات الزراعية التي تواجه منافسة حادة في السوق الدولية لضمان الإنتاج في العراق وضرورة توفي الأمن الغذائي.
هـ) أن تلعب النقابات ومنظمات المجتمع المدني دورها الفاعل في المجتمع وفي النضال من أجل حقوق العمال والمستخدمين والعاملين في الإدارة وفي حل الخلافات بين العمل ورأس المال وغير ذلك.
إننا بذلك نستطيع أن نضمن الكثير من الأسس التي لا تسمح بتشديد الصراع الطبقي أو الصراع بين العمل وراس المال لصالح تعجيل التنمية والاستفادة من كل الطاقات المتوفرة في البلاد.
و) لدي القناعة بأن الدول النامية عموماً والعراق على وجه الخصوص لن يكون في مقدوره في المرحلة الراهنة من الناحيتين النظرية والعملية أن يمارس سياسة الباب المفتوح في الاقتصاد ذ إنها ستعطل عملياً وفعلياً القدرة على تطوير الاقتصاد الوطني وعملية التصنيع وتحديث الزراعة بسبب المنافسة غير المتكافئة. ولهذا فأن ضمان الوصول إلى عملية تنمية فعلية مستدامة ومتطورة تستوجب في المرحلة الراهنة إخضاع التجارة الخارجية لخمسة عوامل أساسية, وهي:
* وضعها في خدمة عملية التنمية الصناعية والزراعية والتعليمية والثقافية والبيئية.., أي التنمية الاقتصادية والبشرية ومن أجل تحقيق تراكم عقلاني مستمر للثروة الوطنية.
* الإشباع المناسب لحاجة السوق المحلية للسلع الاستهلاكية وسلع الاستهلاك الدائم مع الاهتمام بنوعية السلع المستوردة.
* كما يفترض أن تلعب الدولة ولسنوات طويلة قادمة دور المنظم والمؤثر إيجاباً على حركة وفعل قانون العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار وخلق توزان عقلاني بينها وبين الأجور والمدخولات السنوية للأفراد والعائلات من ذوي الدخل الواطئ والمحدود, وخاصة بالنسبة لأكثر السلع أهمية وضرورية لنسبة كبيرة جداً من السكان.
* تنويع مصادر الدخل القومي من خلال زيادة دور المنتجات الصناعية والزراعية غير النفط الخام والغاز الطبيعي في إجمالي صادرات العراق.
* السعي لتحقيق التوازن التدريجي في الميزان التجاري العراقي مع الدول المختلفة وبين الصادرات والاستيرادات, والتي يمكن أن تؤثر إيجاباً على ميزان المدفوعات.
اقتصاد السوق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي
عند قراءتي لدراسة الدكتور محمد علي زيني الغنية بالمعلومات لاحظت عدم إشارته إلى المؤسسات المالية الدوليةو ولكنه يشير إلى الاعتماد على الرأسمال الأجنبي. ولا شك في أن هذه المؤسسات هي من أكبر الممولين لرؤوس الأموال في السوق الرأسمالي العالمي. وهذه المؤسسات تطرح شروطها القاسية على الدول المقترضة, كما فعلت مع العراق حين تقرر إعفاء العراق من بعض ديونه الخارجية في أن يلتزم باقتصاد السوق الحر ووفق شروط ومواصفات محددة. ولهذا من المفيد للقارئة والقارئ أن يعودا إلى الحلقتين الثانية والثالثة من الدراسة المذكورة بشكل خاص ليتابعا موقف الدكتور زيني من دور الدولة وقطاعها الاقتصادي ومن التجارة والسوق الاقتصادي الحر. إن الزميل زيني يتبنى دون أن يشير إلى ذلك أهم الشروط التي يطرحها النموذج الذي تقترحه علينا المؤسسات المالية الدولية, الذي, كما أرى, لا ينفع العراق في أغلب جوانبه وفي ضوء الواقع الذي يعيش فيه العراق. وملاحظاتي بهذا الصدد تتلخص في النقاط التالية:
إن فقرات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي المقترح من المؤسسات المالية الدولية لا تتميز بوحدانية الجانب وذات صرامة شديدة لا يمكن ممارستها في العراق بسبب غياب مستلزمات ذلك في العراق وفي البلدان النامية كما إنها لا تأخذ بنظر الاعتبار نقاط جوهرية يمكن الإشارة إليها في ما يلي:
إنها تسقط العلاقة العضوية القائمة بين السياسة والاقتصاد والمجتمع التي يفترض أن تكون لصالح المجتمع ( راجع في هذا الصدد: د. صبري زاير السعدي. الاقتصاد السياسي للتنمية والاندماج في السوق الرأسمالية العالمية. بحث منشور في مجلة المستقبل العربي. يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية. العدد (249) 11/1999. بيروت. ص 31), ولكنها في واقع الأمر تمارس سياسة طبقية صارمة, سياسة تحقق مصالح الدول الرأسمالية المتقدمة ومصالح الفئات الرأسمالية المالكة لوسائل الإنتاج والغنية على التوالي. فهي لا تتجنب الحديث عن الديمقراطية السياسية فحسب, بل تكثر من الحديث عن اللبرالية الاقتصادية وحرية المنافسة, وهي تضعف قدرة الدول النامية على المنافسة والبقاء في السوق الدولية لصالحها, إنها تنسى بكل معنى الكلمة أو تتناسى المصالح الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان لا في الحياة السياسية والاجتماعية فحسب, بل وفي نشاط المؤسسات الاقتصادي والحياة النقابية, إذ ما يهمها يتركز في دمج اقتصاديات وأسواق هذه البلدان بالسوق الدولية وفتح الأبواب أمام نشاط احتكاراتها الدولية. إنها تطالب حكومات هذه البلدان بامتلاك الإرادة السياسية لتنفيذ البرنامج, والذي لا يعني سوى ممارسة سياسة الاستبداد الاقتصادي في تنفيذ سياسات اقتصادية لا تتبناها الغالبية العظمى من السكان ولا تخدم سوى مصلحة أقلية ضئيلة في المجتمع.
إنها تسقط من حسابها مصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة والكادحة التي تحتاج إلى الدعم الحكومي بأشكال مختلفة, خاصة وان العراق قد خرج لتوه من الدكتاتورية وحروبها وقمعها والحصار الاقتصادي, حيث اتسعت وتفاقمت وتعمقت حالات الفقر والحرمان في الأوساط الشعبية وارتفعت نسبة السكان التي تعيش تحت خط الفقر المحدد دولياً. وفي المرحلة الراهنة تطالب هذه المؤسسات بإلغاء “البطاقة التموينية” كلية, ولم تدعو إلى حصرها بالمحتاجين, وهي من الأسباب التي أدت إلى التظاهرات الأخيرة أيضاً.
إنها تنسى الواقع الذي تواجهه هذه البلدان وأهمية وضرورة وجود قطاع حكومي ديناميكي وفعال ومؤهل إداريا وتقنيا ومستقلاً في أداء جملة من مهمات العملية الاقتصادية, خاصة وأن بعضها يمتلك موارد مالية يمكن توجيهها للأغراض التنموية حيث يعجز أو يمتنع القطاع الخاص عن الولوج فيها, إذ أن الدولة بحاجة إلى جزء من الفائض الاقتصادي لتوجهه إلى تلك المشاريع التي لا تتوجه صوبها رؤوس الأموال الخاصة لأي سبب كان, أو من أجل تأمين الدعم الحكومي النسبي للتخفيف من أعباء شدة استغلال رأس المال. (راجع: د. رمزي زكي, اللبرالية المستبدة. سينا للنشر. ط 1. القاهرة. 1993. ص 82-94).
إنها, وهي تدعو إلى تقليص الإنفاق الحكومي, تساهم في تشديد الاختلالات والتناقضات لقائمة حاليا التي تعمق من انقسام المجتمع إلى معسكرين, الأغنياء والفقراء, وتجهز على مواقع الفئات الاجتماعية الوسطى في الإنتاج وتنهي عمليا وجودها على الخارطة الاجتماعية للسكان, ولكنها تسكت كلية عن, أو حتى تشجع على, شراء الأسلحة التي تحمّل ميزانية هذه البلدان موارد مالية كبيرة وتزيد من مديونيتها الخارجية وتشجعها بهذا النهج على حل مشكلاتها الداخلية والإقليمية بالقوة وممارسة العنف والحروب, كما لا ترفض تزويد البلدان النامية بالقروض المالية لأغراض التسلح, وتغفل تماماً الأضرار الناجمة عن ذلك على العملية الاقتصادية وارتفاع المديونية الخارجية والفوائد المترتبة عليها وتدهور الحياة المعيشية والاجتماعية للغالبية العظمى من السكان. وكلنا يعرف العواقب الوخيمة التي تقود إليها هذه الحالة, ومنها مثلاً تقليص الموارد التي تخصص لأغراض التربية والتعليم والثقافة والصحة العامة والنقل …الخ. والشعوب العربية المنتفضة الآن هي نتيجة منطقية لا لسياسات الاستبداد والقهر السياسي فحسب, بل وبسبب تلك السياسات الاقتصادية التي مارستها وما تزال تمارسها الحكومات العربية والمبنية على اقتصاد السوق الحر بمواصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية الحرة, التي لا تغيب عنها العدالة الاجتماعية النسبية فحسب, بل وتشتد البطالة والفقر وتتسع فجوة الدخل السنوي بين الطبقات والفئات الاجتماعية وتركز الثروة بيد فئة صغيرة من المجتمع تحرم منها الغالبية العظمى من السكان التي تقود بدورها إلى تشديد التناقضات الاجتماعية والصراعات السياسية والنزاعات الداخلية وتنتهي إلى ما نحن عليه الآن بعد أن أدركت الشعوب في الدول العربية إن عليها أن تأخذ مصيرها بنفسها وتتحكم بمستقبلها.
من هذا يتبين للقارئة والقارئ بأني إذ أتفق من حيث المبدأ وفي المرحلة الراهنة مع زميلي الفاضل الدكتور زيني في مسألة الأخذ باقتصاد السوق, أي بناء العلاقات الإنتاجية الرأسمالية التي لا مفر منها مرحلياً, ولكني أختلف معه في السبيل الذي يفترض أن نسلكه في إطار العلاقات الإنتاجية الرأسمالية للوصول إلى ما هو أفضل للعراق. أتمنى أن يساهم النقاش الفكري الموضوعي الهادف, كما تعودنا عليه في دراسات الزميل زيني, في الوصول إلى رؤية مشتركة أو متقاربة حول هذه الأمور التي تزداد أهميتها للمجتمع العراقي, خاصة ونحن معاً نحمل الهمَّ العراقي بمشكلاته وطموحاته وآفاق تطوره.
انتهت الحلقة الثالثة وتليها الحلقة الرابعة.
21/5/2011 كاظم حبيب
قراءة ومناقشة “خارطة طريق اقتصادية” للسيد الدكتور محمد علي زيني
الحلقة الرابعة
4 . حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد العراقي
الدكتور محمد علي زيني يتبنى في دراسته المحمودة ” خارطة طريق اقتصادية ” للعراق من الناحيتين النظرية والعملية تلك الفكرة التي تدعو إلى ابتعاد الدولة كلية عن أي نشاط اقتصادي إنتاجي وترك هذا المجال كلية للقطاع الخاص المحلي. وخص الدولة بدور “الرقابة” و “التحكيم”, إذ كتب:
”إن أهم درس خرجت به تجارب التطور الاقتصادي في مختلف دول العالم النامية هو تحديد العلاقة بين الدولة والسوق، أو بعبارة أخرى بين الحكومة والقطاع الخاص. وهذا الدرس يشير إلى أن عملية التطور الاقتصادي ستحقق النجاح عندما يكون دور الحكومة مكملاً لدور السوق وليس متضارباً معه”. ويحدد دور الحكومة المكمل لدور السوق على النحو التالي:
”ويكون دور الحكومة مكملاً لدور السوق (القطاع الخاص) عندما تتبنى الحكومة سياسة ودية نحو السوق (Market-friendly Approach) فتدع السوق تعمل بحرية حينما تنجح وتتدخل حينما تفشل. ولقد دلت التجارب على أن السوق إذ تنجح نجاحاً باهراً في الأنشطة الإنتاجية فإنها تفشل فشلاً ذريعاً في بناء البنية التحتية )المادية والبشرية( وحماية البيئة وتوفير الصحة العامة وفي كل مجال لا تحقق به أرباحاً مباشرة.” وبناء على ذلك يستنتج الدكتور زيني الموقف التالي الذي يفترض أن تمارسه الحكومة:
”إن هذا الدرس المهم يدعو الحكومة إلى أن تتخذ دور السند والداعم للقطاع الخاص بأن تركز جهودها في توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات وبناء البنية التحتية والعناية بالصحة العامة وحماية البيئة ونشر التعليم وتشجيع البحوث وتمويلها، وكذلك التدخل في شتى المجالات الحيوية الأخرى التي ينحسر فيها نشاط القطاع الخاص، أو أن يكون فيها نشاطه معارضاً لما يتطلبه الصالح العام، إذ يتعين على الحكومة هنا أن تتبنى دوراً رقابياً فاعلاً على أنشطة القطاع الخاص منعاً للاحتكار والانحراف والاستغلال المضر بمصالح المواطنين والدولة.” ولا يكتفي بهذا بل يصر على توضيح أدق لموقفه فيؤكد:
”ويدعو هذا الدرس، من جهة أخرى، الحكومة أن تبتعد عن الأنشطة الإنتاجية التي هي من صميم اختصاص القطاع الخاص، كإنتاج السلع الالكترونية والأنسجة والاسمنت والأحذية والحديد والصلب وإدارة الفنادق والإنتاج الزراعي، وغير ذلك من الأنشطة التي يحسنها القطاع الخاص ويتفوق بها عندما يتوفر له المناخ الملائم.” (راجع: جميع هذه المقتطفات مأخوذة من نص الحلقة الثالث من “خارة طريق اقتصادية”).
اخترت هذا المقاطع الطويلة نسبياً لأحدد بوضوح رؤية الزميل زيني من جهة, وابتعد عن تكرار إيراد مقاطع أخرى في الدراسة تشير إلى ذات الفكرة الرئيسة التي يرى إنها المعبرة عن جوهر اقتصاد السوق من جهة أخرى.
بعد أن انتهيت من القراءة الثانية للمادة التي نالت إعجابي بشكل عام , ولكنها أثارت عندي الإحساس بأن الراديكالية التي كانت تدعو إلى هيمنة كاملة لقطاع الدولة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي, قوبلت حينذاك, وأصبحت اليوم تقابل براديكالية أشد تدعو إلى هيمنة كاملة للقطاع الخاص على العملية الاقتصادية, ولكن وبشكل خاص على القطاع الإنتاجي, في العراق, رغم إن الزميل زيني لا يتميز بالتطرف في أطروحاته السياسية والاقتصادية , بل يتسم بالموضوعية والاعتدال.
إن الدراسة الغنية للدكتور محمد علي زيني قد أوحت لي أيضاً ودون أدنى ريب بأن العراق بحاجة تامة إلى نشاط واسع واستثمار كل الإمكانيات والطاقات المتاحة, سواء المتوفرة منها في الداخل أم التي يمكن استيرادها من الخارج, لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة والخلاص من التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المريع الذي يعيش فيه المجتمع العراقي. وإذا كان هذا الإيحاء صحيحاً وفي ظل اقتصاد السوق, فليس هناك من الناحيتين النظرية والعملية أي مانع, وبخلاف ما يطالبنا به الدكتور زيني, من استخدام كل القطاعات الاقتصادية من حيث الملكية في العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية, أي مشاركة القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاعين المختلط والتعاوني, إضافة إلى القطاع الخاص الأجنبي, بل هي ضرورة حتمية وملحة. والدكتور زيني لا يستثني قطاع الدولة من النشاط الاقتصادي, ولكن يحصره في البنية التحتية والخدمات العامة ليوفر كل ما هو ضروري للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لأداء دورهما في العملية الاقتصادية. وفي هذا يبرز الاختلاف في الموقفين. علماً بأن هناك بعض الاقتصاديين الذي يتبنى بشكل مطلق فكر ونهج اللبرالية الجديدة في الحياة الاقتصادية ويرى بأن من يخالف اللبرالية الجديدة لم يطلع عليها وليست له معرفة بمضامينها! في مثل هذه الحالة لا يشعر الإنسان بجدية من يناقش بهذه الطريقة غير العقلانية التي يعتبر فيها وكأن الآخر يكتب بأمر لا علم له بها, وأنه وحده العليم بهذه الأمور !!
حين نستعيد مراحل تطور الرأسمالية على الصعيد العالمي, وفي فترات الحروب وفي أعقابها بشكل خاص, سنجد أن اقتصاد السوق الحر قد اعتمد في تطوره الاقتصادي على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وفي صناعات تحويلية مهمة, بل وأن هناك دولاً رأسمالية متقدمة ما تزال تمارس هذا النهج إلى جانب الدور الرئيسي للقطاع الخاص في مجمل العملية الاقتصادية, ومنها فرنسا. كما إن الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة التي ما تزال عواقبها مستمرة بفعلها السلبي على الصعد المحلية والإقليمية والدولية, دفعت بالكثير من الاقتصاديين والسياسيين والباحثين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي في أوروبا وفي الولايات الم
تحدة إلى الدعوة لاستعادة قطاع الدولة بعض دوره في العملية الاقتصادية في مجالات الصناعة والمالية والبنوك, أي الدعوة إلى تأميم مشاريع اقتصادية إنتاجية ومالية وخدمية. إذ إن العواقب الوخيمة التي تسببت بها الاحتكارات الرأسمالية الخاصة والبنوك كانت كبيرة وحملت خزائن الدول خسائر مالية فادحة تحملها دافعو الضرائب في تلك الدول, وهم في الغالب الأعم الفئات المنتجة للسلع المادية والروحية والكادحة, غذ غالباً ما يتهرب أصحاب رؤوس الأموال والاحتكارات الكبيرة من دفع الضرائب ويعفون تحت ذرائع كثيرة.
من هنا أجد أن الملاحظة التي يطرحها الدكتور محمد علي زيني بشأن إبعاد الدولة عن المشاركة في قطاع الإنتاج وترك المهمة للقطاع الخاص متشددة وغير مبررة في ظروف العراق الملموسة. إذ أرى إن بلداً مثل العراق يفترض فيها أن يستفيد من القطاعين الخاص والعام أولاً, ومن القطاع المختلط والتعاوني ثانياً, وأن لا يستغني عن الاستفادة من القطاع الخاص الأجنبي ومن المعونات الخارجية غير المشروطة بأي حال. وأستند في هذا الرأي إلى ملاحظتين مهمتين:
1. إن صيغ تطبيق الرأسمالية ليست واحدة بل توجد صيغ كثيرة لا تعتمد على طبيعة المرحلة فحسب, بل على وفق الإمكانيات والقدرات الفعلية والوعي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمع وحاجات البلاد وإمكانياته.
2. وإن الدول الرأسمالية في مراحل مختلف من تطورها اعتمدت على قطاع الدولة في تنمية اقتصادياتها وكانت ناجحة في استخدام مشاريع القطاع الحكومي الإنتاجية.
يحضرني في هذا الصدد موقف الاقتصادي الإنجليزي جون مينارد كينز ( John Maynard Keynes) (1883 – 1946) حين تحدث عن دور قطاع الدولة في فترات معينة من تطور الرأسمالية وأكد ضرورة تفعيل هذا الدور في أعقاب الحرب العالمية الثانية للخروج من عواقب الحرب المدمرة والنهوض بالاقتصاد الوطني للدول الأوروبية. كما إن ذلك قد تجلى في موقفه حين شارك في المؤتمر الاقتصادي الدولي في أعقاب الحرب العالمية الأولى وكذلك في موضوعاته المهمة في أعقاب الكساد العالمي 1929-1932.
إن الدعوة إلى مشاركة قطاع الدولة في التنمية الاقتصادية وفي القطاعات الإنتاجية التي أتبناها لا تميل أو تدعو إلى مقاربة ما حصل في الدول الاشتراكية التي كانت تمارس كل النشاط الاقتصادي وأبعدت كلية تقريباً القطاع الخاص وقدراته وكفاءاته العلمية والفنية أو دخلت في إنتاج كل شيء واحتلت كل الخدمات تقريباً من جهة, ولا إلى ما حصل في العراق في فترة حكم البعث في الفترة 1968-2003 الذي حاول النظام السياسي من خلال هذا القطاع فرض هيمنته لا على الاقتصاد الوطني فحسب, بل وعلى كل العاملين في النشاط الاقتصادي وعلى جهاز الدولة باعتباره صاحب العمل الذي يسيطر عليهم ويريد منهم خدمة الفئة الحاكمة وحزبها وقائدها من جهة أخرى, إذ أن النموذجين, وأن اختلفا في الجوهر, ليسا صالحين للعراق. فالدولة العراقية المالكة للموارد الأولية, وخاصة النفط والغاز الطبيعي, يمكنها توفير الموارد المالية على الأمد المتوسط والطويل لصالح التنمية الاقتصادية, سواء بتأمين إقامة مشاريع البنية التحتية, ومنها مشاريع الخدمات الاجتماعية الأساسية بما يسهم في تقديم الخدمات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي, أم في إقامة مشاريع إنتاجية ذات أهمية فائقة وذات طبيعة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة. والقطاع الخاص المحلي عاجز حالياً وإلى عقدين قادمين أو أكثر عن توفير مستلزمات النهوض بمهمات التنمية دون دعم واسع ومتواصل من جانب الدولة وقطاعها الاقتصادي. كما إن القطاع الخاص الأجنبي الذي نحتاجه في التنمية الاقتصادية سوف يتلكأ كثيراً بسبب المنافسة الشديدة الخارجية على الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية من جهة, وبسبب الأوضاع الداخلية التي لن تنتهي في فترة وجيزة في ضوء النظام القائم على المحاصصة الطائفية واستمرار الإرهاب المحلي والإقليمي وتدخل دول الجوار الفظ في الشأن العراقي من جهة ثانية, وطبيعة القوى الحاكمة التي لم تعِ, وربما لا تريد أن تعي مفهوم التنمية المستدامة الضرورية والملحة للنهوض بالاقتصاد العراقي من جهة ثالثة. يضاف إلى ذلك واقع الفساد المالي المستشري في العراق لا كظواهر متفرقة, بل كنظام سائد ومعمول به ومقبول من الدولة بسلطاتها الثلاث ومن فئات الشعب التي تمارسه يومياً مجبرة لأنها لا تستطيع بدون ذلك تمشية معاملتها وشؤونها اليومية.
لا أنطلق في هذا الموقف من قطاع الدولة ودوره ودور بقية القطاعات الاقتصادية من حيث الملكية من مواقع أو رؤية إيديولوجية, بل استند في ذلك إلى منظور اقتصادي اجتماعي للمجتمع العراقي وبنيته الطبقية ومن رؤية موضوعية لواقع العراق الملموس وحاجاته الكبيرة للتنمية وضرورة تعبئة كل الإمكانيات لهذا الغرض. ولهذا لا أرى صواب أن يشارك القطاع العام في إنتاج كل شيء بما في ذلك إبر الخياطة والخيوط والدبابيس …الخ , ولا أن يعمل بالضرورة في صناعة الفندقة والسياحة مثلاً, ولكن من الممكن أن يشارك في صناعة الصلب والحديد أو في إنتاج الخبز الجيد والرخيص للمجتمع على وفق المثل الشعبي البغدادي القائل “الناس تفتش عن خبز باب الأغا حار ومگسب ورخيص). ولم ينشأ هذا المثل الشعبي عن فراغ, بل كان وما يزال يعبر عن حاجة الناس لذلك. ومثل هذه المواصفات الثلاث لا يوفرها القطاع الخاص وغير مستعد لتوفيرها على هذا الأساس. لا شك في أن من واجب الدولة أن توفر البنية التحتية لمشاريع الفندقة والسياحة, وربما يمكنها في مرحلة لاحقة أن تطالب بتعويضات معينة من أ
صحاب مشاريع الفندقة والسياحة عن استخدامهم لتلك المرافق أو مشاريع البنية التحتية التي تقيمها وتساهم في تنشيط مختلف أنواع السياحة في العراق.
العراق ورؤوس الأموال الأجنبية
ويبدو لي إن من المفيد ونحن نتحدث عن الاستثمار الأجنبي في العراق أن نفكر بخمس مسائل جوهرية:
1 . إمكانية وضرورة وأهمية مشاركة رؤوس الأموال القادمة من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في مشاريع اقتصادية مشتركة, سواء بمشاركة الدولة أم القطاع الخاص المحلي, أي مشاريع مختلطة لاكتساب الخبرة والمعرفة والمشاركة في الأرباح. وينطلق هذا الموقف من أهمية تحقيق التعاون والتنسيق الاقتصادي على صعيد الدول العربية والمنطقة لما في ذلك من أهمية في حجم رؤوس الأموال التي يمكن توظيفها وحجم الإنتاج والتقنيات الأكثر حداثة التي يمكن استخدامها في الإنتاج ورفع مستوى الإنتاج ونوعية الإنتاج وتقليص التكاليف وتوسيع السوق الذي يمكن تصريف السلع المنتجة فيه وتكون سلعه قادرة على المنافسة في السوق الدولية. أي الإنتاج الموجه للتصدير, ولكن في الوقت نفسه لأسواق المنطقة والداخل.
2 . أن تساهم رؤوس الأموال الأجنبية في تنمية تلك القطاعات أو المشاريع الاقتصادية التي يحتاجها العراق لتنمية المناطق التي ما تزال متخلفة وبحاجة إلى تنمية معجلة يصعب على القطاعين العام والخاص المحليين النهوض بها . وفي هذه المشاريع يمكن التفكير بدور مشارك للقطاع الخاص المحلي أو الحكومي للوصول إلى ذات الأهداف.
3 . أن نبتعد قدر الإمكان عن استثمارات الحافظة التي حذر منها بصواب الدكتور زيني, وأن ننشط استثمار رؤوس الأموال بشكل مباشر. ومن المفيد هنا أيضاً أن نشجع على الاستثمار المشترك, أي بين الأجنبي والعراقي, سواء أكان حكومياً أم خاصاً, في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية وفي إقامة وتنشيط مراكز البحث العلمي النظري والتطبيقي لصالح عملية التنمية.
4 . أن يلتزم القطاع الخاص الأجنبي بقوانين العمل والعمال والضمانات الصحية والاجتماعية والحماية الصناعية .. الخ في العراق وأن لا يتجاوزها بما يلحق الضرر بالعاملين ومصالحهم.
5 . أن تقدم الدولة تسهيلات مهمة ومناسبة, سواء أكانت في مجال الضريبة على الأرباح أو تخفيض التعريفة الجمركية على المواد الأولية والسلع نصف المصنعة المستوردة, من أجل تشجيع وتنشيط الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد العراقي والسماح له بتحويل جزء مهم ومعقول من أرباحه إلى الخارج وإعادة توظيف جزء أخرى منها في الداخل لتنمية لتحقيق تراكم رأسمالي وتحسين التقنيات المستخدمة وطرق الإنتاج بما يتناسب وحماية البيئة في العراق.
هل نحن بحاجة إلى خصخصة
وأخيراً دعا الدكتور زيني في “خارطة طريق اقتصادية” للعراق إلى تحقيق خصخصة كاملة للمنشآت والمشاريع الحكومية المتبقية في قطاع الصناعة التحويلية, باستثناء قطاع النفط الخام. ومع تأييدي الكامل لحصر اقتصاد النفط الخام بالدولة العراقية, أرى خطأ اللجوء للخصخصة التامة لما تبقى من قطاع الدولة الصناعي, إذ إن العيب ليس في ملكية الدولة لوسائل الإنتاج بل في طبيعة النظام السياسي وفي وأساليب وأدوات العمل والإدارة والأهداف المحددة لمشاريع هذا القطاع. الدكتور زيني يقول بهذا الصدد ما يلي:
”ولقد استمرت هذه الحالة حتى الثورة في 1958 (ويقصد هنا الاعتماد على اقتصاد السوق, ك. حبيب)، حيث بدأت بعدها الحكومات العراقية المتعاقبة تستثمر في القطاع الصناعي. وعندما زاد الميل تدريجياً نحو الاقتصاد الاشتراكي، نفّذت الحكومة عمليات التأميم في سنة 1964. ومنذ ذلك الحين هيمن القطاع العام على الاقتصاد العراقي. وغني عن القول أن الاقتصاد الاشتراكي، بخصوص عمليات الإنتاج، فشل في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن العراق، وأصبح الآن ضرورياً تفكيك معظم القطاع العام الفاشل، وفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بمهمة الإنتاج.” (راجع: الحلقة الثالثة من “خارطة طريق اقتصادية”).
في هذا المقطع ثلا ث مسائل تستوجب المناقشة:
1 . إن الميل صوب التأميم في العام 1964 لم ينطلق من رؤية وفلسفة اشتراكية ثانياً, ولا من جماعات كانت تؤمن بالاشتراكية ثانياً, فعبد السلام محمد عارف الذي وقع على إجراءات التأميم هذه لم يكن اشتراكياً بل كان الرجل قومياً شوفينياً وطائفياً مقيتاً, كما إن الجماعة التي حركته للتأميم لم تكن هي الأخرى اشتراكية. لقد تمت عملية التأميم البائسة التي لم يبلغ حجم رؤوس الأموال المؤممة كلها وفي جميع القطاعات عن 28 مليون دينار عراقي حينذاك, وقد اضرت بالاقتصاد العراقي ولم تنفعه بشيء. لقد صدرت إجراءات التأميم تلك تحت فعل ثلاثة عوامل:
أ . وجود الجماعة الناصرية في الحكم في عهد عبد السلام عارف التي حاولت التماثل مع سياسة عبد الناصر في مجال إجراءات التأميم التي وقعت بين 1961-1964 في مصر, والتي جاءت في مصر في حينها عقاباً للبرجوازية المصرية على موقفها من الوحدة مع سوريا, ولم تستند إلى فلسفة اشتراكية, وكان استغلال ونهب قطاع الدولة في مصر يتم من الباطن ولم يتوقف. وبالمناسبة أشير هنا إلى إن رسالتي للدكتوراه التي دافعت عنها في شهر شباط/فبراير 1968 حملت العنوان التالي ” طبيعة إجراءات التأميم في جمهورية العربية المتحدة “. ونشرت بشأن الإجراءات مقالين في جريدة الطليعة المصرية في أوائل 1968.
ب . معاقبة البرجوازية الوطنية العراقية التي رفضت الانقلابات البعثية والقومية وسياساتها الفاشية وتوقفت عن توظيف استثماراتها في الاقتصاد العراقي بهدف إقناع الحكومة العراقية بضرورة تغيير
سياساتها مواقفها الطائفية المتشددة التي تميزت بها مواقف عبد السلام محمد عارف حينذاك. وعلينا أن نتذكر هنا مذكرة الشيخ محمد رضا الشبيبي إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الرحمن البزاز حول تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق حينذاك.
ج . محاولة السيطرة على الاقتصاد الوطني لإخضاع كل العاملين في النشاط الاقتصادي وكذلك المجتمع للسلطة السياسية حينذاك والتحكم في وجهة التطور بأمل تحقيق الوحدة مع مصر.
ولهذا فإن القول بأن الدولة كانت تتجه صوب الاشتراكية ليس صحيحاً وقد كتبت عن إجراءات التأميم في العام 1964 ثلاث دراسات نشرت في مجلة دراسات عربية (1969) ومجلة الطريق (1970) ببيروت وفي أكثر من مقال في الثقافة الجديدة وفي مجلة الجامعة المستنصرية ببغداد باعتبارها إجراءات سيئة أعاقت عملية التنمية ودور القطاع الاقتصادي وبثت الخشية فيه طويلاً. وبذلك ساهمت في تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج والابتعاد عن توظيفها في الداخل.
2 . بصدد الفترة 1968-2003
في الوقت الذي ساندتُ إجراءات التأميم في قطاع النفط الخام في العام 1972 ووقفت إلى جانب تطوير قطاع الدولة الاقتصادي, ولكني رفضت تورط الدولة المفرط في التوسع العفوي والفوضوي لقطاع الدولة والمعرقل عملياً لنمو القطاع الخاص وتطوره ودوره في التنمية والعجز عن إدارة وتنظيم قطاع الدولة ومجمل الاقتصاد الوطني. ودعوت إلى تشجيع ودعم نشاط القطاعات الأربعة من حيث الملكية التي أشرت إليها في هذه الدراسة أيضاً والابتعاد عن عقد المشاريع تحت عنوان المشروع الجاهز أو تسليم المفتاح لما في ذلك من عواقب سلبية على الاقتصاد من حيث الكلفة وصعوبة إدارتها فنياً وعدم تدريب الكوادر الفنية العراقية عليها. كما كنت صارماً في الموقف من التنمية الانفجارية التي كتبت عنها الكثير وتسببت تلك الكتابات, وخاصة المقال الذي نشر في طريق الشعب في يوم الجمعة المصادف 7 من شهر تموز/يوليو 1978 حيث تم اعتقالي في نفس يوم نشر المقال وخلال اعتقالي وتعذيبي تمت أحالتي على التقاعد بدرجتين أقل وبدون راتب تقاعدي. ثم قدمت أوراقي إلى محكمة الثورة بتهمة إهانة مجلس قيادة الثورة, ودولة البعث ولكن كنت قبلها بقليل قد غادرت العراق إلى الجزائر.
لقد كانت الجمهورية الرابعة, البعثية, استبدادية وبوليسية قمعية ومهووسة بأموال النفط الخام المصدر التي تساقطت على رأس النظام كزخات مطر أعمت بصر وبصيرة نظام البعث, كما نلاحظ هذه الظاهرة في يومنا هذا أيضاً وبصيغ متنوعة. ولهذا لم يهتم النظام بقطاع الدولة بقدر ما اهتم في التوسع به وهيمنته على كل العاملين في أجهزة الدولة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ودفعت به إلى تحميل خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة من خلال تقديم الدعم المستمر لهذه المشاريع مع سبق الإصرار, إذ لم يعمل القطاع الحكومي على أسس اقتصادية ومحاسبية ومنافسة جدية, بل كان يراد منه إعطاء صورة كاذبة وكأن الدولة تسير بـ “الاتجاه الاشتراكي” ولهذا أطلقت عليه اسم القطاع الاشتراكي زيفاً وبهتانا.
العيب الفعلي لم يكن في قطاع الدولة, بل بالنظام السياسي الذي أخضع هذا القطاع له وتوسعه بصورة عفوية وعبثية. كما كان العيب في الأساليب والأدوات والكوادر البعثية التي وضُعت على رأس هذا القطاع الحكومي ليخدم هيمنتها على الاقتصاد والمجتمع في العراق وليتحكم بأجهزة الدولة ومجالاته من جهة أخرى, وليكون أداة للنهب والسرقة والتحايل على المال العام, سواء من حيث التعاقد على إقامة تلك المشاريع, أم في فترة إقامتها أم في فترة إنتاجها.
وبكلمة مختصرة فإن خسارة مشاريع قطاع الدولة كانت مبرمجة ابتداءً, إذ لم يكن هدفها اقتصادي, بل سياسي بحت. ولا يمكن أن يتصور الإنسان نجاح مشاريع قطاع الدولة كلها حين يكون الهدف منها سياسي لا غير.
3 . وعليه فأن الحديث عن التوجه الاشتراكي في سياسة الدول وهي تقيم هذه المشاريع خاطئ حقاً ولا يتناغم مع الواقع الذي ساد العراق خلال الفترة 1968-2003. فالاشتراكية لا تعني ملكية الدولة لوسائل الإنتاج, إذ إن الرأسمالية كانت فيها أيضاً ملكية دولة لوسائل الإنتاج دون أن يطلق عليها اشتراكية بل رأسمالية دولة. والاشتراكية لا تعني فقط وجود حزب يدعي الاشتراكية, كما في اسم حزب البعث العربي الاشتراكي, أو يدعي تمثيله للطبقة العاملة والفلاحين ولكن يسير بالاتجاه المعاكس كما عشنا التجربة في الدول الاشتراكية التي عبرت في الخط العام عن رأسمالية دولة, كما هو الحال في الصين حالياً. ولست هنا معنياً بتبيان ما تعنيه الاشتراكية, إذ ربما يحتاج هذا الموضوع إلى بحث مستقل.
لقد كان نظام البعث شمولياً واستبدادياً دموياً, لقد كان فاشياً من الناحيتين الفكرية والسياسية والسياسات العسكرية والقمعية والقسوة, ولم تكن لكلمة الاشتراكية في تسمية حزبه إلا ذراً للرماد في عيون البسطاء من الناس.
كما إن من غير الصائب الدعوة إلى الخصخصة إذا كان بالإمكان, وهذا ممكن فعلاً, إيلاء اهتمام أكبر بتلك المشاريع وإعادة تأهيلها ووضع كوادر إدارية ومحاسبية وفنية أمينة ونظيفة ومخلصة للعملية التنموية في العراق ولثروة الوطنية.
انتهت الحلقة الرابعة وتليها الحلقة الخامسة.
24/5/2011 كاظم حبيب
قراءة ومناقشة “خارطة طريق اقتصادية” للسيد الدكتور محمد علي زيني
الحلقة الخامسة
العراق والعولمة
استخلص الصديق الدكتور محمد علي زيني بصواب أن “العولمة موضوع مثير للجدل، وهي ليست كلها نافعة كما هي، أيضاً، ليست كلها ضارة. فهي لها مجالات إيجابية عديدة يمكن التركيز عليها واستغلالها والاستفادة منها، ولها بعض المجالات السلبية التي يمكن تقليص آثارها إلى الحدود الدنيا إن لم يكن ممكناً تفاديها أو التغلب عليها بالكامل. وسيسهل أيضاً مواجهة تحديات العولمة إذا تمت الاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى .” (راجع: الحلقة الثالثة من خارطة طريق اقتصادية).
وهو من حيث المبدأ استنتاج واستخلاص سليم, إذ لم يعد ممكناً لأي بلد من البلدان تجاوز العولمة وفعلها وآثارها أو نتائجها وعواقبها في آن, فنحن وكافة الدول الأخرى تشكلُ جزءاً من هذا العالم ولا نستطيع الهروب منه, وأن اختلفنا في المواقع التي نحتلها فيه. إذ إ العولمة الرأسمالية قد حولت العالم كله إلى قرية دولية صغيرة متفاعلة ومتبادلة التأثير ولكنها متباينة في مدى تأثير كل منها, كما إنها متباينة جداً في ما تملكه في هذه القرية من عمارات شامخة وفيلات ودور عامرة وبيوت بسيطة وأكواخ وبيوت قصديرية ومناطق سكن عشوائية. ففي هذه القرية دول متقدمة غنية ومتخمة يعيش فيها أقل من 20% من سكان العالم ولكنها تستحوذ على أكثر من 80% من الدخل القومي المنتج في العالم وتستخدم أكثر من 80 من الطاقة والأخشاب ومجموعة كبيرة من المواد الأولية الأخرى, وفيها ينتج حوالي 80 %من إنتاج العالم …الخ, وبجوارها مئات الدول المتخلفة والفقيرة وبعضها أكثر من بائسة يعيش فيها أكثر من 80% من سكان العالم ولكنها حصتها تقل عن 20% من الدخل القومي المنتج على الصعيد العالمي, ولا تستخدم سوى 20% من الطاقة والأخشاب ومن الإنتاج العالمي, بما في ذلك النفط الخام المصدر للدول الأخرى. في الدول الغنية في هذه القرية توجد مجموعة الدول المنتجة للسلع المصنعة التحويلية التي تسيطر على 80% من إجمالي صادرات العالم, في حين توجد بجوارها تلك الدول التي تنتج وتصدر في الغالب الأعم المواد الأولية, وبالتالي فهي غير متساوية في مستوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولا في قدرتها على حماية البيئة الذي تتسبب الدول المتقدمة في إنتاج أكثر من 80% من كمية التلوث في العالم, وهي بالتالي غير متكافئة في مجمل العملية الاقتصادية والتي تبرز بشكل جلي في عمليات التراكم والتبادل.
ومن هنا فنحن أمام عالم واحد, ولكنه في واقع الحال عالمان, عالم غني متخم, وآخر فقير حد الإملاق. ورغم ذلك فمن يحاول رفض العولمة أو عدم التعامل معها والإفلات منا, كمن يضرب رأسه بصخرة فيشجها أنها حقيقة صلدة, لأنها نتاج موضوعي لمستوى تطور القوى المنتجة المادية والبشرية وطبيعة علاقات الإنتاج الرأسمالية على الصعيد العالمي, كما إنه يبدو أشبه بالنعامة التي تدفن رأسها بالرمال حين تواجه عدوها وجهاً لوجه بأمل أن لا يراها ذلك العدو! إنه الوعي المزيف الذي لا يريد أن يرى الأشياء على حقيقتها. فالعولمة قائمة بالرغم منا, إذ إنها ضمن مرحلة متقدمة من مراحل تطور العلاقات الإنتاجية الرأسمالية على الصعيد العالمي. فكما ظهر التبادل التجاري والتعامل الاقتصادي الدولي وتوسع تدريجاً في المراحل الأولى من تطور الرأسمالية وبرز بوضوح غير قابل للإنكار أو منعه من التطور في القرن التاسع عشر, إذ ما عاد بإمكان البرجوازيات المحلية الرجعية حينذاك تفادي التبادل أو التعامل الاقتصادي الدولي وما كان بالإمكان حصر التبادل داخل البلد الواحد, إذ كان هذا التوجه يتعارض مع النمو المتواصل في التقسيم الدولي الرأسمالي الاجتماعي للعمل. فالعولمة اليوم تسجل تطوراً هائلاً في القوى المنتجة المادية والبشرية, تطوراً في التقنيات الإنتاجية والاتصالات تتجلى في ثلاثية ثورة الإنفوميديا وما تحققه من تشابك وما تلعبه من دور متصاعد في اقتصادات وعلاقات دول العالم ومختلف أوجه حياة الشعوب. كتب ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي في العام 1848 النص التالي:
“والبرجوازية، باستثمارها السوق العالمية، طبَّعت الإنتاج والاستهلاك، في جميع البلدان، بطابع كوسموبوليتي، وانتزعت من تحت أقدام الصناعة أرضيتها القومية وسط غم الرجعيين الشديد. فالصناعات القومية الهرمة دُمّرت وتدمَّـر يوميا لتحل محلها صناعات جديدة، أصبح اعتمادها مسألة حيوية بالنسبة إلى جميع الأمم المتحضرة، صناعات لم تعد تستعمل المواد الأولية المحلية، بل المواد الأولية من أقصى المناطق، صناعات لا تُستهلك منتجاتها في البلد نفسه فحسب، بل أيضا في جميع أنحاء العالم. فمكان الحاجات القديمة، التي كانت المنتجات المحلية تسدُّها، تحُل حاجات جديدة تتطلب لإشباعها منتَجات أقصى البلدان والأقاليم. ومحل الاكتفاء الذاتي الإقليمي والقومي والانعزال القديم، تقوم علاقات شاملة في كل النواحي، وتقوم تبعية متبادلة شاملة بين الأمم. وما ينطبق على الإنتاج المادي ينطبق أيضا على النتاج الفكري. فالنتاجات الفكرية لكل أمة على حدة تصبح ملكا مشتركا. والتعصب والتقوقع القوميّان يُصبحان مستحيلين أكثر فأكثر. ومن الآداب القومية والإقليمية ينشأ أدب عالميّ.” (راجع: كارل ماركس وفريدريك إنجلز. البيان الشيوعي. الفصل الأول). لهذا فمن يرفض التعامل مع العولمة كمن يرفض العصر الذي يعيش فيه. والاعتراف بوجود العولمة كعملية موضوعية لا يعني الخضوع لها ولا القبول بالسياسات التي ترسمها الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة التي تخدم مصالحها لا غير وتريد فرضها على شعوب وحكومات البلدان النامية. بل لا بد من التحري عن سبل جديدة لممارسة سياسات تعبر عن إرادة الشعوب وتخدم مصالحها, ومنها إرادة الشعب العراقي ومصالحه.
إن الاعتراف بوجود العولمة وحركة قوانين الرأسمالية وفعلها على الصعيد العالمي يتطلب من علماء الاقتصاد والاجتماع والمثقفين والسياسيين في العراق مثلاً التعاون في فهم جوانب العولمة وسبل الاستفادة منها, كما أشار إلى ذلك السيد الدكتور زيني بصواب وسبل التخلص من جوانبها السلبية الحادة على اقتصاديات العراق وشعبه. وعلينا أن نشير هنا إلى أن الكثير من الجوانب السلبية في العولمة الرأسمالية التي أود الإشارة إليها في أدناه تلتحم, من حيث الأساليب والأدوات والأهداف في الواقع العملي, بسياسات المؤسسات المالية الدولية والاحتكارات الكبرى المتعدية الجنسية وتتوافق معها وتتجلى في ممارساتها في موقعين: أ) في التعامل مع شعوب الدول النامية ومنها العراق, وب) في التعامل مع الجزء الأكبر من شعوبها, أي مع الفئات المنتجة للخيرات المادية والكادحة والعاطلة عن العمل في البلدان الرأسمالية المتطورة. ويلاحظ بوضوح حجم البطالة المتعاظم يوماً بعد آخر بسبب سعي أصحاب رؤوس الأموال إلى تقليص حصة العمل في القيم المنتجة أو حصة الأجور (رأس المال المتحرك) في إجمالي رأس المال الموظف في الإنتاج لصالح رأس المال الثابت. إنها الملاحظات التي يفترض, ونحن نتحدث عن العولمة أن لا تغيب عن ذهن اقتصاديي وحكام وشعوب الدول النامية, ومنها العراق التي ألخص أبرزها في النقاط التالية:
** إن العولمة تسعى إلى تجاوز الحدود والسيادة الوطنية للدول وتقليص قدرة الدول النامية على اتخاذ وتنفيذ قرارات اقتصادية أو حتى سياسية واجتماعية مستقلة عن الدول الكبرى المتحكمة بسياسات العولمة. ويتجلى ذلك في عدد كبير من الأمور في المجال الاقتصادي ومنها فرض أسس محددة في التجارة الدولية المفتوحة والاستثمارات والقوى العاملة وبراءات الاختراع… الخ. فقواعد اللعبة الاقتصادية بيد المراكز الدولية الثلاثة للعالم الرأسمالي وليس بيد غالبية الدول الأخرى في العالم. وغالباً ما يتسنى للولايات المتحدة الأمريكية فرض رغباتها وإرادتها على دول الاتحاد الأوروبي واليابان.
** إن العولمة الجارية التي نتحدث عنها في هذه المرحلة من تطور المجتمع البشري ومن العلاقات الإنتاجية السائدة فيه تعتبر الوليد الشرعي للنظام الرأسمالي العالمي وقوانينه الاقتصادية الموضوعية الخاصة والعامة, أي إنها عولمة رأسمالية ناتجة في صيغتها الجديدة عن مستوى تطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي.
** وهذا يعني بدوره إن العولمة الرأسمالية بطبيعتها وطبيعة وفعل القوانين الاقتصادية المتحكمة فيها استغلالية ترتبط عضوياً بقوانين وآليات اقتصاد السوق الحر, وتسعى إلى تحقيق أقصى الأرباح.
** وأن هذه العولمة, وأن كانت عملية موضوعية, فإنها تتسبب, إضافة إلى سياسات الدول الرأسمالية المتقدمة, وخاصة بمضمون اللبرالية الجديدة, باستغلال شعوب البلدان النامية وكذلك الفئات الكادحة والمنتجة للخيرات المادية في بلدانها بالذات وتعميق التفاوت الطبقي الاجتماعي, وتتسبب في مزيد من الصراعات الطبقية والنزاعات السياسية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
** والعولمة, وهي تجعل جملة من القيم والمعايير عامة شائعة ومتداولة كالمجتمع المدني والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان, ولكنها من حيث الجوهر تقلص ممارسة هذه القيم في الدول المتقدمة وغالباً ما تغيب عن الدول النامية كلية أو على نطاق واسع. وتتقلص أيضاً حتى صلاحيات مجالس النواب والسياسات الحكومية لصالح القرارات الدولية التي تتخذها تلك المراكز المهيمنة على سياسات العولمة. فمجالس النواب تخضع بشكل عام في قراراتها لاجتماعات الدول الـ 7 + 1 الكبار أو الدول ألـ 20. وهذا ما نشاهده أيضاً في خضوع مواقف وقرارات مجالس النواب في الدول الأوروبية إلى المجلس الأوروبي.
** والقوى الموجهة للعولمة التي تبدي اهتماماً خاصاً بالجانب الاقتصادي, تهمل بشكل تام تقريباً الجوانب الاجتماعية ومشكلاتها في حياة الشعوب, وخاصة مشكلات ومصاعب حياة الفئات الكادحة والمنتجة للخيرات المادية لا في البلدان النامية فحسب, بل وفي بلدانها بالذات. وقد تجلى ذلك بوضوح بعد انهيار الاتحاد السوفييتي الذي كان منافساً للدول الرأسمالية والتي أجبرت في حينها على المساومة مع النقابات العمالية والعمال في مجالات الرعاية والضمانات الاجتماعية والصحية والعطل السنوية والحماية الصناعية …الخ, إذ بدأت تتراجع عنها وتقلصها وتمارس استغلالاً أكثر قسوة مما يزيد من التناقضات الاجتماعية والصراعات الطبقية. كما يمكن تسجيل نفس الملاحظة على موقف الدول الرأسمالية المتقدمة السلبي من اتخاذ قرارات صارمة لحماية البيئة أو استمرارها في زيادة مخزونها من أسلحة التدمير الشامل أو استخدام الذرة في إنتاج الطاقة الكهربائية رغم وقوع كوارث مثل تشرنوبيل وفوكوشيما أخيراً, أو مواصلة تصدير المزيد من الأسلحة الهجومية على الدول النامية التي تسهم في دفع الدول لحل مشكلاتها عبر استخدام القوة والحروب من جهة, وتقليص ميزانيات التربية والتعليم والصحة والسكن..الخ من جهة أخرى.
** وعلينا أن نتابع في هذا المجال أيضاً موقف العولمة من تصنيع الدول النامية, وخاصة ضد إدخال الصناعات الأكثر حداثة وتقدماً والأقل تلويثاً للبيئة فيها, وكذلك السعي لإغراق أسواقها بالسلع المنتجة في دولها والتركيز على سياسة الباب المفتوح أمام التجارة الدولية الذي يعرقل بدوره نمو الصناعات الوطنية. علماً بأن التبادل التجاري الدولي يجسد بصورة فاضحة التعامل غير المتكافئ بين الدول المتقدمة والدول النامية لصالح الأولى. إن العولمة الرأسمالية تسعى إلى جعل عملية إعادة الإنتاج في الدول النامية تابعة وخاصة لعملية إعادة الإنتاج في الدول الرأسمالية المتقدمة. وهي مشكلة لا بد للعراق وبقية الدول النامية التفكير في سبل تحقيق الاستقلالية النسبية رغم التعامل مع واقع العولمة القائمة.
** إن ابرز ما يهم المؤسسات المالية الدولية المعبرة عن روح العولمة ووجهتها الأساسية هو تقديم شروط التعامل مع الدول النامية, ومنها العراق, أو حتى الدول الصناعية الضعيفة التطور, كما في حالة البلدان الاشتراكية السابقة, ومنها رومانيا وبلغاريا ..الخ, سواء أكان بتقديم القروض أم المساعدات المالية, التي تتركز في استكمال خصخصة المشاريع الحكومية وإبعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي الإنتاجي وإلغاء الدعم الذي يوجه للسلع الأساسية التي تستفيد منها الفئات الكادحة والفقيرة, وإجراء ترشيق في ميزانية الدولة في حقول الرعاية الاجتماعية وممارسة سياسة توفيرية ضاغطة ومضرة بالفئات الفقيرة من المجتمع التي تقود بدورها إلى مزيد من الانفصام بين سياسات حكومات تلك البلدان والغالبية العظمى من شعوبها.
** السيد مونتيفيرنگ, رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني, ألقى خطاباً في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وتصريحات أدلى بها في نيسان/أبريل 2005 أستخدم صورة أسراب الجراد للتعبير عن سلوك الرأسماليين الألمان التي تريد التهام كل شيء ولا تبقي شيء للمنتجين الفعليين. (قارن: أولريش شيفر. انهيار الرأسمالية, عالم المعرفة 371. يناير 2010 ص126-128). وهذه الحقيقة هي نتيجة منطقية لطبيعة العلاقات الإنتاجية الرأسمالية التي يسعى فيها الرأسمالي إلى انتزاع أقصى ما يمكن من الثروة المنتجة في البلاد على شكل أرباح وفوائد وريع ويترك القسم الضئيل منها لمنتجي السلع المادية والروحية, لمنتجي القيمة المضافة للثروة في المجتمع. وتزداد هذه الحالة في إطار العولمة الجارية. ويمكن أن نقرأ ذلك بوضوح في ملاحظات الدكتور زيني حول مسألتين من خلال دراساته الأخيرة:
الأولى تمس واقع العقود النفطية التي وقعها العراق ولا تنسجم مع مصالح البلاد, بل تخدم بشكل صارخ مصالح الشركات الاحتكارية البترولية الأجنبية.
نظام الفساد السائد في العراق والذي تمارسه الشركات الأجنبية العملاقة مع العراق منذ نظام صدام حسين واشتد في الفترة التي أعقبت سقوط الدكتاتورية التي تحدث عنها بوضوح كبير الأخ الدكتور محمد علي زيني. إن الفساد الراهن في العراق معولم بكل معنى الكلمة, وتشارك فيه قوى سياسية واجتماعية كثيرة.
والمثال الثالث الذي أورده هنا يمس موقف الدول الصناعية المتقدمة من النظم المستبدة في الدول العربية. فهي وعلى مدى عقود ساعدت الحكومات المستبدة والرجعية ابتداءً من السعودية ومروراً بكل دول المنطقة ومصر والعراق على حساب حرية وحياة ومصالح شعوبها لأنها كانت لها مصالح في هذه البلدان. وهي ما تزال تؤيد الكثير من هذه النظم لذات السبب. ولكن حين اصطدمت مصالحها ببعض تلك الدول لم يكن لديها مانع من شن الحرب للتخلص منها والعمل قدر الإمكان لإرساء نظام جديد يمكن أن يدعم بشكل أفضل مصالحها في هذه البلدان.
إن تشخيصنا لهذه الجوانب السلبية في العولمة وفي السياسات العولمية لا يعني عدم سعينا للاستفادة من جوانب إيجابية فيها مثل السعي الحصول على أحدث التقنيات المناسبة لإقامة الصناعات الحديثة غير الملوثة للبيئة أو في تطوير البحث العلمي والتدريب والخبرة العلمية والتطبيقية والتعليم وفي مجال التبادل التجاري والثقافي والبيئي, إضافة على الحصول على الاستثمارات الضرورية على وفق شروط مناسبة.
إن الاستنتاج الصائب حول العولمة الذي أورده الدكتور زيني وأشرت إليه في بداية هذه الحلقة, لم يبرز بوضوح, كما أرى, في مجمل دراسته عن خطة طريق اقتصادية” للعراق وبشكل خاص في الموقف من الانفتاح التجاري واقتصاد السوق الحر والخصخصة ..الخ.
أتمنى أن تكون الدراسة التي قدمها الدكتور زيني فرص لمزيد من النقاش الهادف.
انتهت الحلقة الخامسة وتليها الحلقة السادسة وتدور حول الاقتصاد العراقي.
25/5/2011 كاظم حبيب
قراءة ومناقشة “خارطة طريق اقتصادية” للسيد الدكتور محمد علي زيني
الحلقة السادسة
المدخل
قدم لنا الزميل الدكتور محمد علي زيني في دراسته للاقتصاد العراقي “خارطة طريق اقتصادية” تستحق القراءة والمناقشة. إنها لوحة مكثفة تتضمن مشكلات وإمكانيات وحاجات العراق للنمو الاقتصادي, وشخص المهمات التي يستوجب النهوض بها لإخراج العراق من نفق التخلف. وقد طرح الأسئلة المهمة التالية وسعى للإجابة عنها وفق قناعاته:
“ماذا يجب أن نعمل وما هي الخيارات المتاحة لانتشال العراق من الهوّة السحيقة التي وقع بها؟ ماذا يمكن أن تقوم به الحكومات العراقية بالتضامن مع الشعب العراقي، وبالتضامن مع المجتمع الدولي أيضاً، للخروج بالعراق من نفق التخلف الاقتصادي الطويل المظلم الذي دخل به؟ كيف سيتمكن العراق من استعادة عافيته الاقتصادية ثم المضي في طريق التطور الاقتصادي ليلحق بدول عديدة لم تكن أفضل منه في سبعينات القرن الماضي ولكنها حققت بالنهاية نجاحاً اقتصادياً باهراً، ومنها النمور الآسيوية كتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا؟” (راجع: الحلقة الأولى من خارطة طريق اقتصادية). وسعى الزميل بجهد مشكور وملموس للإجابة عن تلك الأسئلة وعن سبل وأدوات تحقيق ذلك. وهي التي ستكون موضع نقاش ينطلق من مواقع الحرص على الاقتصاد العراقي التي كانت بدورها هدف الزميل الدكتور زيني أيضاً.
تضمنت الإجابة النموذج الاقتصادي الذي يراه مناسباً للعراق والأدوات التي يفترض استخدامها لهذا الغرض.
وتابعت المنهج الذي استخدمه في تلك الدراسة وفي الإجابة عن تلك الأسئلة, وهو حق ثابت له. وكقارئ أتمتع بقراءة ما يكتبه الدكتور زيني خاصة وان تحليلاته تتسم بالجدلية والعقلانية ووضوح ما يريد كنت أرى أو أفضل أن يمارس أسلوباً آخر في معالجة الدراسة التي بين أيدينا بحيث تسمح للقارئة والقارئ أن يتعرف بوضوح أكبر على المسائل التي تدور في ذهن الكاتب والتي تتجلى في الموضوع المطروح للمناقشة.
1 . طرح المنهجية التي يريد بها معالجة المشكلة العراقية والنموذج الاقتصادي الذي يختاره لمعالجة مشكلة النمو الاقتصادي ووجهة التطور الاقتصادي والاجتماعي لكي لا يُجبر الكاتب على تكرار جوانب مختلفة من النموذج الاقتصادي, كما حصل في الدراسة.
2 . ثم عرض المشكلات والاختلالات التي يعاني منها الاقتصادي والمجتمع في العراق من الناحية البنيوية ومن ثم تجلياتها في القطاعات الاقتصادية العراقية لكي تبرز من خلال هذا العرض التحليلي تلك المواقع التي هي بحاجة إلى التغيير والتطوير.
3 . ثم يتابع ذلك بتشخيص السياسات الاقتصادية التي تمارسها الدولة العراقية أو الحكومة في المرحلة الراهنة ومقدار استجابتها لمعالجة المشكلات والاختلالات القائمة, أو مدى تأثيرها على تعميق المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع.
4 . وحين الانتهاء من هذه المهمة يضعنا الكاتب أمام رؤيته واقتراحاته للتغيير المنشود على مستوى الاقتصاد من الناحيتين الكلية والجزئية. فمشكلات الدخل والتشغيل والعلاقات في ما بين القطاعات الاقتصادية وقضايا الأجور والأسعار, وبتعبير أدق السياسات المالية والنقدية, ومشكلات التأمين والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية, إضافة على المشاريع الاقتصادية التي يفترض اقتراحها لعملية التنمية, إضافة إلى السياسات الاجتماعية التي يفترض أن تتكامل في ما بينها لتحقق التغيير المنشود في الاقتصاد والمجتمع. وهذا يتطلب ابتداءً تحديد إستراتيجية النمو الاقتصادي والتطور العام في البلاد وبضمنها إستراتيجية قطاع النفط الخام الذي يفترض أن يخضع لإستراتيجية البلاد الكلية لعقدين من السنين أو أكثر.
ولا بد لي من القول بأن هذه الموضوعات موجودة في الدراسة التي تحت تصرفنا, ولكنها مبعثرة وتنقصها الملموسية المطلوبة في مثل هذه التسمية للدراسة “خارطة طريق اقتصادية” للعراق.
لقد قرأت منذ سنوات دراسة أخرى قيمة للأخ الدكتور صبري زاير السعدي تحت عنوان “نموذج النمو الاقتصادي والتوزيع في العراق (الثروة النفطية وإدارة الاقتصاد والعدالة الاجتماعية من منشورات دار الأديب البغدادية في العام 2004), وهي دراسة مهمة حقاً, بغض النظر عن مدى موافقة أو اختلاف القارئ مع هذه الفكرة أو تلك, إذ إن المنهج الذي استخدمه مهم ودقيق ويسهل فهم المادة المطروحة, بالرغم من المعادلات الرياضية أو الجبرية المستخدمة التي تفيد المختصين وليس عموم القارئات والقراء, كما يسهل البحث في الدراسة أو مناقشة أفكارها وما يسعى إليه الكاتب. ورغم وجود نقاط التقاء مهمة بين الدراستين, ولكن توجد تباينات أيضاً واختلاف كبير في منهجية الدراسة وفي طريقة العرض والتحليل.
في مناقشتي لهذه الدراسة سأتناول الموضوعات كما وردت عند الزميل بعد أن وزعت المناقشة على جانبين النظري والتطبيقي, وبعد أن انتهيت من القسم الأول, سأبدأ بمناقشة الأفكار الواردة في الجانب الثاني أي وجهة ومضمون السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعراق.
*****
حول واقع الاقتصاد العراقي
قدم لنا الدكتور زيني في البداية لوحة حزينة, ولكنها واقعية, عن الكوارث التي حلت بالاقتصاد العراقي خلال العقود التي هيمن فيها حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة السياسية, ومن ثم على الاقتصاد والمجتمع في البلاد وأقام نظاماً شمولياً وبوليسياً جائراً, وبرَّز الخسائر المادية الكبيرة التي تسببت بها سياسات النظام الاقتصادية وحروبه الدموية, الخارجية منها والداخلية, إضافة إلى سياساته القمعية. وإذا كانت هذه المعلومات التي قدمها للقراء في هذه الورقة مكثفة جداً, فإنه كان قد توسع بها كثيراً قبل ذاك في كتابيه اللذين أشرت إليهما قبل ذاك.
فقد برَّز الزميل زيني حجم الدمار الهائل الذي لحق بالاقتصاد العراقي ومشاريع التنمية التي أقيمت في البلاد خلال أكثر من نصف قرن وكشف عن الخراب الذي انتهت إليه مشاريع البنية التحتية في حروب الخليج الثلاث. إذ قدرت بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية إضافة إلى تلك الموارد المالية التي وجهت منذ منتصف السبعينات حتى عام 1990 نحو التسلح والتي بلغت أكثر من 250 مليار دولار أمريكي, (راجع: كاظم حبيب, المأساة والمهزلة في العراق, دار الكنوز الأدبية. بيروت. 2000م), التي أدت كلها إلى بدء مديونية العراق الخارجية التي بلغت أكثر من مئة مليار دولار أمريكي في حينها, دعْ عنك الفوائد التي ترتبت عليها.
وإذا كان الزميل زيني لم يتطرق إلى الجانب البشري في خسائر العراق الكبيرة خلال سنوات حكم حزب البعث, كما أشار إلى ذلك الأخ الدكتور كامل العضاض بصواب في ملاحظاته على الحلقة الأولى من هذه الدراسة, فقد اعتمد, كما يبدو لي, على ما جاء في كتابيه ولم يجد ضرورة إلى إعادة ذلك في هذه الدراسة. إلا إني أرى بأن هذه الدراسة تختلف عن الكتابين, وهي مستقلة, كما إن لها هدف محدد هو طرح خارطة طرق لإعادة بناء وتطوير الاقتصاد العراقي, ولذلك كان لا بد من الإشارة الواضحة إلى الخسائر البشرية باتجاهات خمسة هي:
1 . سقوط ضحايا بشرية كبيرة قدرت عبر الحروب الثلاث المذكورة زائداً الحرب ضد الشعب الكردي والكُرد الفيلية وضد سكان الأهوار بما يتراوح بين 750000 -1000000 إنسان وأغلبهم من القوى القادرة على العمل, وكان أغلبهم من الرجال, وبينهم الكثير من النساء والأطفال. كما إن الحصار الاقتصادي الدولي الظالم قد اختطف مئات ألوف الأطفال وكبار السن والمرضى نتيجة سوء التغذية وانعدام الأدوية والمعالجة الطبية وتدهور البنية التحتية في البلاد.
2 . هجرة ما يزيد عن ثلاثة ملايين إنسان عراقي بين 1968-2003 من العراق, سواء أكان ذلك بسبب الهجرة القسرية, كما حصل بالنسبة للكُرد الفيلية وعرب الوسط والجنوب بذريعة التبعية لإيران, أم بسبب الحروب والهروب منها, أم لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية أخرى.
3 . خسارة كبيرة جداً من ذوي الكفاءات العلمية والتقنية والمهنية والثقافية والأدبية والفنية تحملها الاقتصاد والمجتمع في العراق, سواء أكان ذلك بسبب الموت عبر الحروب والقمع الصدَّامي, أم بسبب الهجرة المرتبطة بالكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقومية والدينية, أم بسبب الأمراض التي أصيبوا بها في فترة الحروب والحصار الاقتصادي ولم تتوفر لهم المعالجة الطبية والأدوية,
ولا بد من الإشارة هنا إلى إن الذين قتلوا أو استشهدوا في العراق كانوا في الغالب الأعم من أعمار تسمح لهم بالزواج أو كانوا متزوجين فعلاً وكانوا قادرين على الإنجاب والمشاركة في زيادة معدل النمو السكاني, ولكن هذا لم يحصل. وهي خسارة كبيرة في عملية إعادة إنتاج البشر. فالعراق لم يخسر من مات في الحروب أو قتل تحت التعذيب, بل وحرم من الأطفال الذين كان في مقدور هؤلاء الذين قتلوا إنجابهم.
5 . إن السياسات القمعية وإرهاب الدولة والحروب والحصار الاقتصادي والجوع والحرمان قد تسببت كلها وبالتضافر في نشوء علل نفسية وعصبية وجسدية وأخلاقية, إضافة إلى مئات ألوف الجرحى وعشرات ألوف المعوقين الذي يعانون اليوم ويعاني معهم المجتمع والاقتصاد الوطني من الكثير من المشكلات بما فيها الخروج من دائرة الإنتاج أو النشاط الاقتصادي العام. ومن بين العلل الاجتماعية نشير إلى ظواهر العنف والشراسة في التعامل والانتهازية, إضافة إلى الفساد الذي أصبح نظاماً سائداً في العراق.
ورغم سقوط النظام الشمولي, فأن عدد المهجرين والمهاجرين قد ازداد عما كان عليه في فترة صدام حسين بسبب نظام المحاصصة الطائفية والعمليات الإرهابية والصراعات الدينية والطائفية وعدم استقبال العائدين من ذوي الكفاءات استقبالاً حسناً, بل تحملوا الكثير من الإساءات والعزل والمرارة وأجبر الكثير منهم على العودة إلى خارج الوطن والقبول بالاغتراب الذي فضلوه عن اغتراب الإنسان في وطنه.
الزميل زيني كشف للقراء عن الحاجة الماسة لمزيد من الموارد المالية التي لن تكون موارد النفط المالية كافية لسد الحاجة الفعلية خلال العقدين القادمين. اتفق مع هذا الاستنتاج العام, شريطة أن يرتبط ذلك بتأمين تعبئة كل الطاقات المحلية والإمكانيات الخارجية لصالح تعجيل إعادة الإعمار والسير على طريق التنمية المستدامة والذي لم يحصل حتى الآن. ولكني أرى بأهمية وضرورة أن ننتبه إلى هذا الموضوع إذ إن المشكلة في العراق لا تخضع لعامل واحد هو حجم رؤوس الأموال التي يحتاجها العراق للنمو الاقتصادي, بل نحتاج إلى التفكير بعدد من العوامل الأخرى الفاعلة التي تؤثر دون أدنى ريب وبشكل مباشرة على هذه الحسابات بالزيادة أو النقصان والتي يفترض أن تؤخذ بالحسبان. لقد جرى استخدام نماذج رياضية في احتساب ما يحتاجه العراق لتسديد ديونه أو إعادة إعمار ما خربته الحروب في منتصف التسعينيات من عدد من الأخوة, منهم على سبيل المثال لا الحصر, الأخ الدكتور سنان الشبيبي الذي قدم دراسة مهمة في ندوة عقدت في فيينا ونظمها المكتب الاستشاري العراقي بإدارة السيدين أديب الجادر والدكتور مهدي الحافظ حول هذا الموضوع وطرح أرقاماً عن مدة تسديد ديون العراق وحجم النفط الذي سيصرف لهذا الغرض وحجم الموارد التي يحاجها العراق لإعادة عملية الإنتاج فيه. وعلى أهمية تلك الأرقام والاحتمالات التي طرحت, فأن الحياة قد برهنت على لوحة أخرى مختلفة بسبب الطريقة التي تم بها إسقاط النظام والقوى التي وصلت إلى السلطة وما أحيط بمجمل العملية من مصاعب ما زالت قائمة في البلاد وستبقى لفترة غير قصيرة قادمة.
أقصد هنا إن المسألة مرتبطة بعدد من العوامل المهمة, منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 . من هي القوى التي تمارس عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو البشرية, وما هي بالتحديد الإستراتيجية التي تتبناها في عملية التنمية, وهل ستتبنى التصنيع أم تبقى تعتمد على الاقتصاد الريعي النفطي بشكل خاص أم ستسعى إلى استثمار النفط لأغراض تقليص دوره لاحقاً من خلال تنويع البنية الاقتصادية من خلال عملية التصنيع وتحديث الزراعة وتنويعها وبالتالي تنويع مصادر الدخل القومي. (من المفيد هنا أن نعود إلى دراسات ومقالات عدد مهم من الاقتصاديين العراقيين, منهم السادة الدكتور صبري زاير السعدي والدكتور علي مرزا والدكتور فاضل عباس مهدي والدكتور كامل مهدي والدكتور كامل العضاض والدكتور فوزي القريشي والدكتور ماجد الصوري والدكتور وليد خدوري والأستاذ حمزة الجواهري, على سبيل المثال لا الحصر.
2 . حين البدء بوضع الإستراتيجية التنموية يفترض أيضاً تحديد إستراتيجية اقتصاد النفط الخام التي يفترض موردها المالي والنفط الخام والغاز يساهمان في عمليات الاستثمار والإنتاج في العراق, أي ربط الإستراتيجيتين معاً ليشكلا القاعدة الأساسية لعملية التنمية وتغيير بنية الاقتصاد الوطني على مدى العقدين القادمين, أي أن يكون النفط الخام, كمادة خام وكمورد مالي, القاعدة الأساسية لعملية تغيير بنية الاقتصاد العراقي وتحقق التنويع الضروري في مكونات الدخل القومي وتقليص دور إيرادات صادرات النفط الخام فيه.
3 . وكما أشار الدكتور زيني نفسه فإن المبالغ المقترحة تتغير بعد سنة أو عدة سنوات بسبب التضخم أو لعامل كثيرة أخرى, ولهذا يمكن أن تتخذ تلك الأرقام كمؤشر عام لوجهة التطور وحجم الاستثمارات المطلوبة.
4 . إن احتساب المبالغ التي تستوجبها التنمية ذات المدى البعيد 20-25 سنة تحتاج إلى رؤية تفصيلية مرتبطة بطبيعة المشاريع التي يراد إقامتها وحداثة التقنيات التي يراد استخدامها, سواء أكان ذلك في قطاع الصناعة النفطية الإستخراجية أم في الصناعة التحويلية أم في تحديث القطاع الزراعي أم في مجال التنمية البشرية, وهي الملاحظة التي أوردها الدكتور كامل العضاض في ملاحظاته المرسلة لكم عن الحلقة الأولى من “خارطة طريق اقتصادية”.
5 . كما لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار لا المبالغ المتوفرة فحسب, بل ومدى قدرات العراق الفعلية في الظروف الملموسة على التنفيذ, لكي لا نعمل على طريقة المقولة الشعبية ” الهور مرگ والزور خواشيگ”. إذ لو ألقينا نظرة فاحصة على محاولات البرمجة والتخطيط منذ أن بدأ العراق بوضع البرامج في العام 1935/1936 حتى آخر خطة وضعت في العراق التي توقفت عمليا في فترات الحروب, فإن مستوى التنفيذ, أو بتعبير أدق, مستوى الصرف قد تراوح بين 20- 40 % في أحسن الأحوال. ولا أقصد بالمثل الشعبي هنا بطبيعة الحال ما طرحه الدكتور زيني, بل أقصد إن واقع العراق يتطلب الحذر من طرح الأرقام المجردة.
6 . أما في حالة استمرار الفساد الجاري حالياً في البلاد, دعْ عنك الإرهاب, فأن على العراق أن يحسب أضعاف ما يطرحه الدكتور زيني من مبالغ للوصول إلى الحد الذي قدره للصرف الفعلي. إذ إن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى ما يلي: حين يتم تخصيص مليون دولار لإنجاز مشروع (أ) في العراق, فأن ما يصرف على المشروع من هذا المبلغ فعلياً لا يزيد في أحسن الأحوال عن 10% منه, أي بحدود 100 ألف دولار والباقي يذهب في جيوب المقاولين بين مشتر وبائع للمشروع بين عدد منهم, سواء أكان المقاولون من داخل البلاد أم من خارجه. وأعتقد إن الدكتور زيني قد شخص ذلك في دراسته القيمة عن الفساد في العراق.
انتهت الحلقة السادسة وتليها الحلقة السابعة.
28/5/2011 كاظم حبيب
قراءة ومناقشة “خارطة طريق اقتصادية” للسيد الدكتور محمد علي زيني
الحلقة السابعة
سأحاول في هذه الحلقة أن أتطرق إلى بعض المشكلات الاقتصادية الموروثة من العهود الماضية وما تراكم عليها خلال الفترة التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين والتي فيها الكثير من التأييد والاتفاق مع الأخ الأستاذ الدكتور محمد علي زيني.
حين نتابع ما كتب عن الاقتصاد العراقي خلال القرن الماضي سنجد أن لدينا كم كبير ومهم من الدراسات الاقتصادية النوعية التي تبحث في واقع الاقتصاد العراقي ومشكلاته, ولهذا يصعب أن نأتي بجديد في تشخيص الظواهر الملازمة لهذا الاقتصاد. وسأحاول هنا أن أجمع في تقديري لواقع العراق الاقتصادي والاجتماعي ومشكلاته التي تجسد التفاعل بين السياسة والاقتصاد وتجلياتها في الواقع الاجتماعي مستنداً في ذلك إلى صحة ما أشار إليه الدكتور زيني بصدد العلاقة الجدلية بين السياسة والاقتصاد وتجليات ذلك على المجتمع وأحواله.
1 . فمنذ تأسيس الدولة العراقية تحت الهيمنة البريطانية, ورغم إقرار النخب الحاكمة للدستور العراقي في العام 1925, ورغم تأييد وتوقيع العراق في العام 1948 على اللائحة الدولية لحقوق الإنسان, فأن الممارسة الفعلية كانت تتجلى في غياب الحياة السياسية الحرة والديمقراطية وتقليص الحرية الفردية وقهر الإنسان سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. ورغم أن الدولة العراقية قد امتلكت دستوراً أقر مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واستقلال القضاء. إلا إن ممارسة تلك السلطات خضعت للإرادة السياسية للسلطة التنفيذية والسفارة البريطانية وشوهت الحياة الدستورية والبرلمانية, وبالتالي لم ينعم الإنسان العراقي بأجواء تسهم في تفتحه الذهني وانطلاقته في التفكير الحر غير المقيد في فترة الحكم الملكي. وفي أعقاب سقوط الملكية كان الأمل في أن يتجه العراق صوب المجتمع المدني والديمقراطي, ولكنه سار بالاتجاه المعاكس بعد فترة وجيزة من عمر ثورة تموز 1958, وهيمنت سياسات الاستبداد والقسوة والتمييز مع الانقلابات القومية والبعثية في البلاد, والتي غاص الشعب في ربع القرن الأخيرة من عمر حكم صدام حسين في العزلة والظلمتين على حد تعبير الأستاذة بلقيس شرارة والأـستاذ رفعت الجادرجي في كتابهما النفيس “بين ظلمتين”.
2 ولا بد من الإشارة على إن الأحزاب السياسية العراقية التي نشأت في تلك البيئة غير الديمقراطية ورغم جهودها لتكون ديمقراطية, لم تكن كذلك على وفق ما يفترض أن تكون. ونحن نعيش اليوم حالة غالبية الأحزاب السياسية العراقية التي تفتقد للكثير مما يفترض أن يكون ديمقراطياً في علاقاتها الداخلية وفي ما بينها ومع المجتمع وفي استخدام السلطة السياسية.
3 . وكحال الدول العربية ودول الإقليم المجاورة لم يشهد العراق حركة نهضوية وتنوير ديني واجتماعي-ثقافي تسهم كلها في إنقاذ الإنسان العراقي من براثن التخلف في الفكر الديني الشائع وفي ممارساته الشكلية المضرة, كما إن الأحزاب السياسية لم تسع إلى خوض صراع فكري مع المؤسسة الدينية التي لم تجدد نفسها ولم تسع إلى تجديد فكر المجتمع بل سعت إلى وضعه في ثلاجة تسهم في تجميده لا تحريكه. ولهذا تراجع العراق عن ركب الحضارة البشرية, رغم انه كان في يوم من الأيام أحد مهود الحضارة البشرية.
4 . ولم يتجه التعليم في العراق صوب الدراسات المهنية والعلمية التطبيقية ومراكز البحث العلمي التي تدعم عملية التنمية الوطنية إلا بشكل محدود في أعقاب ثورة تموز 1958 والتي تطورت في ما بعد ولكن بوجهة خاطئة ذات طبيعة عسكرية رغبة من النظام الصدَّامي في العسكرة وشن الحروب والتوسع على حساب الجيران والهيمنة على “العالم العربي”.
5. والحكومات العراقية المتعاقبة التي لم تفكر بمصالح المجتمع لم تعر أيضاً عملية التنمية الاقتصادية والبشرية اهتماماً كبيراً وبالوجهة الصحيحة التي تحقق التنمية المنشودة لبلد خرج لتوه من دولة عثمانية رجعية متخلفة في الدين والدنيا. وتجلى ذلك في سياساتها الاقتصادية. ونتج عن ذلك جملة من الخصائص السلبية التي تميز العراق بها التي يمكن بلورتها في النقاط التالية:
أ . اقتصاد زراعي متخلف من حيث علاقات الإنتاج وأساليب وأدوات وطرق الإنتاج وكذلك في قواه العاملة في الزراعة. وهي الظاهرة التي استمرت تميز الاقتصاد العراقي رغم محاولات تطبيق قوانين للإصلاح الزراعي التي جوبهت بمقاومة عنيفة من القوى ذات المصلحة بالعلاقات البالية وأجهزة الدولة التي لم تتغير حتى بعد ثورة تموز 1958 بل حتى الآن من حيث الجوهر ونظم العمل البيروقراطية السائدة والفساد المالي والمحسوبية المهيمنة. ورغم أهمية الزراعة في توفير الغذاء والأمن الغذائي, فأن الاهتمام بها وفي تغيير وتنويع بنيتها كان ضعيفاً ومترديا, رغم الموارد المالية الكبيرة التي خصصت للري والبزل في سنوات العقد الثامن من القرن العشرين.
ب . اقتصاد ريعي يعتمد على اقتصاد النفط الخام في تكوين القسم الأعظم من ناتجه الإجمالي أو في تكون دخله القومي. وإذا كان القطاع في البداية بأيدي الشركات الاحتكارية الأجنبية فأن طبيعته لم تتغير حين أصبح عائداً للدولة العراقية وينفذ سياسات الحكومة العراقية. فموارد النفط المالية لم تتوجه صوب تنمية حقيقية موجهة وهادفة إلى تغيير بنية الاقتصاد الوطني, بل وجهت بالأساس لتلبية حاجات السلطة السياسية وأغراضها وحروب النظام.
ج . وبدلاً من تطوير صناعة تحويلية متقدمة وغير ملوثة للبيئة على وفق المقترحات التي تقدمت بها خبراء وزارة التخطيط, فأن مجلس قيادة الثورة كان يقرر ما يشاء وفق إرادته ورغباته وجرى التخلي عن الكثير من المشاريع المهمة التي اقترحها الخبراء. كما إن ما بني في العقد الثامن والنصف الأول من العقد التاسع وما كان موجوداً منذ العقدين السادس والسابع قد دمرته حروب النظام تقريباً. وكان الدكتور زيني محقاً في إشارته الواضحة إلى إن الاعتماد على صناعات إحلال محل الواردات لم يكن بالمطلق صحيحاً ولكنه لم يكن بالمطلق خطأ, وكذا مقترحه الأخير بصناعات لأغراض التصدير ينطبق عليها نفس المبدأ, إذ يفترض أن تتعين تلك الصناعات التحويلية على وفق إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المدروسة والمقررة وتستند إلى ما يمتلكه من موارد أولية ومنتجات ومحاصيل زراعية وإمكانيات فعلية وصناعات بتقنيات حديثة وغير ملوثة للبيئة.
د . واعتمد العراق طيلة الفترات المنصرمة حتى الوقت الحاضر على توجيه موارد البلاد صوب استيراد السلع المصنعة ولم يهتم ببنية الاستيرادات من أجل تحقيق تغيير تدريجي لبنية الاقتصاد الوطني. لهذا كانت موارد النفط المالية تصرف دون أن تحقق تراكماً رأسمالياً ضرورياً لتنشيط النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الوطنية. ولا بد لي هنا من الإشارة إلى إن الانفتاح التجاري, كما اقترحه الزميل زيني, كما أرى غير مناسب للعراق. فالانفتاح مفيد شريطة أن تتحدد فيه: ا) سياسة حمائية للإنتاج الوطني, أي سياسة جمركية لا تلغي كلية المنافسة ولكنها لا تخنق الإنتاج الصناعي الوطني, و2) سياسة تجارية تسمح بتنمية الصناعات التحويلية الوطنية وتنويع وتطوير الزراعة, و3) أن تكون هناك رقابة صارمة على النوعية والموصفات والمقاييس …الخ, و4) أن تدرس الميزان التجاري مع الدول المختلفة بعناية كبيرة لضمان تنشيط صناعتنا ومنتجاتنا الزراعية المحلية.
هـ. وقد توجه النظام منذ النصف الثاني من العقد الثامن (منتصف السبعينات) من القرن الماضي صوب التصنع العسكري والبحث العلمي فيه. وصرف مئات المليارات لهذا الغرض أو على التسلح من الخارج والتي في الغالب الأعم دمرت فيما بعد عبر الحروب والغارات عليها لتدميرها, إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.
و . وقد توجه التعليم في العراق وجهة الدراسات الإنسانية وتخلف عن الدراسات العلمية الصرفة والتطبيقية أو المهنية لسنوات طويلة. وحين بدأ في أعقاب ثورة تموز 1958 لم يتواصل بالطريقة المناسبة. ومع ذلك نشأ في العراق على مدى أكثر من نصف قرن كم رائع من الكفاءات والقدرات العلمية والفنية والمهنية التي فرط بالكثير منها في حروب النظام ومن خلال سياساته العدوانية. وجزء كبير جداً من هذه الكفاءات موجود ومشتت اليوم في خارج العراق بسب الأوضاع البائسة حالياً في البلاد. كما لا يستثمر المتاح منه في الداخل بصورة جيدة. وقد استشهد الكثير جداً من الكوادر العلمية والفنية والمهنية المتقدمة عبر عمليات الاغتيال الإرهابية بعد سقوط نظام البعث الدموي. وإذ حقق العراق في نهاية السبعينيات من القرن الماضي خطوات جيدة على طريق مكافحة الأمية بين الكبار, فأن الأمية اليوم تشكل خطراً كبيراً على البلاد يفترض معالجتها, وخاصة الأمية بين صغار السن الذين يتسربون من المدارس الابتدائية بسبب الفقر والبطالة وحرمان العائلات من القدرة على تعليم بناتهم وأبنائهم. يضاف إلى ذلك البطالة بين كبار السن, وخاصة بين النساء.
ز . يشير الدكتور زيني إلى ما يلي:
“منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة، بدأ الاقتصاد العراقي نموه في بيئة يهيمن عليها بصورة رئيسية السوق أو القطاع الخاص. وحتى بعد اكتشاف النفط في 1927 وتزايد العوائد النفطية منذ 1950 التي شجعت على تبني خطط التنمية الاقتصادية، اقتصرت معظم أنشطة الحكومة الاقتصادية على عمليات استخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض (النفط بالدرجة الأولى) وإدارة الصناعات المتعلقة بها. فالقطاعان الرئيسيان، الزراعة والصناعات التحويلية، بقيتا بأيدي القطاع الخاص بصورة كاملة تقريباً، أما الاستثمارات الحكومية فكانت تخصص لتوفير البنية التحتية مثل الطرق والجسور والنقل العام ومشاريع السيطرة على الفيضان والإرواء وتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصحة والتعليم.
ولقد استمرت هذه الحالة حتى الثورة في 1958، حيث بدأت بعدها الحكومات العراقية المتعاقبة تستثمر في القطاع الصناعي.” (راجع الحلقة الثالثة من الدراسة).
يمكن إيراد ملاحظات توضيحية لما جاء في هذا المقطع : اتفق مع الأستاذ زيني على أن الدولة الملكية لم تعتمد في نموذجها الاقتصادي على قطاع الدولة. ولكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية نشطت قوى المعارضة العراقية وطالبت الحكومة بثلاث مسائل من الناحية الاقتصادية, وهي: 1) تفعيل قانون الحماية الصناعية لعام 1929 من أجل تنشيط القطاع الخاص للتوظيف في الصناعة المحلية. ب) ضرورة بناء صناعة وطنية من خلال توظيف استثمارات حكومية في القطاع الصناعي التحويلي, إضافة إلى مشاريع البنية التحتية لأهميتها للعراق ولتشغيل العاطلين عن العمل وزيادة الدخل وتحسين السيولة النقدية والقوة الشرائية للمواطنات والمواطنين. 3) تغيير شروط امتيازات النفط الممنوحة لشركات النفط العاملة في العراق باتجاه زيادة حصة العراق والتي تحققت في العام 1952 بمفعول رجعي لعام 1951. وقد حصل العراق على 50% من عوائد النفط الخام المصدر على وفق هذا الاتفاق وازدادت عوائده النفطية.
وبهذا ازداد الضغط على الحكومة لإقامة مشاريع في القطاع الصناعي التحويلي برؤوس أموال حكومية. وقبل ذاك كانت الحكومة قد بدأت في العام 1948/1949 بإقامة مشاريع في صناعة الأسمنت تابعة للحكومة.
في العام 1951/1952 تم إنشاء مجلس ووزارة الإعمار ومن خلاله أمكن إقامة العديد من المشاريع الصناعية التحويلية المهمة في العراق, كما شارك المصرف الصناعي الذي تم تأسيسه في العام 1940 بموجب القانون رقم 12 لسنة 1940, ولكن نشاطه الفعلي بدأ في العام 1947 بموجب القرار رقم 41 لسنة 1947, حيث بدأ بمنح القروض أو المشاركة في رأس مال بعض المشاريع الصناعية. )Hamoud, Abdul Rasool. Einige Probleme der Leitung und Finanzierung des staatlichen Sektor der Industrie im Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1968.)
وعلى هذا, وبالرغم موقف الحكومة الرافض للتوظيف في القطاع الصناعي, فأن الجهات التالية أبدت في حينها اهتماماً ملموساً بالقطاع العام الصناعي, وهي:
مجلس الإعمار ووزارة الإعمار.
المصرف الصناعي.
اتحاد الصناعات العراقي.
دائرة الشؤون الصناعية في وزارة الاقتصاد العراقية.
مصلحة المنتجات النفطية التي تركز نشاطها على تطوير صناعة تكرير النفط الخام وتسويق منتجاته.
انصبت جهود هذه المؤسسات, وفق سياسة الحكومة العراقية, على إقامة المشاريع الصناعية الاستهلاكية الخفيفة بشكل عام, إضافة إلى تنمية صناعات الأسمنت من جانب مجلس الإعمار لارتباط ذلك بمشاريع الري والبزل وإقامة السدود والخزانات المائية حينذاك, كما تركزت اتجاهات النشاط لهذه المؤسسات في:
إقامة مشاريع تابعة كلية لقطاع الدولة.
إقامة مشاريع صناعية برأسمال مختلط حكومي وخاص محلي.
تقديم القروض المالية لإقامة المشاريع الصناعية, سواء أكانت خاصة أم مختلطة من جانب المصرف الصناعي.
تركزت جهود مجلس الإعمار ووزارة الإعمار على إقامة مجموعة من المشاريع الصناعية خلال الفترة الواقعة بين 1951-1958, تم إنجاز ثلاثة منها قبل وقوع ثورة تموز عام 1958, كما استمر العمل بخمسة مشاريع أخرى أنجزت في أعقاب الثورة. وكانت المشاريع الثلاثة المنجزة هي مشروع إنتاج الإسمنت في سرچنار في السليمانية, ومشروع الغزل والنسيج في الموصل, ومشروع الإسفلت في القيارة في الموصل. أما المشاريع الصناعية التي أنجزت فيما بعد فكانت مشروع السكر في الموصل, ومشروع المنتجات القطنية في الهندية, ومشروع الإسمنت في حمام العليل في الموصل, ومشروع السجاير في السليمانية, ومشروعات إنتاج الطاقة في أبو دبس وبغداد والنجيبية .., وتم إنجاز هذه المشاريع في أوائل الستينات من القرن الماضي.
وكان نشاط الدولة الصناعي قد تركز قبل ذلك على مجالين أساسيين بالنسبة للاقتصاد العراقي, وهما قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية, ومصافي النفط الخام. فحتى عام 1958 كان القطاع الحكومي يمتلك مشاريع مهمة لإنتاج الطاقة الكهربائية الموجهة لأغراض التنوير أو لتزويد المنشآت الاقتصادية بالطاقة الضرورية. . فقد وجدت في العراق 14 محطة لإنتاج الطاقة المحلية في مراكز المدن العراقية, إضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في العراق, التي بلغت طاقة إنتاجها 70% من إجمالي إنتاج الطاقة في العراق. راجع في هذا الصدد:
)Zain Al-Abidin, Khalid Hamid. Zur Rolle und Problematik des Staates und des Staatssektors in der Industrie des Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 76.(
وعلى العموم فقد وجدت في العراق حتى عام 1954 (49) منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية, بلغ مجموع العاملين فيه 1359 شخصاً, كما كان هناك 22 منشأة تنتج الكهرباء وتزود السكان بالماء أيضاً, بلغ عدد العاملين فيها 1384 شخصاً. وفي ضوء التطور النسبي الذي شهدته الصناعة الوطنية وانتشار نسبي لاستخدام الكهرباء في المدن العراقية, أمكن تسجيل زيادة ملموسة في السعات الإنتاجية لمحطات الموجودة ولإنتاج الطاقة فعلاً في العراق خلال الفترة الواقعة بين 1951-1958. ففي الوقت الذي بلغت السعة الإنتاجية 394.200 ألف كيلووات/ ساعة في عام 1951, ارتفعت في عام 1958 إلى 840.084 كيلووات/ ساعة. وارتفع إنتاج خلال ذات الفترة من 164.901 إلى 620.074 كيلووات/ ساعة موزعاً على الاستخدام الصناعي والتنوير السكاني بتناسب متقارب 1:1 تقريباً في عام 1951, إلى تناسب بلغ أكثر من 1,5:1 لصالح الاستخدام الصناعي في عام 1958.
امتلك العراق حتى عام 1951 مصفى واحداً لتكرير النفط هو مصفى الوند في خانقين الذي اشتراه من شركة نفط خانقين. وكانت القوى السياسية المعارضة للحكومة تضغط دوماً باتجاه زيادة عمليات تصنيع النفط الخام في العراق بدلاً من تصدير الكمية الكبرى منه. ولكن هذه الرغبة كانت تصطدم باستمرار بموقف حازم من شركات النفط الأجنبية التي كانت تريد الاحتفاظ بذلك لاقتصادياتها من جهة, وإبقاء الأسواق المحلية مفتوحة لمنتجاتها النفطية, إضافة إلى خشيتها من نمو جديد في البنية الطبقية في المجتمع العراق. ولكن تشكيل مصلحة المنتجات النفطية وتسليمها مسؤولية إدارة مصفى الوند وشركة نفط خانقين مسؤولية التفكير بمشروعات جديدة لتكرير النفط الخام. وظهرت في العراق تدريجا منشآت صناعية جديدة لتكرير النفط الخام, إضافة إلى المنشأة القديمة, كما يظهرها الجدول التالي:
منشآت مصافي النفط العراقية
| عدد العاملين نهاية 1958 |
الطاقة الإنتاجية /مليون طن |
رأس المال د. عراقي |
سنة التشغيل | الموقع | المصفى |
| غ.م.** | 0.50 | 1.0 | 1927 | خانقين | الوند |
| 340 | 0.40 | 2.2 | 1955 | الموصل | القيارة |
| 1153* | 2.65 | 23.7 | 1955 | بغداد | الدورة |
| غ.م. | 0.25 | 0.4 | 1952 | البصرة | المفتية |
| 3.750 | 27.3 | 4 مصافي |
Zain Al-Abidin, Khalid Hamid. Zur Rolle und Problematik des Staates und des Staatssektors in der Industrie des Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 104. * 1000 مشتغل عراقي و 153 خبير وفني أجنبي. ** غير متوفر.
انتهت الحلقة السابعة وتليها الحلقة الثامنة والأخيرة.
2/6/2011 كاظم حبيب
قراءة ومناقشة “خارطة طريق اقتصادية” للسيد الدكتور محمد علي زيني
الحلقة الثامنة والأخيرة
أشرت في أول حلقة من حلقات هذه السلسلة النقاشية إلى إن الزميل الدكتور محمد علي زيني قد حرك لديَّ ولدى آخرين بالضرورة جو الحوار الموضوعي والهادف والمسؤول حول واقع ومشكلات وحاجات واتجاهات تطور الاقتصاد العراقي من جهة, وأن في دراسته جملة من الأفكار التي أتبناها معه أو لدي تحفظات على بعضها الآخر أو أراء أخرى تستحق المناقشة وردت في حلقاته السبع الخاصة بـ”خارطة طريق اقتصادية” للعراق. وسأحاول في هذه الحلقة الأخيرة هنا أن أشير إلى أهم تلك الأفكار المهمة التي أتفق فيها معه أو أتحفظ على بعضها أو جوانب منها مع الزميل الدكتور زيني والتي تحتل أهمية بالغة بالنسبة للعراق:
1 . بلورته الصائبة لمشكلات التخلف التي كان وما يزال يعاني منها الاقتصاد العراقي والمجتمع, إضافة إلى معاناتهما من سياسات العسكرة والحروب والحصار الدولي والدمار سنوات طويلة, وكذلك الخسائر البشرية الكبيرة التي تحملها المجتمع طيلة العقود المنصرمة حتى الوقت الحاضر.
2 . إشاراته المهمة والواضحة إلى غياب العدالة الاجتماعية في توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي في العراق وسوء استخدامه في آن واحد.
3 . إشارته إلى التشوه الملازم لبنية الدخل القومي الناتجة عن وحدانية الطرف في الاقتصاد العراقي, الاقتصاد الريعي النفطي على نحو خاص, وضرورة تغيير هذه البنية لصالح التنوع والتحديث.
4 . إشارته الصائبة إلى أن إجمالي الناتج المحلي أو الدخل القومي والمعدل السنوي لحصة الفرد الواحد منهما لا يعكسان الواقع الفعلي لمدى تقدم أو تخلف اقتصاد معين, إذ لا بد من معرفة تفاصيل بنية الإنتاج أو الدخل القومي أولاً, كما لا يعكسان عدالة توزيع الدخل القومي في المجتمع بل يغطيان على عدم العدالة السائدة في العراق مثلاً, ولكي نستطيع التعرف الدقيق على طبيعة وبنية الدخل القومي وعلى غياب عدالة التوزيع للدخل القومي بين فئات وأفراد المجتمع يفترض أن ندخل في تفاصيل المؤشرين وتجلياتهما في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية المختلفة.
5 . إشارته إلى أهمية وضرورة وجود إستراتيجية تنموية للاقتصاد العراقي ولا بد من استخدام التخطيط لهذا الغرض, إضافة إلى إستراتيجية نفطية مرتبطة بها وتشكل جزءاً منها.
6 . تأكيده أهمية وضرورة التصنيع الوطني لتحقيق التنمية الفعلية المنشودة وإرساء الاقتصاد الوطني على قاعدة صناعية متماسكة.
7. ضرورة الاستفادة القصوى من الزراعة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
8 . إشارته إلى أهمية تغيير بنية التجارة الخارجية لضمان تحقيق التنمية الصناعية والزراعية.
9. الاهتمام الرئيسي بالقطاع الخاص ومنحه الإمكانيات لزيادة دوره ونشاطه في الاقتصاد الوطني.
10 الاستفادة من إمكانيات رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد العراقي وكذلك من جوانب العولمة الإيجابية وتجنب مزالقها السلبية.
ولكن إزاء هذه النقط وغيرها, إضافة إلى ما أشرت إليه في الحلقات السابقة, بعض ما اختلف فيه جزئياً أو كلياً, مع الأخ الفاضل الدكتور زيني, منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 . رفضه لأي دور يفترض أن يشارك فيه قطاع الدولة في النشاط الاقتصادي الإنتاجي, ومنح الدولة دور المراقب لما يجري في البلاد, وجعل القطاع الخاص ليس له الدور الرئيسي في العملة الإنتاجية فحسب, بل الدور الوحيد له. أي إنه يخرج قطاع الدولة من النشاط الاقتصاد, وخاصة الإنتاجي كلية, وهو ما أختلف معه عليه من الناحيتين المبدئية والعملية وفي ظروف العراق الملموسة. إذ علينا أن نلاحظ بعناية عدة مسائل في هذا الصدد: أ) إن الدولة العراقية مالكة كبيرة لمورد أولي ضخم هو النفط الخام وقادرة بأموال النفط الخام تأمين الاستثمار في نشاطات اقتصادية إنتاجية في مجال الصناعة التحويلية إلى جانب الصناعة الإستخراجية وفي إقامة سلسلة من العمليات والمشاريع الإنتاجية الأمامية والخلفية ليس في مقدور القطاع الخاص النهوض بها أو يفترض من الوجهة الاجتماعية أن ينهض بها القطاع العام وليس القطاع الخاص, وب) كما إن مستلزمات تطور القطاع الخاص في العراق حالياً غائبة حقاً وليس بمقدور القطاع الخاص النهوض بالعملية الإنتاجية في عموم البلاد, والتي لا يمكن توفيرها له خلال السنوات العشر القادمة وأكثر منها إن بقيت الأوضاع فترة أخرى على ما هي عليه الآن, وج) كما يمكن لقطاع الدولة أن ينشط معه القطاع الخاص بإقامة قطاع مختلط, حكومي وأهلي, وقطاع تعاني يدعمه بمساعدات مالية وفنية وخبرات أيضاً, إضافة على مساعدة ودعم القطاع الصناعي الصغير الحرفي الذي يعاني اليوم من منافسة حادة غير متكافئة من جانب السلع المصنعة المستوردة.
2 . ومع الاتفاق بأهمية وضرورة مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق, فأن من الواجب أن نحدد ثلاث مسائل جوهرية في هذا الصدد ونبتعد عن أن يكون الباب مفتوحاً أمام رؤوس الأموال الأجنبية دون شروط مناسبة للعراق: أ) أن تحدد الدولة المجالات التي يحتاجها العراق لتوظيف الاستثمارات الأجنبية فيها, سواء أكانت في اختيار القطاعات الاقتصادية النوعية, أم بالنسبة إلى مناطق التوظيف التي يستوجبها التقدم الاقتصادي للمحافظات أو التوطين الصناعي مثلاً, ب) أن يلتزم الرأسمال الأجنبي بالقوانين العراقية, ومنها بشكل خاص قانون العمل والعمال وأن يلتزم بتشغيَّل الأيدي العاملة العراقية من عمال وفنيين وإداريين …الخ, ج) وأن تحدد نسبة مناسبة لتصدير الأرباح المتحققة له, وأن يعيد توظيف نسبة من أرباحه السنوية في تحسين وتطوير تلك المشاريع الصناعية أو التوسع فيها لتحقيق التراكم الرأسمالي الذي تستوجبه عملية التنمية. كما يمكن للدولة أن تقدم له تسهيلات مهمة أيضاً لغرض تشجيع المستثمرين بتوظيف رؤوس أمواله في الاقتصاد العراقي.
3 . إن نموذج اقتصاد السوق الحر الذي يؤكده الدكتور زيني, وبالطريقة التي يدعو إليها والتي تلتقي مع نموذج باول بريمر والمؤسسات المالية والنقدية الدولية, يعني دون مواربة إطلاق العنان لآليات السوق بالعمل بصورة عمياء, وهي دون أدنى ريب ستقود أكثر فأكثر إلى مزيد من الاختلالات الشديدة في الاقتصاد العراقي وإلى تشديد الاستغلال وإلى تعميق التناقضات الاجتماعية, إذ إن الهدف الأساسي سيكون في مثل هذه الحالة زيادة حجم الأرباح التي يحققها رأس المال وليس التوفيق بين المصلحة الخاصة لصاحب رأس المال والمصلحة العامة أو المصالح الاجتماعية عموماً. وما طالب به الزميل زيني لا يتعدى رقابة حكومية معينة لا تثمر كثيراً ولا تخفف من تفاقم التناقضات الاجتماعات والصراعات الطبقية والنزاعات السياسية المحتملة جداً. إن الاتفاق على نموذج اقتصاد السوق لا يعني بأي حال الالتزام بالنموذج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية الحرة, وهي مؤسسات تريد إطلاق العنان للقطاع الخاص والخصخصة والتجارة الخارجية المفتوحة تماماً والتي تقود كلها إلى ما لا تحمد عقباه على المجتمع. إلى عكس ما يقول به الدكتور زيني بأهمية التصنيع والزراعة. فالتجارة الحرة لا تجلب المنافع للبلاد, بل تجلب الكثير من الأضرار ما لم نتعامل بطريقة عقلانية في هذا القطاع الحيوي, أي ما يمكن ويما يفترض أن نستورده لتنمية القطاعين الصناعي والزراعي وتنشيط الإنتاج الصناعي الصغير .. الخ. في مقابلة صحفية مع المدى قدم الدكتور صالح حسن ياسر أفكاراً واضحة على النتائج التي ترتبت حتى الآن عن السياسات التي فرضها بريمر في العراق والتي ما تزال متواصلة حتى اليوم. (راجع: جريدة التآخي, العدد 5889 بتاريخ 17/6/2010, ص 7). إن ما أدعو إليه, وفي إطار المرحلة التي يمر بها العراق, هو اقتصاد السوق المقيد بقوانين اقتصادية واجتماعية تحد من المنافسة المدمرة للصناعة والزراعة المحلية والموسعة للبطالة والمشددة لاستغلال الطبقة المنتجة, الطبقة العاملة. أي نحن بحاجة إلى حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع والطبقة العاملة, بمفهمها الواسع, التي تبيع قوة عملها الجسدية والفكرية لصحاب رؤوس الأموال, أي العمل من أجل ضمان الأخذ باقتصاد السوق الاجتماعي.
4 . إن العدالة الاجتماعية التي يقترحها الزميل زيني مهمة, ولكن النموذج الذي يقترحه, أي اقتصاد السوق الحر غير المقيد بقوانين اقتصادية واجتماعية, والتي نلاحظها بوضوح كبير في الدول الرأسمالية الأكثر تطوراً, يقود إلى نشوء “أمتين” في البلد الواحد, إلى أمة فقيرة وكادحة, وأمة غنية ومتنعمة, إلى أمتين تختلفان في مستوى الحياة والمعيشة والثقافة كلية وتتسع الفجوة بينهما ويحتدم التناقض وتتفجر الصراعات وتنشا النزاعات الطبقية السياسية, ويتباين مستوى متوسط الأعمار وامتيازات أخرى كثيرة بين “الأمتين”. ولهذا فالطرح الشكلي للعدالة الاجتماعية لا يقود إلى عدالة اجتماعية مناسبة بل إلى مزيد من تغييب العدالة الاجتماعية.
5 . ورغم تحذيره من جوانب العولمة السلبية, وهو تحذير وارد وضروري, ولكنه يقترح علينا الانفتاح الكامل على السوق الدولي والتجارة الخارجية التي يعتبرها مفتاح التطور وجني المنافع, في حين إنها تعطل دون أدنى ريب أي توجه فعلي لدعوته الجادة لتصنيع العراق وتنمية الزراعة وتحديثها وحماية الإنتاج الصناعي السلعي الصغير.
6 . كما أني أختلف مع الزميل زيني بشأن دعوته لخصخصة المنشآت الصناعية الباقية التابعة لقطاع الدولة. إذ إن عليه أن يتابع بأن العيب ليس في ملكية الدولة لوسائل الإنتاج, بل في طبيعة الدولة وأجهزتها الإدارية المتسمة بضعف الإدارة والتخلف والفساد والذي يفترض تغييره. فلا يجوز, كما أرى, الدعوة وبشكل مطلق إلى الخصخصة, بل دراسة كل مشروع ورؤية ما يمكن عمله لصالح تطويره وتحسين أوضاعه على أسس اقتصادية ومحاسبية سليمة. وعلينا أن نلاحظ الضغوط التي سلطتها المؤسسات المالية الدولية على العراق لتشطب على نسبة عالية من ديونه في مقابل الأخذ بشروط هذه المؤسسات, ومنها الخصخصة في فترة كان أياد علاوي رئيساً للوزراء ومن بعده إبراهيم الجعفري. واليوم, إذ تعاني اليونان من أزمة اقتصادية ومالية حادة اقرب إلى إفلاس الدولة, اشترطت دول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية تقديم القروض لها في مقابل خصخصة كاملة لكل مشاريع الدولة الاقتصادية, وسواء أكانت مشاريع البنية التحتية أم الصناعة التحويلية, وهو أمر يقود إلى مزيد من المشكلات للفئات الاجتماعية الفقيرة والمنتجة ولكنه يجلب الأرباح لأصحاب رؤوس الأموال الذين استفادوا من إفلاس الدولة والدول المتقدم صناعياً في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا. إن اقتراب اليونان وإسبانيا والبرتغال من حالة الإفلاس ترتبط مباشرة بسياسات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والمالية والنقدية (تعميم اليورو) التي جمعت دولاً ضعيفة التطور مع دول متقدمة دون أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية الدول الضعيفة من الدول الأكثر تطوراً في إطار الاتحاد الأوروبي. إنها نتيجة منطقية ربما ستلحق بها دول أخرى من شرق أوروبا, مثل رومانيا أو هنغاريا أو بلغاريا على سبيل المثال لا الحصر.
7 . هناك جملة من المسائل الأخرى التي تستوجب من الدكتور محمد علي زيني الولوج إليها بدلاً من الإشارة إلى جوانب من الاقتصاد الكلي, بل إلى الاقتصاد الجزئي أيضاً, وخاصة في موضوع التصنيع. إذ لا ينفع الحديث عن التصنيع بشكل عام, بل ما نريد أن نصنعه في العراق في الفترة القادمة. وهذه المهمة يفترض أن تنهض بها وزارة التخطيط ومن هو ملم تماماً بأوضاع القطاع الصناعي والزراعي. إذ لا بد هنا من الولوج إلى تفاصيل التنمية الصناعية وطرح النموذج المناسب لهذه العملية على المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة. هناك جملة من الدراسات المهمة التي طرحت خلال الأشهر الأخيرة, منها دراسة الأخ الدكتور علي مرزا بشأن التصنيع, ومقالة الأخ الدكتور فوزي القريشي عن التصنيع أيضاً, وكذلك الدراسة الجديدة التي ينوي نشرها الأخ الدكتور كامل العضاض عن الاقتصاد الريعي (النفط) ودراسات للأستاذ حمزة الجواهري التي نشرت في موقع الحوار المتمدن في 8 حلقات تحت عنوان “من أجل إدارة أفضل لتنفيذ عقود النفط” في العراق و3 حلقات حتى الآن تحت عنوان “من أجل بناء قطاع خاص في الصناعة النفطية”, وهي مادة غنية تستوجب من الباحثين والاقتصاديين والمختصين بشؤون اقتصاد النفط والصناعة التحويلية المناقشة الجادة والمسؤولة والهادفة إلى توضيح الموقف من هذا القطاع ومهماته ودوره في إستراتيجية التنمية الوطنية المستدامة, إضافة إلى غيرها من الدراسات وغيرهم من الباحثين.
8 . إن متابعة اتجاهات التطور الاقتصادي والاجتماعي في العراق خلال السنوات الثمانية الأخيرة تؤكد مسألة مركزية في الجانب الاجتماعي, وهي التي يفترض أن تكون محط دراسة ومتابعة من جانب الباحثين في الاقتصاد والمجتمع في العراق, وأعني بها الفجوة الدخلية المتسعة في العراق بين الفئة الغنية والحاكمة من جهة, وفئات المجتمع الكادحة والفقيرة من جهة أخرى. والغنى الذي حصل للفئة الحاكمة والغنية لم يأت جراء عملهم وعرق جبينهم, بل وفي الغالب الأعم من جراء الفساد المالي ونهب قطاع الدولة ودور الشركات الأجنبية في نهب العراق وفي تنشيط عمليات الإفساد التي تساهم بدورها بتنشيط الإرهاب والقتل. لقد تضاعف عدد أصحاب الملايين والمليارات من الدولارات في العراق بفترة وجيزة عدة مرات. واغلب هؤلاء نجدهم في صفوف الفئة الحاكمة الجديدة وأحابها السياسية وكذلك الأفراد والجماعات القريبة من الحكم وتلك العاملة في قطاع النفط والمقاولات والتجارة الخارجية, وهم من المقربين للفئة الحاكمة والمحيطين بها أيضاً. وتقدم التقارير الدولية وهيئة النزاهة والشفافية مواد دسمة حول هذا الموضوع وكذلك مقالات الدكتور زيني نفسه وكذلك مقالات الأستاذ سلام إبراهيم كبة المنشورة في موقع الحوار المتمدن وغيرها عن الفساد السائد في العراق.
9 . وإذ يسجل الواقع العراقي نمواً واضحاً في الطبقة الوسطى في أجهزة الدولة والمقاولات والتجارة, نلاحظ عدم وجود أي نمو ملموس ومهم في قاعدة الطبقة الوسطى الصناعية والزراعية, وهي المشكلة الناشئة عن سببين: أ) السياسة الاقتصادية التي تبتعد عن التصنيع وعن دعم القطاع الخاص لإقامة المشاريع الصناعية بسبب منافسة الاستيراد المفتوح للسلع المنتجة محلياً, بما فيها الصناعة الصغيرة, وب) وجهة القطاع الخاص في العمل في القطاعات التي تجلب له الأرباح السريعة والمضمونة والعالية. وغياب الطبقة البرجوازية الوطنية المتوسطة في قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي, إضافة على ضعف نمو الطبقة العاملة في هذه القطاعات تسهم بدورها في إعاقة السير صوب بناء المجتمع المدني الديمقراطي الحر.
10 . المشكلة التي لم يعالجها الزميل زيني وتمس الاقتصاد الزراعي, هي مشكلة الأرض الزراعية التي تشير إلى اختفاء فعلي لما تبقى من قانون الإصلاح الزراعي وعودة العلاقات القديمة إلى سابق عهدها, وبالتالي يصعب تأمين تطور ملموس في الزراعة ما لم تعمد الدولة إلى تطبيق فعلي لقوانين الإصلاح الزراعي وتقديم الدعم للفلاحين للبقاء في الريف والمشاركة في الإنتاج الزراعي. إن سياسة الدولة التجارية تسهم في مزيد من هجرة الفلاحين من الريف والزراعة إلى المدينة, خاصة بعد أن قطع أي دعم للسلع الزراعية المنتجة محلياً من جانب الدولة, وهي السياسة التي تروج لها المؤسسات المالية والنقدية الدولية.
11 . ولم يعالج الزميل زيني السياسة المالية والنقدية وقضايا التأمين التي تعتبر كلها ادوات تنفيذية للسياسة الاقتصادية والتي كان المفروض أن يبحث فيها لنتبين الوجهة التي يتبناها ويدعو لها في ضوء النموذج الاقتصادي الذي تبناه,
12 . كان المفروض أن يعالج الزميل زيني الإدارة الاقتصادية المتخلفة في العراق ومشكلاتها وسبل تغيير هذا الواقع, وهي لا تمس قطاع الدولة فحسب, بل القطاع الخاص أيضاً ومجمل العملية الاقتصادية. ولا بد هنا من التفكير في سبل تجديد الإدارة الاقتصادية ونظم العمل الإداري ودمقرطته وزيادة رقابة المجتمع المدني عليه ومشاركة الفرد في ذلك. إن الإدارة الاقتصادية غير البيروقراطية والفعالة والمستندة إلى الأساليب العلمية, (الإدارة علم وفن في آن واحد) الحديثة في هذا المجال وتطبيق مبادئ المحاسبة الاقتصادية التي تسهم لا في إنجاح المشاريع الاقتصادية فحسب, بل وتسهم في رفع إنتاجية العمل وإجمالي الإنتاج وتقليص التكاليف وتحسين ظروف العمل وعلاقات العمل وأجور العاملين وظروف حياتهم… الخ.
وأخيراً شكراً جزيلاً للأستاذ الدكتور محمد على زيني على نشر دراسته القيمة الموسومة “خارطة طريق اقتصادية” للعراق التي فسحت في المجال لأهميتها على النقاش والتمعن في أوضاع العراق الاقتصادية والاجتماعية. أتمنى أن لا أكون قد أخطأت بحق زميلي الفاضل الباحث والكاتب الأستاذ الدكتور محمد علي زيني ودراسته القيمة.
3/6/2011 كاظم حبيب
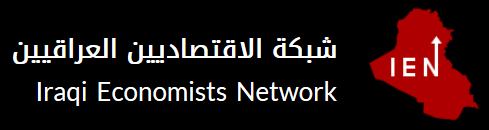



ليس بوسعى مناقشة كل ما طرحه الاستاذ الدكتور كاظم حبيب حيث تطرق فى مداخلاته الى مجمل حركة الاقتصاد الدولى والعولمة واللبرالية الجديدة والقديمة والخصخصة والتحول الى اقتصاد السوق وازمات النظام الراسمالى وغير ذلك والدكتور كاظم حبيب واحدا من ااقتصاديين المعروفين عراقيا وعربيا ودوليا
اريد التعليق على جملة واحدة وردت فى مناقشته لدراسة الدكتور محمد على زينى حيث يقول ما نصه ( ليس العيب فى ملكية الدولة لوسائل الانتاج بل فى طبيعة الدولة واجهزتها الادارية المتسمة يضعف الادارة والتخلف والفساد)
هذا الاعتراف من الدكتور كاظم حبيب يضع الامور فى نصابها الصحيح وهو اى الدكتور كاظم حبيب يتطابق بل يتفق تمام الاتفاق مع روح وجوهر دراسة الدكتور محمد على زينى
كيف؟
ان الخصخصة (او الخوصصة ) وهى التمهيد للتحول الى اقتصاد السوق والتى بدات فى المملكة المتحدة كان دافعها صعوبة احكام الرقابة على موسسات القطاع العام ( فى ظل اسلوب الادارة البيروقراطى الحكومى)
لم يكن القطاع العام فى العراق مجموعة من الفاسدين لا ابدا كما يضم نخبة من الاداريين والمهندسين المخلصين فى اداء عملهم الوظيفى ومعظم قادة القطاع العام ومن بقى منهم على قيد الحياة يعيشون عيش الكفاف
العيب فى اسلوب الادارة البيروقراطى الحكومى (لا يمكن تغيير البيروقراطية الحكومية) اذا حاولت ستكون مثل ذلك المعلم الذى يعلم رجل عمره مئة سنة قيل له ماذا تعمل قال اغسل الحبشى لعله يبيض! فتامل
– انخفاض انتاجية العمل فى القطاع الحكومى لعدم وجود الحافز الشخصى (راجع دراسة الدكتور محمد سلمان حسن بهذا الخصوص)
-اعتماد القطاع العام فى العراق ولحد الان على الموارد العامة للدولة فى تمويل استثماراته وعلى ضمان الدولة والمصارف احكومية التى تقدم له القروض والتسهيلات دون ان يساهم هذا القطاع (عدا قطاع التجارة الاستيرادى والقطاع المصرفى العام) ومساهمتهما محدودة فى تحقيق ارباح مرتبطة بالانتاجية وانما بطريقة التسعير(الكلفة +)
-لم يستطع القطاع العام تجديد اصوله المستهلكة والمندثرة محاسبيا واقتصادياا اى فى السجلات وفى القيمة السوقية لها
بدلا من ان يقوم القطاع العام بتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة صار عبئا عليها وهناك حوالى 400 الف منتسب فى القطاع العام الصناعى معظمهم يستلمون الرواتب الشهرية دول عمل والجهات الحكومية المختصة تتفرج
لناخذ مثلان لا يقاس عليهما من الدول الاشتراكية ولا مناقشة فى الامثال كما يقال!
الاول – حدثنى الشهيد الدكتور صباح الدرة انه حصل عطل فى سيارته وكان انذاك فى بلغاريا وانه ادخل السيارة الى احد الكراجات هناك ودفع الفاتورة وفى اليوم التالى وجد الخلل كما كان فعاد الى الكراج فقيل له (سيارتك لم تدخل الكراج) ليس هناك امر عمل يثبت دخول السيارة الى الكراج (يعنى العاملون فى الكراج حرامية)
الثانى وصلت الى هنكاريا مساء وكان المطر شديدا دخلت فندق قيل لى لا توجد غرفة شاغرة ذهبت الى فندق اخر ثم الى ثالث قالوا لى يوجد سويت فقط فى اليوم التالى اتصلت بالسفارة العراقية بصديق وشرحت له ما حصل قال لى الم يكن معك بطل ويسكى من الطائرة قلت يا لغبائى لغبائى كيف فاتتنى!
فى الختام احى كل من الدكتور على زينى والدكتور كاظم حبيب على اتاحة الفرصة لرجل مثلى عاطل عن العمل ولا اقول متقاعد ( لان التقاعد يذكرنى بقول اشاعر الجاهلى اذ يقول
ولقد علمت وما الاسراف من خلقى ان الذى هو رزقى سوف ياتينى
اسعى اليه فيعيينى تتطلبه ولو قعدت اتانى لا يعننى