كتاب إلكتروني مجاني:
أوراق اقتصادية ونفطية -العراق والعالم المجلد الرابـــع.
د. علي مرزا*
صدر المجلدان الأول والثاني لهذا الكتاب في شباط/فبراير 2021، ويحتويان، فيما بينهما، دراسات وبحوث وتعليقات وتعقيبات كتبتها ونشرتها، باللغة االعربية، خلال السنوات 2011-2020. أما المجلد الثالث فلقد صدر في نيسان/أبريل 2023 وهو يحتوي ما كتبته ونشرته خلال الفترة نيسان/أبريل 2021-نيسان/أبريل 2023. وهو يشمل، أيضاً، مواضيع تتعلق بالسياسات والمسائل (issues) والتطورات الاقتصادية/الاجتماعية والنفطية/الغازية والمؤسسية في العراق، قصيرة/متوسطة وبعيدة المدى. أما هذا المجلد (الرابع) فهو يحتوي ما كتبته ونشرته خلال الفترة نيسان/أبريل 2023-آذار/مارس 2025. وهو يشمل، مواضيع متعددة نفطية/غاز طبيعي ونقدية تتعلق باختلال التوازن في سوق الصرف ومالية تتعلق بعلاقة الموازنة الإتحادية وميزان المدفوعات وموازنة القطاع العائلي/الخاص وباقي الموازنات والدين العام الداخلي والخارجي. وتشمل المواضيع أيضاً قضايا تنموية تتصل بالدوافع والتوجهات التنموية والسمة الريعية للاقتصاد خلال المائة سنة الأخيرة وكذلك ملاحظات حول خطة التنمية الوطنية 2024-2028. هذا إضافة لورقة حول التفاوت الاقتصادي في العراق.
وتنصرف الورقة الأولى إلى مسألة معالجة الغاز الطبيعي وتوفره خلال السنوات الماضية والمستقبلية واستمرار حرقه. حيث يتبين من الورقة أن الجهود الحالية في معالجته وتوفيره وتقليل حرقه هي جهود مرحب بها وفي الاتجاه الصحيح. ولكن هناك ملاحظات حول اسبقيات الاستثمار والجهات التي تقوم به والتوقيت الزمني لإيقاف حرق الغاز. كما تثير ملاحظة مهمة تتعلق بعدم وجود منظور outlook، حديث، متوسط/بعيد الأمد حول النفط/الغاز/الطاقة في العراق. إذ أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة INES وضِعَت قبل أكثر من عشر سنوات، والتي تغيرت الظروف العالمية والمحلية خلالها بشكل جوهري، لا سيما مدى سرعة التوجه نحو الطاقات المتجددة، من ناحية، واختلاف الطاقات الإنتاجية المتحققة للنفط والغاز في العراق خلال العقد المنصرم عما ورد فيها، من ناحية أخرى. كما تتناول الورقة مسألة أسعار الغاز المستورد للعراق وكذلك الاستثمار المشترك في انتاجه.
وفي مجال اختلال التوازن في سوق الصرف في العراق تتناول ثلاث أوراق في هذا المجلد مسألة الطلب والعرض على الدولار ودور السوق الرسمي (النافذة/المنصة) والسوق الموازي في تحديد سعر الصرف الموازي ودور الرقابة الدولية (وزارة الخزانة الأمريكية/الاحتياطي الفدرالي) في هذا المجال. وبالرغم من استمرار التصريحات بقرب انتهاء الفجوة الملموسة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي لا زالت الفجوة واسعة نسبياً حيث بلغت نسبة الفجوة بينهما حوالي 13% (نسبة الفرق للسعر الرسمي) في نيسان/أبريل 2025، مما يبين استمرار اختلال التوازن في أسواق الصرف. هذا بالرغم من أن توجه البنك المركزي العراقي للتحول في تمويل استيرادات القطاع الخاص من اسلوب النافذة/المنصة إلى أسلوب التمويل من خلال خطابات الائتمان letters of credit، في هذه السنة 2025، استُهدف منه المساهمة في تقليل نسبة الفجوة، من ناحية، ومكافحة غسيل الأموال بما فيها أموال الفساد، من ناحية أخرى. لذلك بالرغم من أن الأوراق الثلاث حول سوق الصرف، في هذا المجلد، تغطي، فيما بينها، الفترة 2022-تموز2024 فقط، ولكن يمكن استخدام منهجية التحليل والأرقام والعرض فيها لبيان أن التفاعل في سوق الصرف الموازي بين الطلب على الدولار (ومن ضمنه ذلك الذي لم يشبع في السوق الرسمي)، من ناحية، والعرض منه، من ناحية أخرى، قاد إلى توازنهما/مساواتهما عند سعر صرف موازٍ تخطى سعر الصرف الرسمي بحوالي متوسط نسبة الفجوة المبينة لشهر نيسان/أبريل 2025.
وفي المجال التنموي، تتناول ثلاث أوراق، فيما بينها، مسألة السمة الريعية للاقتصاد العراقي، من ناحية، والدوافع والتوجهات التنموية للتركيبة المؤسسية، من ناحية أخرى، خلال المائة سنة الأخيرة. إذ تتناول ورقتين، من الأوراق الثلاث، أثر اختلاف الدوافع والتوجهات التنموية، بالرغم من استمرار السمة الريعية، في اختلاف الجهود والإنفاق التنموي. ويتبين من هاتين الورقتين أنه بينما قاد ارتفاع الدوافع والتوجهات التنموية للقيادة السياسية/التركيبة المؤسسية، عموماً، خلال فترتي مجلس الإعمار 1951-1958 ومجلس التخطيط 1958-1980 إلى تصاعد الجهود والإنفاق التنموي، أدى تواضعها، سواء أثناء فترة الحروب والعقوبات الدولية حتى سنة 2002 أو بعد تغيير 2003 حتى سنة 2022، إلى تواضع الجهود والإنفاق التنموي. فبخلاف ما كان متبعاً في فترتي مجلس الإعمار ومجلس التخطيط خلال السنوات 1951-1980، حيث كان أعداد وتنفيذ ومتابعة المناهج والخطط التنموية يتم “دوريا” من قبل بنى مؤسسية وإدارية تحت أشراف وأسناد أعلى سلطة سياسية/اقتصادية في البلاد تم التخلي، فعلياً، عن اتباع مناهج وخطط تنموية خلال فترة الحروب/العقوبات الدولية حتى 2002. كما تُرك إعداد الخطط والمناهج التنموية، بعد تغيير 2003، لعملية روتينية تقوم بها وزارة التخطيط، بحيث اصبحت هذه الخطط والمناهج محدودة الفائدة والتطبيق، عموماً.
وبالرغم من عدم تحقيق أسس لنمو مستدام خلال فترتي مجلس الأعمار ومجلس التخطيط، غير أن مساهمة نمو نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفضت، خلالهما، لمصلحة مساهمة الأنشطة غير-النفطية. فلقد بلغت مساهمة نمو ناتج استخراج النفط/الغاز حوالي 32%، في متوسط نسبة النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة 1951-1958، وانخفضت إلى حوالي 29% خلال الفترة 1958-1980. لابل أنها انخفضت في أواخر الفترة الثانية إلى حوالي 20% (1975-1980). في المقابل، فأن الاعتماد المتزايد على النفط الخام، من ناحية، وتواضع السياسات والدوافع/التوجهات التنموية التي قادت لانخفاض الاستثمار، ومن ثم انخفاض خلق الطاقات الإنتاجية في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير-النفطية، من ناحية أخرى، قادت إلى ارتفاع مساهمة نمو ناتج استخراج النفط والغاز، في متوسط نسبة النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي، بشكل ملموس إلى 67% خلال السنوات 2003-2022، أي أكثر من ثلاث مرات مساهمته خلال السنوات 1975-1980.
وبالإضافة للمتغير/العامل الأساس المتمثل بالدوافع والتوجهات التنموية للقيادة السياسية/التركيبة المؤسسية في التأثير في مستوى النمو وتفاوته بين الفترات المختلفة، يُشار، بشكل عام، إلى متغيرات/عوامل أخرى ترد ضمن منهجية تحليل النمو، من خلال تفاعل علاقات القيادة السياسية/التركيبة المؤسسية والتسويات والمصالح/الصفقات المتبادلة بينها وكذلك مع النخب الاقتصادية/الاجتماعية في مكونات العراق ومناطقه، التي تؤمِّن استمرارها، وانعكاس ذلك في تسريع أو أبطاء النمو الاقتصادي.
وفي مقارنة الإداء الاقتصادي في العراق خلال السنوات 2003-2022 مع الأداء الاقتصادي العالمي (لمجموعة مختارة من الدول)، يتم تناول علاقة النمو الاقتصادي (النمو في الناتج المحلي الإجمالي)، من ناحية، والإطار المؤسسي، كما تقيسه مؤشرات الحوكمة التي يُعِدُها البنك الدولي، من ناحية أخرى. ويلاحظ من هذه المقارنة أنه بالرغم من تحقيق العراق لمتوسط نسبة نمو مُناسبة في الناتج المحلي الإجمالي مقدارها 5.1% سنويا، وهي تساوي حوالي ضِعف نمو السكان، خلال العقدين المنصرمين، في ظل حالة متواضعة من الحوكمة/البنى المؤسسية، فأن ذلك لا يعني عدم أهمية هذه البنى. وإنما ينصرف إلى حقيقة أن هذا النمو تحقق، في “موروث” مؤسسي ريعي، من خلال الزيادة في كمية إنتاج النفط الخام، من ناحية، وتحسن أسعار وعوائد تصديره، وما قاد أليه من ارتفاع النفقات في الميزانية الاتحادية، وانعكاسها على زيادة نواتج الأنشطة غير المتاجر بها، بأكبر من الأنشطة السلعية غير-النفطية، من ناحية أخرى. وهو بالنتيجة نمو غير مستدام.
وتُبَرِّز الورقة الثالثة في المجال التنموي، المتعلقة بخطة التنمية الوطنية 2024-2028، تواضع التأطير التنموي في العراق، حيث يتبين منها انخفاض دقة وشمول هذه الخطة وقصر مداها الزمني. فلقد جاءت لتكرر استمرار الهيكل الإنتاجي الأحادي في العراق، فعلياً، في سنة الهدف 2028 كما في سنة الأساس 2022 وافتقدت لمسار بعيد المدى على طريق التنويع الاقتصادي وغاب فيها قائمة للمشاريع بحيث نتج عن ذلك اهداف لا تتماشى مع المسار المبين فيها.
أما الورقة المتعلقة بالموازنة الاتحادية والموازنات الأخرى، بما فيها ميزان المدفوعات (التغير في الاحتياطيات الدولية) والدَين العام (الداخلي والخارجي)، فهي تبين بشكل مترابط العلاقة الأساسية بين التوازنات الداخلية والخارجية والتي قادت إلى زيادة الاحتياطيات الدولية خلال السنوات 2004-2022. ولكن يتبين من الورقة أنه بالرغم من رفد هذه الاحتياطيات أساسا بالفائض المتجمع للموازنة الاتحادية غير ان الدَين العام الداخلي نما بشكل سريع لا يمكن تبريره في الوقت الذي تحقق الفائض في الموازنة الاتحادية، من ناحية، وما تقود أليه زيادة الدَين من تزايد عبء خدمته (الفائدة والأصل)، من ناحية أخرى. وبينما بدأت سنة 2004 بعد تغيير 2003 بدَين عام خارجي مهيمن فأنه تناقص خلال العقدين المنصرمين (وهو لا زال يشمل “الدَين الخليجي”) في الوقت الذي أرتفع فيه الدَين العام الداخلي حتى اقتربا من التساوي في 2023 وتخطى الدَين الداخلي للخارجي بعد ذلك.
وفيما يخص ورقة التفاوت الاقتصادي في العراق فهي ورقة موسعة اعتمدت على حسابات تفصيلية مباشرة وغير مباشرة. وبالرغم من تعدد وتشعب أسباب التفاوت الاقتصادي، فأن الورقة تُرَكِّز على أثر العرض من والطلب على العمل، من ناحية، ودور الاسترباح rent-seeking، لا سيما من الريع النفطي، والفساد، من ناحية أخرى، في تفاوت الدخول والثروات في العراق. وفي كل من هذين البعدين يلعب الاستخدام في الجهاز الحكومي والقطاع العام، من ناحية، والإدارة العامة وسياساتها وممارساتها والمؤسسات التي تعمل من ضمنها، من ناحية أخرى، دور جوهري. ويتبين في الورقة أن المؤشرات حول التفاوت أصبحت قليلة وغير منظمة في العراق. فبعد نشاط مناسب خلال العقد الأول بعد تغيير 2003 في إعداد مسوح حول الدخول والإنفاق والفقر، والتي على أساسها تعد مؤشرات حول التفاوت في الدخول، تراجع هذا النشاط خلال العقد الأخير بحيث غاب، فعلياً، إعداد مؤشرات منظمة بعد سنة 2012. أما فيما يخص التفاوت في الثروات فلا تتوفر عنها مؤشرات منظمة مباشرة، أصلاً.
ونتيجة لغياب مؤشرات منظمة عن تفاوت الدخول بعد سنة 2012، تم في هذه الورقة حساب مؤشرات أخرى تكميلية/إضافية تغطي السنوات 2012-2023، لممثل مقارب proxy ولكنه جزءي، وهو تفاوت الرواتب/الدخول في التوظيف الحكومي الذي يُكَوِّن حوالي نصف الاستخدام في العراق. ويتضح من الورقة أن هناك بُعد مهم في التوظيف الحكومي، يتعلق “بنمط” مخصصات غلاء المعيشة في سلم الرواتب الحكومية، في وجود نوع من العلاقة العكسية، عموماً، بين مستوى الراتب الاسمي ونسبة غلاء المعيشة، مما يساهم في تخفيف تفاوت الدخول في هذا التوظيف. لذلك تشير مؤشرات تفاوت الدخول لكل السكان خلال السنوات 2006-2012 ولموظفي الدولة خلال السنوات 2012-2023 تفاوتاً “معتدلاً”، نسبياً، في العراق، بالمعايير الدولية، سواء استُخدِمت مؤشرات معامل جيني أو حاصل قسمة حصة العًشر الأعلى (الأغنى) على العٌشر الأدنى (الأفقر).
غير أن هذه المؤشرات مأخوذة من بيانات لا تغطي، بشكل كافٍ، مجالين مهمين في المجتمع والاقتصاد. الأول هو الاقتصاد غير المنظم/الظل، informal، الذي يمثل نسبة مهمة من الاقتصاد الكلي والذي يتسم بتهرب ضريبي واستخدام نقدي أكبر، عموماً. أما المجال الآخر فيتمثل في الفساد الحكومي واستغلال المنصب، ومن ثم الريع النفطي، والذي يقود إلى تخطي الدخول الفعلية لفئة ملموسة من موظفي الدولة للرواتب التي يستلموها، سواء في الدرجات الوظيفية العليا، أو في الدرجات المتوسطة والدنيا. وتمتد الاستفادة من أموال الفساد واستخدام النفوذ، من خلال المحسوبية والمصالح المشتركة، إلى القطاع الخاص. وبالنتيجة فإن التفاوت الفعلي في العراق هو، بأغلب الظن، يتخطى، بدرجة أو بأخرى، المؤشرات الواردة في هذه الورقة؛ سواء في الداخل أو مقارنة بدول العالم.
ومن المناسب الإشارة إلى أن معظم الأوراق في هذا المجلد تم تنقيحها revised، في ضوء الآراء والتعليقات والمداخلات والتصحيحات التي أثيرت حولها بعد نشرها.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
Merza-Iraq_&_the_World_Volume_IV
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
حزيران/يونيو 2025.

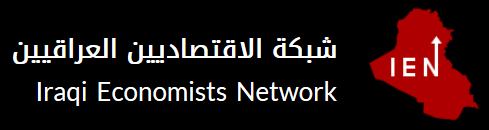


الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية