التأمين في العراقي إلى أين؟
منعم الخفاجي*
نبذة مختصرة عن نشوء وتطور التأمين في العراق
عُرف التأمين بشكله الحديث في العراق في نهايات القرن التاسع عشر أيام الحكم العثماني مقتصرًا على التأمين البحري/بضائع، ولهذا الغرض تم اصدار قانوني السيكورتا العثماني والتجارة البحرية العثماني الخاصين بتنظيم هذا النوع من التأمين .
بعد الحرب العالمية الأولى مرَّ التأمين في العراق بمرحلة جديدة حيث دخلت العراق فروع ووكالات لشركات تأمين أجنبية مارست بالإضافة إلى التأمين البحري/بضائع أنواع أخرى كالتأمين من الحريق، السرقة، والسيارات …الخ بمستندات ونماذج إنكليزية وبإشراف هيئات تأمين بريطانية. استمر هذا الحال حتى بعد تأسيس أول شركة تأمين عراقية سنة 1946 برأس مال أجنبي 60% وعراقي 40%.
بدء التطور الحقيقي
بعد سنة 1950 ومع تأسيس شركة التأمين الوطنية، أول شركة تأمين برأس مال حكومي عراقي، بدأت حقبة جديدة من التطور الحقيقي لقطاع التأمين في العراق. وبسبب نجاح هذه الشركة بادر القطاع الخاص العراقي بمزاولة العمل التأميني حيث تم في سنة 1958 تأسيس أول شركة تأمين أهلية هي شركة بغداد للتأمين (التحقتُ بهذه الشركة في آب/1963) ثم توالى تأسيس شركات تأمين أهلية حتى بلغ عددها عشية صدور قرارات التأميم في تموز/1964 ست شركات عاملة في السوق إضافة إلى شركة التأمين الوطنية وشركة إعادة التأمين العراقية وخمسة عشر فرعًا ووكالة تأمين أجنبية، جميعها تزاول عملها بشكل مهني متطور وفقًا لمبادئ وشروط ومستندات تأمين مصدرها شركات التأمين الغربية المتطورة وفي المقدمة منها الشركات العاملة في سوق التأمين البريطانية وبإشراف مباشر من قبل هيئات بريطانية متخصصة من بينها هيئة مكاتب الحريق (Fire offices’ Committee).
بعد قرارات التأميم وما لحقها من دمج شركات التأمين المؤممة وتصفية وكالات وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في العراق، أقتصر سوق التأمين العراقي على ثلاث شركات فقط هي شركة التأمين الوطنية تخصصت بأعمال التأمينات العامة (عدا التأمين على الحياة)، والشركة العراقية للتأمين على الحياة تزاول التأمين على الحياة حصرًا، وشركة إعادة التأمين العراقية تمارس أعمال إعادة التأمين.
وفي حقبة ما بعد التأميم، وبفضل الإدارة الحكيمة لهذه الشركات بإشراف المؤسسة العامة للتأمين، استمر تطور قطاع التأمين في العراق نحو الأفضل وبوتيرة متسارعة حتى أصبح في سبعينات القرن الماضي من أهم قطاعات التأمين في المنطقة فنيًا حيث أصبح مركزًا لتدريب وتأهيل كوادر التأمين العراقية، التي بفضلها تقدّمَ العمل التأميني، وكانت العديد من الكوادر العربية تقصد العراق لغرض التدريب. ليس هذا وحسب بل بادر قطاع التأمين العراقي إلى تأسيس شركات تأمين في عدد من الدول العربية ورفدها بالكوادر العراقية للمساندة وإدارة العديد من شركات التأمين العربية، وكان رائدًا في هذا المجال.
ومن حيث حجم الأعمال كان قطاع التأمين العراقي أيضًا في مقدمة القطاعات في المنطقة حيث بلغت أقساط التأمين المكتتبة في التأمينات العامة (عدا أقساط التأمين على الحياة) خلال سنة 1981 600000000$ (ستمائة مليون دولار)، في حين كانت أقساط التأمين في الدول الأخرى في المنطقة أقل كثيرًا من هذا الرقم.
كل هذا التطور والمكانة المرموقة التي تمتع بها قطاع التأمين في هذه المرحلة، جاء نتيجة التدريب المستمر للكوادر التنفيذية التي كانت تشرف عليها الإدارات الحكيمة للقطاع، عن طريق تنظيم الدورات التدريبية الممنهجة داخل العراق واستقدام خبراء أجانب حقيقيين من دول أوربية متعددة لعقد الندوات والدورات التدريبية وكذلك ابتعاث عدد غير قليل من الموظفين خارج العراق للدراسة والتدريب، مما أدى إلى تنمية كوادر تنفيذية متخصصة لقيادة القطاع وإلى تطور القطاع بمنهجية سليمة.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

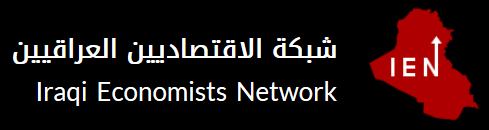
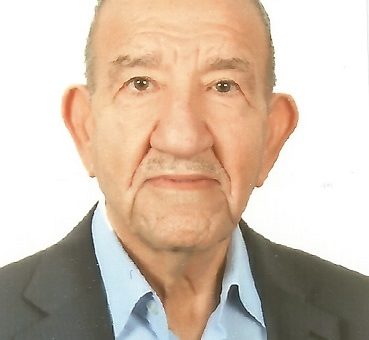
حين نتأمل سوق التأمين في العراق منذ نشأته حتى يومنا هذا، فإننا نصطدم بحقيقة مؤسفة: غياب المراقب التأميني بالمعنى المؤسسي والمهني، وهو غياب ممتد عبر عقود. في زمننا الحاضر، حيث ترتكز مفاهيم الرقابة على محورين أساسيين هما حماية المستهلك وضمان متانة الشركات المالية، يبدو أن السوق العراقي ما يزال متروكًا لانطباعات عامة أكثر مما هو قائم على تقييم علمي أو مهني. فالتقييم اليوم، في ظل هذا الفراغ الرقابي، لا بد أن يظل انطباعيًا، يستند إلى مشاهدات وتجارب متفرقة لا إلى بيانات دقيقة أو تقارير رسمية منتظمة.
وإذا عدنا إلى الثمانينات، فإن الدولة كانت تمثل آنذاك طرفي المعادلة معًا: هي الممثل الحصري للطلب عبر مؤسساتها، وهي الممثل الحصري للعرض عبر شركاتها المملوكة لها. بمعنى أن السوق لم يكن سوقًا بالمعنى الحقيقي، بل كان جهازًا إداريًا تديره الدولة ضمن خطتها الاقتصادية المركزية. كانت غالبية الاقساط ( حسب ماذكرت من قبل الزملاء الأعزاء مصباح كمال ومنعم الخفاجي) تأتي من مؤسسات الدولة، وكانت المطالبات تُدار ضمن نفس المنظومة، فلم يكن هناك مجال للمنافسة أو لظهور ديناميكيات العرض والطلب.
أما اليوم، فقد انتقل العراق إلى مرحلة أكثر إرباكًا: لم تعد الدولة اللاعب المركزي في المعادلة، لكنها أيضًا لم تؤسس جهازًا رقابيًا قادرًا على ضبط التوازن. النتيجة أننا أمام سوق لا يمكن وصفه بوجود “عرض” حقيقي ولا “طلب” حقيقي. فالعرض لا يتجسد في منتجات مبتكرة والطلب لا يقوم على وعي مجتمعي وثقة بالمؤسسات. السوق يعيش حالة فراغ مزدوج، يتأرجح بين تراث احتكاري موروث، وواقع مفتوح بلا قواعد واضحة.
وللمقارنة، نجد أن دولًا قريبة مثل الأردن أسست منذ عقود إدارة عامة للتأمين ثم نقلتها تحت مظلة البنك المركزي، ما أتاح مراقبة ملاءة الشركات، إصدار تقارير دورية، وإلزام الشركات بتبني معايير ملاءة شبيهة بالمعايير الدولية. أما في مصر، فقد كان وجود الهيئة العامة للرقابة المالية عاملًا أساسيًا في تنظيم السوق، فرض المعايير المحاسبية، وضبط المنتجات المطروحة لحماية المستهلك. هذه الرقابة لم تمنع التحديات، لكنها صنعت سوقًا يمكن تقييمه بالأرقام والمؤشرات لا بالانطباعات.
العراق، في المقابل، ظل خارج هذه المنظومة الرقابية. فبينما تطورت أسواق الجوار نحو مفاهيم Solvency (الملاءة) وConsumer Protection (حماية المستهلك)، بقي السوق العراقي محكومًا بالصدفة والاجتهاد الفردي، بلا منظومة تقارير دورية أو مؤشرات ملاءة مالية، وبلا جهاز يضبط العلاقة بين المؤمن والمستأمن.
ولعل الطريق إلى الإصلاح يبدأ من توصيات عملية يمكن أن تشكّل نقطة انطلاق:
1. تأسيس هيئة رقابية مستقلة: هيئة متخصصة بالتأمين، أو على الأقل إدارة قوية ضمن البنك المركزي، تكون لها صلاحيات واضحة في الترخيص والرقابة والإشراف.
2. إصدار تقارير سنوية إلزامية: تلزم جميع شركات التأمين بتقديم بيانات مالية موحدة تُنشر للعلن، بما يرفع مستوى الشفافية ويتيح تقييمًا حقيقيًا للسوق.
3. اعتماد إطار مرحلي للملاءة: يبدأ بمعايير محلية مبسطة ثم يتدرج نحو تبني مقاييس إقليمية ودولية شبيهة بـSolvency II، حتى لو بشكل مبسط.
4. حماية المستهلك التأميني: عبر آليات شكاوى واضحة، حملات توعية، ونظام قضائي/تنظيمي يضمن حقوق حملة الوثائق.
5. تشجيع المنافسة المنظمة: عبر فتح المجال أمام منتجات مبتكرة، ودعم شركات التأمين على بناء قدراتها الفنية بدل الاكتفاء بالعمل التقليدي.
من دون هذه الخطوات، سيبقى السوق العراقي محكومًا بالتجارب الفردية، عاجزًا عن التحول إلى سوق حديث يساهم في حماية الأفراد والاقتصاد الوطني. أما مع هذه الخطوات، فيمكن للعراق أن يلتحق تدريجيًا بركب الدول التي جعلت من الرقابة التأمينية مدخلًا لبناء الثقة والاستقرار المالي.
عودة إلى محنة قطاع التأمين العراقي
بيانات غير مكتملة
منذ سنوات أنشغل العديد من ممارسي التأمين في العراق بالعديد من قضايا سوق التأمين العراقي، ودراسات البعض منهم منشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، وبعضها الآخر مركونة في مكتبات الجامعات كأطاريح ماجستير ودكتوراه أذكر من بينها أطروحة دكتوراه للأستاذ حيدر أحمد أبو القاسم (2024) بعنوان (انعكاس المخاطر الأخلاقية والاختيار المعاكس على بناء النماذج الاكتوارية في قطاع التأمين العراق-التحليل السلوكي منهجًا)، اعتمد فيها الباحث على كم كبير من البيانات. تصدر جمعية التأمين العراقية سنويّا (إحصائية نشاط شركات التأمين العاملة للعراق)، وهي إحصائية بحاجة إلى تطوير. كما تتوفر لدى الديوان البيانات الخاصة بنشاط شركات التأمين. مع هذا لا أختلف مع الزميل سمير عبد الأحد بأن البيانات المتوفرة ليست مكتملة، لكن المتوافر من البيانات يمكن أن يخضع للتحليل باستخدام المؤشرات التي ذكرها ومن بينها: التغلغل والكثافة التأمينية، العائد على حقوق الملكية (ROE)، والملاءة المالية والحوكمة.
مقارنة أقساط تأمين عقود الدولة الكبرى عام 1981 مع الواقع السائد بعد 2003
القول إن “ارتفاع الأقساط عام 1981 [كان] مرتبطاً باحتكار الدولة لعقود كبرى بأسعار إلزامية لا تشبه مثيلاتها في الأسواق الأخرى” يحتاج لقليل من المراجعة. إن العقود الكبرى للدولة (المشاريع الهندسية) لم تخضع لأسعار تأمين إلزامية فلم يكن هناك تسعير إلزامي بالمعنى الدقيق. كان هناك دليل للتسعير قامت شركة ميونيخ لإعادة التأمين بوضعه. وفي كل الأحوال كانت العقود الكبرى تسعر في أسواق التأمين العالمية إذ أن أقيام هذه العقود كانت تفوق قدرة الاستيعابية لاتفاقية التأمين الهندسي لشركة التأمين الوطنية (وقد عرضنا لهذا الموضوع في أوراق منشورة).
توطين التأمين
لم يتغير احتكار الدولة لعقود المشاريع الكبرى بعد الاحتلال الأمريكي سنة 2003 وصياغته لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، ومع هذا فإن هذه العقود لم تنتهي كأعمال تأمين هندسي تستطيع شركات التأمين العامة والخاصة على حد سواء الاكتتاب بها. لماذا؟ هل العلة تكمن في شركات التأمين أم الدولة ومؤسساتها؟ كانت لنا مساهمة متواضعة بعنوان “قطاع التأمين العراقي: قضايا ومقترحات للتطوير” نشرت في موقع الشبكة (قطاع-التأمين-العراقي-قضايا-ومقترحات-مصباح-كمال.pdf). ضمت الورقة العديد من المقترحات ومن بينها الآتي تحت باب توطين التأمين:
من خلال العمل على ما يلي:
1- اشتراط إجراء التأمين على الأصول المادية والمسؤوليات القانونية الناشئة عنها حصراً لدى شركات تأمين مسجلة لدى الدوائر المختصة في العراق ومجازة من قبل ديوان التأمين العراقي.
2- تحريم إجراء التأمين خارج العراق، أي خارج القواعد الرقابية التي يديرها ديوان التأمين العراقي.
3- اشتراط ان تكون استيرادات العراق بشروط الكلفة والشحن (سي أند اف – C & F) وليس بشروط الكلفة والتأمين والشحن (سي آي اف -CIF ) عند فتح الاعتمادات المستندية مع المصارف.
4- فرض غرامات مالية وغير مالية – عند مخالفة شرط التأمين لدى شركات مجازة من قبل ديوان التأمين العراقي – على أي طرف عراقي، عام أو خاص، أو أجنبي يعمل في العراق (أي المؤمن له)، وإلزام الطرف المخالف بشراء التأمين من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.
5- تعزيز الالتزام بهذه الشروط أعلاه وضمان تطبيقها من خلال التنسيق مع الإدارات الجمركية لتقييد إخراج البضائع المستوردة على أنواعها من الموانئ العراقية البرية أو البحرية أو الجوية وذلك باشتراط إبراز وثيقة تأمين أصولية صادرة من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.
6- عدم تقديم السلف أو الدفع على الحساب أو إجراء التسوية النهائية لعقود المقاولات دون إبراز وثيقة تأمين أصولية صادرة من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.
7- النص في عقود الدولة على إجراء التأمين مع شركات تأمين مسجلة ومجازة في العراق.
8- تأمين صناعة النفط والغاز، في جميع مراحلها، لدى شركات التأمين المسجلة في العراق العامة أو الخاصة منها.
مصادر الطلب على التأمين
نزعم أن المصدر الأساس لأقساط التأمين قبل 2003 كان محصورًا بشركات ودوائر الدولة، ولذلك كانت إدارات التأمين تصف محفظة التأمين بأنها غير متوازنة لعدم وجود عدد كبير من وثائق التأمين الشخصي ووثائق تأمين المحلات والمنشآت الخاصة مقابل عدد قليل من الأخطار الكبيرة ذات الأقساط التأمينية العالية. تركيبة المحفظة لم تتغير كثيرًا بعد 2003 وذلك لأن توزيع الدخل القومي غير عادل فالشرائح الغنية (تجار السياسة المحاصصية وسارقي الثروات) ليسوا بحاجة لحماية التأمين. أما الشرائح الأخرى فإن معظم أفرادها لا يكفي دخلهم النقدي للإنفاق على شراء وثيقة تأمين شخصية. لنقرأ بهذا الشأن الخبر التالي:
“كشفت وزارة التخطيط عن تراجع نسبة إنفاق الأسر العراقية على الغذاء إلى النصف، مبينة أن نفقات الغذاء كانت تُشكل أكثر من 60 في المائة من مجمل الدخل خلال السنوات الماضية، وحالياً انخفضت إلى نحو 31-32 في المائة – وفقا للوزارة. وفيما يذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، أن هذا التحوّل يعكس إعادة توزيع الموارد نحو السكن والصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وينسجم مع أولويات المعيشة وتوزيع الإنفاق على مختلف الحاجات الحياتية، يرى اقتصاديون أن هذا التحوّل في الانفاق لا يعني بالضرورة تحسنا في القدرة الشرائية أو حصول انخفاض في أسعار الغذاء، لافتين إلى ان الأسر تضطر إلى تقليل نفقات الغذاء لتغطية تكاليف السكن والخدمات الضرورية المتزايدة.” (كما جاء في صحيفة طريق الشغب بتاريخ 133 أيلول 2025: بسبب ارتفاع تكاليف السكن والخدمات.. العراقيون يخفضون نفقات الغذاء إلى النصف)
تعزيز توزيع المنتج التأميني
يعاني قطاع التأمين العراقي قصورًا في هذا المجال، ويقع على عاتق شركات التأمين مهمة العمل على تنويع منافذ التوزيع. وفي بالنا هنا عدم الاكتفاء بالطريقة التقليدية القائمة على التوزيع المباشر من خلال فروع الشركة أو ما هو مستحدث عبر المنصات الرقمية، والشروع بالعمل الجاد على تعزيز المنافذ الأخرى كالمنتجين والوكلاء الحصريين، والوسطاء المستقلين، والبنوك وشركات التمويل (Bancassurance).
في بلد يعلّي من مكانة الدين في الحياة العامة، لأغراض قابلة للمساءلة، فإن التأمين التكافلي (المتجذر في التشريع الإسلامي) لم يسجّل له حضورًا متميزًا في إشاعة التأمين وبالتالي تعظيم إجمالي حجم أقساط التأمين المكتتبة. لماذا؟
إن محنة قطاع التأمين العراقي متعددة الجوانب وهي انعكاس لأزمة الدولة العراقية القائمة على المحاصصة وسرقة المال العام وغياب المساءلة.
15 أيلول 2025
ان ما قصدته بالانطباعية هو قلة الاعتماد على المؤشرات والأدلة المتعددة عند التحليل وذلك لعدم وجود بيانات مكتملة عن سوق التامين العراقي، ولذلك أقول رغم مرور أكثر من عقدين على تحرير السوق العراقي من احتكار شركتي التأمين الوطنية والعراقية، ورغم تأسيس أكثر من ثلاثين شركة جديدة بعد عام 2003، فإن حجم الأقساط المكتتبة في العراق لا يزال عند مستويات متدنية للغاية لا تتجاوز في أحسن التقديرات نحو 252 مليون دولار في عام 2024، أي ما يعادل 0.09% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 280 مليار دولار، وبكثافة تأمينية تقارب 5 دولارات للفرد سنوياً فقط. وللمقارنة، حقق سوق الإمارات في 2024 أقساطاً تزيد على 17 مليار دولار بنسبة اختراق تقترب من 3.6% وبكثافة تأمينية تفوق 1,600 دولار للفرد، بينما بلغ السوق الأردني نحو مليار دولار بنسبة اختراق بحدود 2% وكثافة تقارب 60 دولاراً للفرد. هذا التفاوت لا يفسّره مجرد اختلاف مستويات الدخل القومي أو عدد السكان، بل يرتبط أساساً بعوامل مؤسسية وهيكلية؛ ففي العراق كان ارتفاع الأقساط عام 1981 مرتبطاً باحتكار الدولة لعقود كبرى بأسعار إلزامية لا تشبه مثيلاتها في الأسواق الأخرى، أما اليوم فإن ضعف أدوات العرض ، واقصد هنا ضعف الأداء (شركات التأمين والجهات الرقابية) وغياب قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ،هدر المال العام ،وتوقع تسريب اقساط التأمين إلى شركات اجنبية، ضعف هيكلية مصادر التوزيع ،كلها عوامل حدّت من قدرة السوق المحلي على تحفيز العملية التأمينية ولارتقاء بحجم اقساط السوق للتماشي مع أسواق دول المحيط ومؤشرات اداءها. وبذلك، يظل السوق العراقي ،يفتقر إلى التطور واقتصاد يعتمد على مورد واحد (النفط) دون أن ينجح في تحويل عائداته إلى محركات مستدامة للنمو التأميني، خلافاً لما نشهده في أسواق الجوار التي تمكنت من بناء بيئات تنظيمية ومؤسسية أكثر كفاءة وشفافية.
مصباح كمال
تدني الطلب الفعّال على التأمين في العراق
في ظل احتكار النشاط التأميني من قبل شركتين (شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية) حققت شركة التأمين الوطنية لوحدها سنة 1981 أقساطًا مكتتبة (Underwriting Premium) في التأمينات العامة عدا تأمينات الحياة بلغت /- 000 000 600 دولار (ستمائة مليون دولار)، كما جاء في تعليق الزميل منعم الخفاجي. في ظل ما يسمى بالتحرر الاقتصادي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003 تأسست أكثر من 30 شركة تأمين لم تحقق فيما بينها ما يوازي ما تحقق سنة 1981 من قبل شركة تأمين واحدة محتكرة للتأمينات العامة. ليس هناك ما يدعو إلى الاحتفاء بما تحقق في الماضي إذ أن المكون الأساس لمحفظة التأمين (وخاصة في التأمينات العامة) كان مصدره عقود الدولة وشركات ودوائر الدولة. لكن السؤال الذي أثرناه أصلاً يتعلق بالبحث عن أسباب ركود حجم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة رغم ازدياد عدد شركات التأمين وإلغاء احتكار التأمين من قبل شركات الدولة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، وازدياد عدد السكان، وازدياد عدد الأغنياء، وازدياد دخول فئات معينة، وازدياد حجم الإيرادات النفطية وما ارتبط بها من ازدياد عدد المنشآت النفطية وازدياد عدد المشاريع الانشائية وعدد السيارات، وغيرها من الأصول المادية التي يمكن أن تكون مصادر للطلب على التأمين.
لا اختلف مع الزميل سمير عبد الأحد بأن الأدوات/المؤشرات التحليلية الحديثة (العمق التأميني والكثافة التأمينية، العائد على حقوق الملكية (ROE)، الملاءة المالية، الحوكمة، ومؤشرات الكفاءة التشغيلية) التي تعتمدها الشركات الاستشارية وشركات التصنيف الائتماني وغيرها في تقييم أداء شركات التأمين وبالتالي أداء سوق التأمين، مطلوبة. القول إن (غياب هذه المؤشرات أو ضعفها يفسر لماذا عجز السوق عن تجاوز حالة الركود، حتى في حال تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية العامة) لا يجيب على سؤال ضعف الطلب الفعّال على التأمين من قبل الأفراد والشركات. وقد كان لنا، كما لزملاء آخرين، مساهمات منشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، للاقتراب من أسباب هذا الضعف.
ترى كيف تكون المقارنة انطباعية في العرض السريع الذي قدمناه، منعم الخفاجي وأنا، عن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عندما تكون المقارنة قائمة على أرقام إحصائية، وعندما نلجأ إلى المقارنة بين سوق قائم على الاحتكار (ثلاث شركات) وآخر قائم على المنافسة (ما يقرب من أربعين شركة)؟ اختلاف البيئة الاقتصادية بين عهدين لا يفسر تدني الطلب على التأمين. لعل بعض المؤشرات التي أوردها الزميل سمير عبد الأحد، من خلال الدراسة والتطبيق العملي، سيساهم في الاقتراب من سؤال الطلب على التأمين.
13 أيلول 2025
إن المؤشرات مثل العمق التأميني والكثافة التأمينية، العائد على حقوق الملكية (ROE)، الملاءة المالية، الحوكمة، ومؤشرات الكفاءة التشغيلية، ليست مجرد أدوات ثانوية، بل هي من صميم تشخيص واقع أي سوق تأميني بشكل علمي. فهي تمثل القاعدة التي يمكن عبرها قياس قدرة الشركات والسوق على النمو والاستدامة.
،
القول إن هذه المؤشرات لا تفسر تدني حجم الأقساط بعد عام 2003 فيه خلط بين وظيفة الأدوات وأسباب الظاهرة. فالعائد على حقوق الملكية مثلاً لا يُفترض أن يفسر حجم الأقساط الكلي، بل يقيس مدى كفاءة الشركات في استثمار رأس المال. وكذلك معايير الحوكمة والملاءة ليست لشرح الركود التاريخي، بل لتحديد قدرة السوق على مواجهة المخاطر وتوليد الثقة. أي أن غياب هذه المؤشرات أو ضعفها يفسر لماذا عجز السوق عن تجاوز حالة الركود، حتى في حال تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية العامة.
أما الإشارة إلى أن حجم أقساط السوق قبل الاحتلال كان أعلى نسبيًا، فهذا لا يعد مؤشراً علمياً بالمعنى التحليلي. فالسوق حينها كان محتكرًا من قبل شركتين مملوكتين للدولة، ولم يكن يعكس منافسة حقيقية أو تنوعًا في المنتجات أو نمواً قائماً على أسس سوقية. المقارنة بين مرحلة احتكار الدولة وما بعد التحرير الاقتصادي دون استخدام مؤشرات كمية ونوعية مضبوطة لا تعطي لنا الصورة الحقيقية، لأنها تغفل عن اختلاف البنية المؤسسية للسوق قبل وبعد عام 2003.
وبالتالي، فإن أي تقييم للسوق العراقي يتجاوز هذه المؤشرات ويكتفي بالمقارنات الانطباعية لا يمكن أن يُعد تحليلاً علمياً. فالتشخيص العلمي يقتضي الجمع بين:
1. مؤشرات جانب العرض (كفاءة الشركات، الملاءة، الحوكمة، ROE).
2. مؤشرات جانب الطلب (العمق التأميني، الكثافة، العوامل الاقتصادية والاجتماعية).
فقط من خلال هذا الدمج يمكن تكوين صورة دقيقة عن أسباب تدني الأقساط وفهم لماذا بقي السوق العراقي متأخراً، لا بسبب ضعف حجم الأقساط وحده، بل نتيجة تداخل عوامل داخلية وخارجية، مؤسسية واقتصادية.
اشكر المداخلة القيمة للزميل مصباح كمال وتعليقه على ان مؤشرات الأداء مثل العمق التأميني، والكثافة، والعائد على حقوق الملكية (ROE)، ومعايير الحوكمة والملاءة، لا تكفي وحدها لتفسير تدني حجم أقساط التأمين في العراق. هذا صحيح إلى حد ما، لكن من المهم توضيح أن هذه المؤشرات لم تُصمَّم لتفسير الظواهر التاريخية الكبرى أو السياقات السياسية والأمنية، وإنما لتقييم قدرة السوق والشركات من الداخل على النمو والاستدامة.
فعلى سبيل المثال:
• العمق والكثافة التأمينية تقدمان صورة كمية عن مستوى الطلب على التأمين مقارنة بالناتج المحلي والدخل الفردي.
• العائد على حقوق الملكية (ROE) يقيس كفاءة الشركات في استثمار رأس المال، وهو أداة لفهم جودة الأداء التشغيلي لا حجم الأقساط الكلي.
• الحوكمة والملاءة تعكسان قدرة الشركات على إدارة المخاطر والوفاء بالتزاماتها.
وعليه، فإن هذه الأدوات تظل ضرورية لأنها تكشف عن جوانب العرض في السوق (قدرة الشركات على المنافسة والنمو)، حتى وإن لم تقدم تفسيرًا مباشرًا للعوامل الخارجية التي تحد من الطلب على التأمين مثل محدودية الدخل أو الوعي التأميني أو الظروف السياسية.
وبالتالي فإن أي تقييم للسوق يخلو من هذه المؤشرات لا يعبر عن المستوى الدقيق للتحليل، لأنه يتجاهل الركيزة الأساسية لفهم أداء السوق داخليًا. ومن ثم لا يمكن الحكم على حجم الأقساط أو تفسير ركودها من دون دمج هذه الأدوات مع تحليل أوسع يشمل الاقتصاد الكلي والعوامل الاجتماعية والسياسية.
مصباح كمال
حول محنة قطاع التأمين العراقي
لقد جاءت مساهمة الزميل سمير عبد الأحد مكملة لدراسة الزميل منعم الخفاجي، وجاءت أيضًا كتمهيد للتوسع في الرصد والتحليل. ونأمل منه أن يرفدنا بما لديه في دراسات قادمة. فيما يلي أقدم بعض الملاحظات السريعة العامة.
السؤال الصعب الذي يستحق البحث هو تدني حجم أقساط التأمين المكتتبة (أقل من 500 مليون دولار) مقارنة بما كان عليه قبل الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003. كانت محفظتي التأمين البحري والهندسي وقت ذاك، وخاصة في فترة الخطة الانفجارية، هما الأكبر بين محافظ التأمين الأخرى (ليست هناك إحصائيات متوفرة لكن التقديرات تشير إلى انهما كانتا لوحدهما بحجم أقساط التأمين المكتتبة سنة 2023 أو 2024. وقد كتبنا عن هذا الموضوع في مقالات سابقة منشورة في موقع الشبكة). كان ذلك في وقت كان عدد سكان العراق يقدر بحوالي 25 مليون نسمة، وهو الآن يزيد قليلاً عن 46 مليون نسمة حسب التعداد العام سنة 2024). كما أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي سنة 2002 كان أقل من 20 مليار (وهو متدني قياسًا بدول نفطية أخرى وسببه يعود إلى العقوبات الدولية الظالمة، وضعف والأحرى تدهور البنية التحتية، وانخفاض صادرات النفط، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 كان بحدود 279 مليار دولار.
مقارنة أرقام الماضي بأرقام اليوم لا يعني أن العمق التأميني (بشقيه: التغلغل التأميني Insurance Penetration: نسبة دخل أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويؤشر على أهمية قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني وتطور هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني ككل. الكثافة التأمينية Insurance Density: إنفاق الفرد على شراء الحماية التأمينية، ويؤشر على إجمالي أقساط التأمين المتحقق في البلد منسوباً إلى عدد السكان) كان عاليًا في العراق في الماضي وفي الوقت الحاضر سوى أن التغلغل التأميني في الماضي كان أكبر منه قي الوقت الحاضر وذلك لأن الطلب من قبل الدولة والشركات المحلية والأجنبية العاملة معها على حماية التأمين كان عاليًا، وهو ما يدل عليه حجم محفظتي التأمين البحري والتأمين الهندسي. كانت التشريعات قبل 2003 تلزم المؤمن لهم التأمين مع شركات تأمين عراقية كما أن قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية (1950) كان يلزم مؤسسات ودوائر الدولة التأمين حصرًا مع شركة التأمين الوطنية، وهو ليس قائمًا في الوقت الحاضر.
وأرى لذلك أن يجري تحليل مصادر الطلب على التأمين لتكوين صورة أفضل عن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة. إن بعض أدوات التحليل التي ذكرها الزميل سمير عبد الأحد (العمق التأميني (Insurance Penetration & Density)، مردودية رأس المال المستثمرROE، معايير الحوكمة المؤسسية، الملاءة المالية لشركات التأمين، إضافة إلى مؤشرات الكفاءة التشغيلية والإدارية – تمثل أدوات علمية لقياس الأداء، وتسمح بتكوين صورة كمية ونوعية دقيقة عن مدى قدرة السوق على النمو، وتعزز إمكانية الحكم على تنافسيته واستدامته) لها أهميتها لكنها لا تفسر تدني إجمالي حجم أقساط التأمين. فالعائد على حقوق الملكية (Return on Equity- ROE) المستخدم لقياس مدى كفاءة الشركة في استخدام أموال المساهمين لتحقيق الأرباح، لا تسعف في تفسير ركود قطاع التأمين العراقي منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، وكذا الأمر بالنسبة لمعايير الحوكمة المؤسسية، وهكذا.
ورغم ارتفاع الدخل القومي المرتبط أساسًا بإنتاج النفط الخام (90%) فإن نصيب الفرد ظل منخفضًا نسبيًا. يعني هذا إن الدخل القابل للإنفاق لدى الأفراد بالكاد يكفي لإشباع الحاجات المعيشية الأساسية وما يَفضلُ من هذا الدخل، لدى بعض الفئات، لا ينتهي كأقساط لشركات التأمين. أضف إلى ذلك العناصر الأخرى التي جاء الزميل منعم الخفاجي على ذكرها (وقمنا كلينا بتحليل جوانب مختلفة منها في العديد من المقالات: الثقافة التأمينية، تشريعات التأمين، عقود الدولة الخالية من شرط التأمين والفشل في توطين التأمين، هزال مشاريع الإصلاح كتلك التي وردت في الورقة البيضاء (راجع كتابي مصباح كمال، حول بعض قضايا قطاع التأمين العراقي: نظرات نقدية (2021) والورقة البيضاء وقطاع التأمين العراقي (2022) متوفر في موقع الشبكة، وغيرها) وهذه الكتابات تقربنا من فهم ركود قطاع التأمين (إجمالي أقساط التأمين لسنة 2024 أقل من أقساط التأمين سنة 1982).
تكمن مساهمة الزميل سمير الأحد القيمة في إلقاء الضوء على أدوات تحليلية مهمة لتحسين أداء شركات التأمين وبالتالي أداء سوق التأمين العراقي برمته. نتمنى عليه الاستمرار في نقد قطاع التأمين العراقي للمساهمة في تكوين وعي جمعي من شأنه الدفع باتجاه سياسات مناسبة لتطوير قطاع التأمين.
10 أيلول 2025
عد مراجعتي لما قدمه االاستاذ منعم الخفاجي في ورقته «التامين في العراق(إلى أين)»، وجدت أن ما طُرح كان بحاجة إلى انطلاق اُوسع يتناول الأسس والمعايير الجوهرية المعروفة عند تشخيص أوضاع الأسواق التأمينية. فالمؤشرات المعتمدة عالمياً – مثل العمق التأميني (Insurance Penetration & Density)، مردودية رأس المال المستثمر ROE، معايير الحوكمة المؤسسية، الملاءة المالية لشركات التأمين، إضافة إلى مؤشرات الكفاءة التشغيلية والإدارية – تمثل أدوات علمية لقياس الأداء، وتسمح بتكوين صورة كمية ونوعية دقيقة عن مدى قدرة السوق على النمو، وتعزز إمكانية الحكم على تنافسيته واستدامته.
نعم ان المعالجات التي تناولها الأستاذ منعم قد شخصت إلى حد بعيد، على موضوعات مهمة وأثر ما مر به العراق على تردي اوضاع التامين لكن الازمةً بعد كل هذه الفترة الطويلة بعد احتلال العراق هي في حقيقتها أعمق من مجرد ضعف تشريعي أو قصور تدريبي أو من آثار زمن المحتل ، بل تتصل بغياب إطار قياسي متكامل لقياس الأداء، وضعف الإفصاح والشفافية، وانعدام آليات فعّالة للمساءلة سواء على مستوى إدارات الشركات والإمعان في المحاصصة عند التعينات ( كما لخّصتها في ورقة الأستاذ مصباح كمال الأخيرة عن تعين مدير عام شركة التامين العراقية ) أو على عدم كفاءة مستوى الجهات الرقابية.
إن سوق التأمين العراقي اليوم يمر بمرحلة يمكن وصفها – دون مبالغة – بأنها أدنى مستويات التراجع والركود. فالمؤشرات لا تبعث على الاطمئنان: ثقة الجمهور بالمنتجات التأمينية شبه معدومة، رؤوس أموال الشركات تتآكل عاماً بعد عام، فيما يتزاحم عدد كبير من الشركات المحلية على أقساط لا تتجاوز في حجمها ما نراه في أسواق متواضعة توصف عادةً بـ”أسواق الموز”. وإلى جانب ذلك، تغيب استراتيجيات ابتكار منتجات جديدة تلبي الاحتياجات الفعلية للاقتصاد والمجتمع، كما نفتقد إلى بنية تحتية تقنية وتشريعية قادرة على مواكبة التطورات العالمية في الصناعة التأمينية.
صحيح ان ما نراه في سوق التامين العراقي ما هو إلا نتيجة لإفرازات الكوارث التى مر بها العراق ، إلا إن المطلوب اليوم ليس مقاربة حذرة أو عامة، بل تشخيص أكثر صراحة وجرأة، قائم على أسس علمية وموضوعية، يضع النقاط على الحروف ويكشف مكامن الخلل البنيوية والتنظيمية بلا مجاملة. نحتاج إلى خطاب إصلاحي يقرّ بأن السوق في وضع مأزوم، وأن الإنقاذ لا يأتي الا من خلال خارطة إصلاح متكاملة تعيد النظر في السياسات الرقابية، وتدفع باتجاه دمج وتوطيد الشركات الضعيفة، وتبني معايير صارمة للحوكمة والملاءة، وتشجع الاستثمار في التقنيات الحديثة ومنتجات التأمين المبتكرة. فقط عندها يمكن القول إننا بدأنا مساراً جاداً لإحياء سوق التأمين العراقي وانتشاله من واقعه الحالي.
ارجوا ان تكون مداخلتي وافية بالغرض
تعليق الزميلين الأستاذ سمير عبد الاحد والأستاذ مصباح كمال بالتأكيد أغنيا الموضوع بتجربتهما وعلو كعبهما في الثقافة التأمينية ولكن سبب عدم تطرقي الى المعايير المعتمدة عالمياً – مثل العمق التأميني والكثافة التأمينية وغيرها من المقاييس المتداولة في قطاعات التأمين المتطورة، بسبب أن هدفي من كتابة هذه الورقة هو توضيح ان القطاع يحتاج إلى النهوض به ليرتقي إلى الحالة التي يجب أن يكون عليها ليضطلع بدوره في التنمية واستقرار الحياة الاجتماعية. ولذلك استخدمت وسيلة أوضح في رأيي وهو مؤشر أقساط التأمين وقارنت بما كان عليه في سنة 1981 حيث بلغت أقساط التأمين المكتتبة (Underwriting Premium) في التأمينات العامة عدا تأمينات الحياة حسب احصائية شركة التأمين الوطنية /- 000 000 600 دولار (ستمائة مليون دولار) وقارنته مع ما آل اليه سنة 2014 و 2023 :حيث بلغت أقساط التأمين المكتتبة بضمنها أقساط التأمين على الحياة -/217 مليون دولار و -/313 مليون دولار على التوالي وهي كانت في ذيل دول المنطقة وتناولت بعض أهم أسباب هذا التراجع وكذلك تطرقت إلى الحلول.
عسى أن يتوجه العاملون في قطاع التأمين والمسؤولون عنه للعمل على الهوض بهذا القطاع المهم