سمير عبد الأحد
المقدمة:
تتناول هذه الورقة البحثية موضوع تأمين انقطاع الأعمال التبعي (Contingent Business Interruption – CBI)، وهو منتج تأميني حديث نسبيًا، لكنه أصبح محور اهتمام الجهات الرقابية وشركات التأمين وإعادة التأمين. وتنبع أهميته من بعده الاستراتيجي ودوره المباشر في حماية الاقتصادات الوطنية، فضلًا عن ما يثيره هذا الخطر من إشكاليات قانونية تتعلق بتحديد نطاق المسؤولية والتغطية، وما ينطوي عليه من تعقيدات اقتصادية ناجمة عن صعوبة قياس الخسائر وطبيعتها التراكمية ذات الأثر النظامي.ويُستخدم أحيانًا تعبير “تأمين تعطل سلاسل الإمداد” كتفسير عملي لهذا المفهوم، إذ إن الخسائر المغطاة تنشأ غالبًا عن توقف الموردين أو العملاء الرئيسيين ضمن الشبكات. وهذه الشبكات تمثل سلسلة مترابطة من المراحل تبدأ بإنتاج المواد الأولية وتصنيعها، مرورًا بعمليات النقل والتوزيع، وصولًا إلى المستهلك النهائي. ومن ثمّ، فإن أي اضطراب في عقدة حرجة ضمن الشبكة ،قادر على إحداث خسائر متزامنة وعابرة للقطاعات. هذا الطابع الشبكي يضاعف احتمالات انتشار الخطر وتراكمه، ويقيّد قدرة شركات التأمين على إجراء تقييم نهائي ودقيق لدرجة التعرض، أو تطوير نماذج اكتوارية سليمة، ومن ثم تحديد أسعار عادلة. وتزداد صعوبة ذلك في ظل غياب قواعد بيانات دقيقة وشفافة حول سلاسل الإمداد، وهو ما برزت أهميته بوضوح بعد أزمات كبرى مثل جائحة كوفيد-19، الحرب في أوكرانيا، وأزمة قناة السويس عام 2021.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
تأمين تعطل سلاسل الامد بين تحديات الواقع وآفاق التطوير في أسواق التامين العربية.

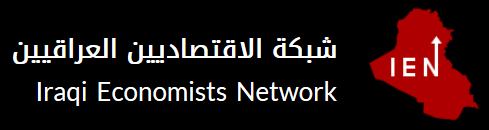

إلى الأستاذة الفاضلة إسراء صلاح داود،
تحية طيبة،
شكراً على المداخلة ولملاحظاتكم القيمة ، لما ورد في ورقتي عن تامين تعطل سلاسل الامداد ،واتفق مع كل ما تفضلتي به من ملاحظات واهميتها القصوى لمشروع طريق التنمية في العراق. ومع اقتراب تنفيذ هذا المشروع ،من المتوقع ان يواجه ديوان الرقابة تحديات نوعية غير مسبوقة، قبل التنفيذ من خلال ضرورة مناقشة جملة من القضايا القانونية مع الجهات المعنية ،وبعد التنفيذ ،مع عدم ملاءة معظم شركات التامين المحلية لهذا النوع من التامين ،بالاضافة إلى إن المشروع لا يمثل مجرد بنية تحتية للنقل، بل منظومة إمداد عابرة للحدود تتقاطع فيها المصالح التجارية والقانونية والتأمينية.
أبرز هذه التحديات يتمثل في إدارة المخاطر العابرة للحدود، حيث إن جزءًا كبيرًا من وثائق التأمين الخاصة بسلاسل الإمداد سيصدر من خارج العراق، بينما تقع الأخطار الفعلية على أراضيه. وهذا التداخل يفتح الباب أمام نزاعات قانونية محتملة حول الولاية القضائية وتطبيق القوانين في حال وقوع حادث يؤثر على مؤمنٍ له خارج العراق.
إن مشروع طريق التنمية لا يُمثّل مجرد استثمار في البنية التحتية، بل فضاءً جديدًا لتشابك المصالح والمسؤوليات القانونية. فمع مرور آلاف الشاحنات والسلع والمؤمن لهم عبر الأراضي العراقية، قد تنشأ مطالبات وتعويضات نتيجة حوادث، أو أضرار بيئية، أو انقطاع في سلسلة الإمداد يؤثر على مؤمنٍ له خارج العراق.
وفي مثل هذه الحالات، ستُوجَّه المطالبات القانونية ضد الأطراف داخل العراق — سواء كانت شركات تشغيل أو جهات حكومية أو مقاولين — استنادًا إلى مسؤولياتهم المباشرة في التسبب بالضرر.
ومن هنا، اعتقد ان على ديوان الرقابة مسؤولية استباق هذه السيناريوهات والدخول مع الجهات المعنية بضرورة بلورة ما يلي :
• وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح يحدد كيفية التعامل مع المطالبات التأمينية الدولية والمحلية داخل الأراضي العراقية.
• إلزام جميع المقاولين والمشغلين بتوفير تغطيات تأمينية محلية كافية تغطي الأضرار المحتملة ضمن نطاق المشروع.
• وضع الية ضمان لمعالجة التعويضات أو النزاعات ذات الطابع العابر للحدود، بما يحمي سمعة الدولة ويضمن استمرارية المشروع دون تعطيل.
إن إهمال هذا الجانب قد يؤدي إلى نزاعات قضائية دولية مكلفة أو إلى تحميل الحكومة مسؤوليات مالية غير مباشرة، وهو ما يتعارض مع أهداف الطريق في جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة.
بكلمة، إن إدارة الخطر القانوني والتأميني في هذا المشروع ليست مسألة فنية فحسب، بل ركيزة للسيادة الاقتصادية وشرط أساسي لاستدامة طريق التنمية كممر آمن وموثوق.
الأستاذ الفاضل سمير عبد الأحد المحترم،
تحية طيبة وبعد،
نود أن نعرب لكم عن بالغ الشكر والتقدير لما تفضلتم بطرحه في ورقتكم البحثية حول موضوع التأمين ضد انقطاع سلاسل التوريد، والذي يمثل أحد الموضوعات الحديثة والاستراتيجية في الوقت نفسه، لما له من صلة مباشرة باستقرار واستدامة الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا في البيئات المعقدة مثل البيئة العراقية.
لقد لامست الورقة البحثية بدقة أهمية هذا النوع من التأمين، كما سلطت الضوء على جوانب حيوية تمثل تحديات حقيقية أمام مختلف الأطراف الفاعلة. ونؤكد من جانبنا في ديوان التأمين أن موضوع تأمين انقطاع سلاسل التوريد لم يحظَ بعد بالتطبيق أو الممارسة الفعلية في السوق العراقي، إلا أن الحاجة إليه قد تطلب هذا التأمين لا سيما مع توجه الدولة نحو مشروع “طريق التنمية”، الذي سيضع العراق في موقع محوري ضمن حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد الإقليمية. ومن هنا تظهر
أهمية التأمين ضد انقطاع سلاسل التوريد في ظل مشروع “طريق التنمية”شتكون جليا
مع توسع الاستثمارات المرتقبة في مجالات النقل، واللوجستيات، والتخزين، والتجارة، فإن المخاطر المرتبطة بانقطاع سلاسل التوريد ستصبح أكثر تنوعًا وتعقيدًا، سواء كانت تلك الانقطاعات بسبب عوامل لوجستية، أو سياسية، أو أمنية، أو طبيعية، مما يجعل من الضروري وجود أدوات تأمينية حديثة قادرة على التخفيف من هذه المخاطر.
ومن هنا، فإن توفير تأمين فعال ضد انقطاع سلاسل التوريد لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة اقتصادية لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات، وطمأنة المستثمرين، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية في مواجهة المخاطر.
الا انه في المقابلة تتجلى التحديات التي سنواجهها كجهة رقابية ، منها:
1. عدم وجود تشريعات أو ضوابط نظيمية خاصة بهذا النوع من التأمين، مما يصعّب على شركات التأمين أو جمعية المؤمنين ومعيدي التأمين إعداد منتجات تغطي هذا المجال لاعتمادها من الديوان
2. ضعف ثقافة السوق عموما ، فمابالكم حول هذا النوع من التغطيات التأمينية، سواء لدى الجهات الحكومية أو لدى المستثمرين المحليين وحتى الدوليين.
3. نقص الكوادر الفنية المؤهلة لتصميم وتسعير وثائق تأمين معقدة كهذه.
4. غياب البيانات الدقيقة الخاصة بسلاسل التوريد، ومصادر الخطر المرتبطة بها، والتي تعد أساسية لتقييم المخاطر وتسعير الأقساط بشكل دقيق. وهو الأهم
5. ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة (كالوزارات، والجهات اللوجستية، والموانئ، والقطاع الخاص)، وهو ما يتطلب حوكمة مشتركة وإطار عمل متكاملة
6. عدم وجود تجارب سابقة محلية أو أعمال مماثلة يمكن الاستناد إليها، وهو ما يجعل الدخول في هذا المجال بحاجة إلى دراسة متأنية، وربما تعاون إقليمي أو دولي للاستفادة من التجارب العالمية.
ارجو ان لا أكون قد أطلت في التعليق..مع التقدير